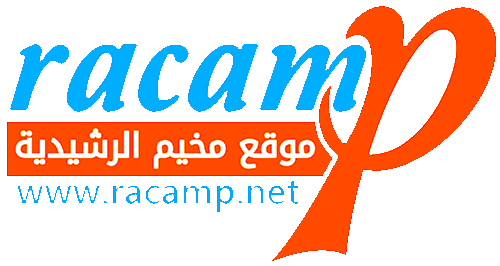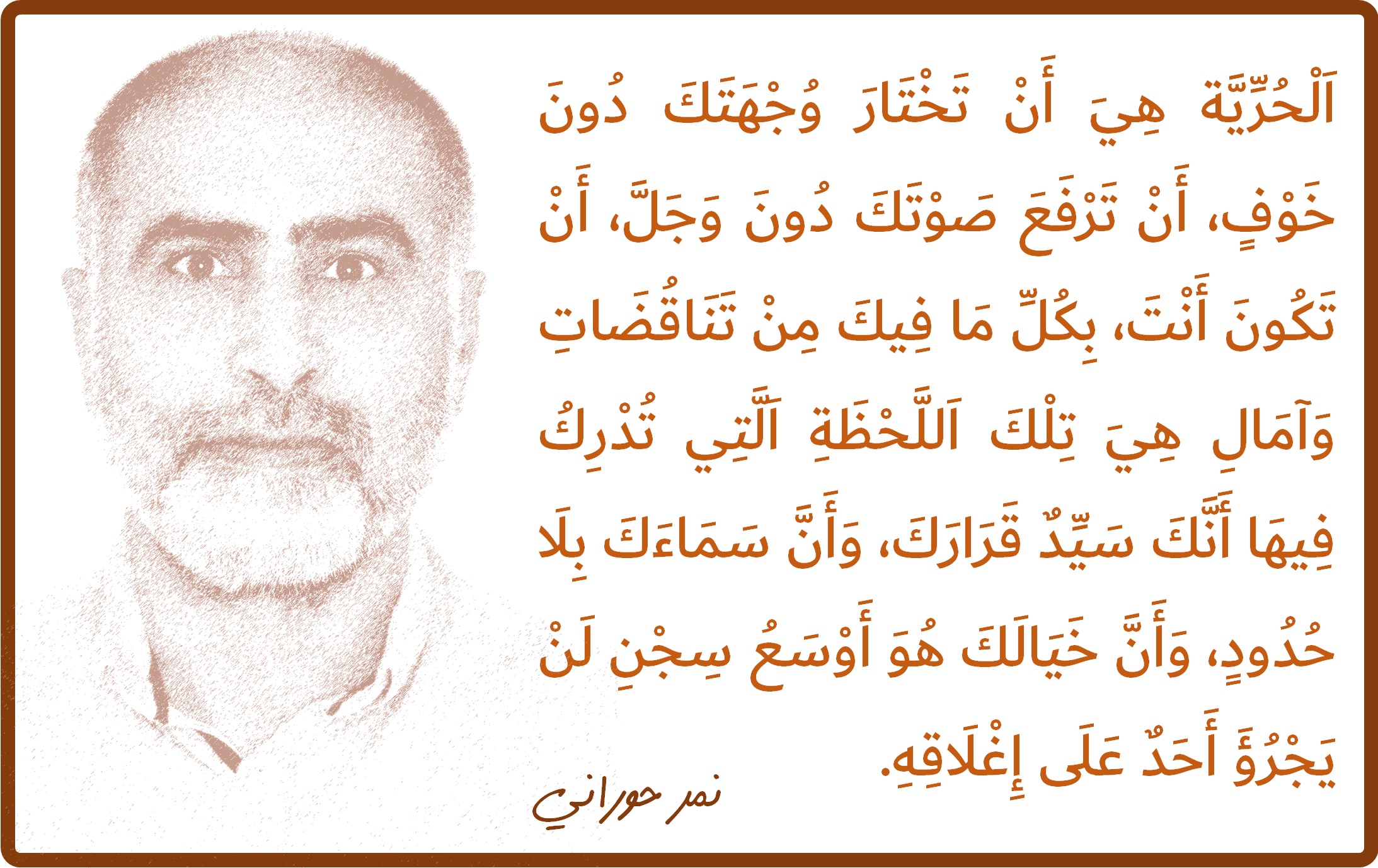معين الرفاعي
في الثامن من الشهر الحالي، كشفت وسائل إعلام عن مناقشات سرّية تمّت بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال، تمحور اللقاء، بحسب التسريبات، حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة. لكنّ اللافت في التسريبات أن الاجتماع طرح المعادلة التالية: موافقة نتنياهو على دور تقني وتنفيذي للسلطة الفلسطينية في بعض مناطق قطاع غزة، يصرّ نتنياهو على أن يكون مؤقّتاً، مقابل حصول الكيان على غطاء سياسي غربي لمنع وكالة «الأونروا» من العمل في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وقبل يومين من الكشف عن بعض ما دار في الاجتماع، كانت الشرطة الإسرائيلية تقتحم المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس، وتنزل علمها وترفع مكانه العلم الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تحمي مقرّات البعثات الدولية. وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أغلقت المقرّ الرئيسي نفسه بعد إصدار الكنيست تشريعاً يمنع عمل «الأونروا» في المناطق المحتلة، ويجرّم التعامل أو التواصل معها.
مساعي إسرائيل للتخلّص من «الأونروا» ليست جديدة. خلال العدوان على غزة، وجّهت إسرائيل اتهامات للوكالة بأنها مُخترقة من قبل حركة حماس، واعتقلت عدداً من موظفيها وأخضعتهم لتحقيقات قاسية. ونتيجة لهذا التحريض، أعلنت الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وكذلك أعلنت العديد من الدول المانحة، ولا سيما الأوروبية منها، وقفَ مساهماتها في ميزانية «الأونروا»، قبل أن تتراجع لاحقاً. ورغم أن إسرائيل لم تستطع إثبات اتهاماتها، ورغم صدور أكثر من بيان عن الوكالة يؤكّد أنْ لا دليل على الاتهامات الموجّهة إلى موظفيها، وكذلك عن محكمة العدل الدولية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية استمرّت في نشر ادّعاءاتها للتحريض على الوكالة والمُطالبة بإنهاء عملها.
غير أن مساعي إسرائيل لشطب وكالة «الأونروا» لا ترتبط بالسابع من أكتوبر؛ بل تعود إلى سنوات كثيرة سابقة. لطالما حرّضت إسرائيل على إنهاء عمل الوكالة بذريعة أنها «تؤبّد» قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توريث صفة اللجوء لأبناء الذين هُجّروا من فلسطين في عام 1948 وأحفادهم. وتزعم إسرائيل أنّ الوكالة تحرّض على العنف من خلال مناهجها التعليمية، وأن تقديماتها يستفيد منها عناصر الفصائل الفلسطينية المقاومة وعائلاتهم.
يدعم الكونغرس الأميركي المطالب الإسرائيلية بقوة، وقد أصدر تشريعاً ينصّ على عدم الاعتراف بتوريث صفة اللجوء، ما يعني عملياً أن الإدارة الأميركية لن تقدّم الدعم المالي إلا بما يتناسب مع العدد المحدود من الأحياء من اللاجئين الفعليين الذين لجأوا في عام 1948، دون أبنائهم أو أحفادهم. وفي مقابل استمرار الدعم الأميركي، الذي يشكّل فعلياً النصيب الأكبر من تمويل الوكالة في ظل الضغط السياسي الذي تمارسه الإدارة الأميركية على الدول الأخرى لإبقاء مساهماتها المالية في الحد الأدنى، أجبرت الإدارة الأميركية وكالة «الأونروا»، في عام 2021، على التوقيع على «اتفاقية إطار» بذريعة محاربة الإرهاب.
ينصّ الاتفاق على حرمان أعضاء الفصائل الفلسطينية أو مَن تلقّوا تدريبات عسكرية أيضاً من خدمات «الأونروا» المختلفة الصحية أو التعليمية منها، وكذلك أن يمتنع موظفو الوكالة، حتى الفلسطينيون منهم، عن المشاركة في أيّ فعالية جماهيرية أو شعبية أو التعليق والكتابة عن القضايا الوطنية «السياسية» وأن يلتزموا بمبدأ الحياد؛ إلى جانب إطلاع الخارجية الأميركية على البيانات كافة المتعلّقة باللاجئين والموظفين.
منذ تأسيسها في عام 1949، شكّلت الوكالة الحجرَ الأساسَ في توفير الإغاثة والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن إنشاءها كان يُفترض أن يكون مؤقّتاً إلى حين إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، فإنّ الظروف السياسية الإقليمية والدولية أبقتها كحاجة دولية إلى الاستقرار في المنطقة.
أيّ انهيار للوكالة سيكون كارثياً على المستويات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن الآثار السياسية، من فقدان لرمزية حق العودة وتمهيد الطريق لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني
على مدى عقود، أدّى فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية شاملة، إضافة إلى صعود القضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية ودولية، إلى تحويل الوكالة تدريجياً إلى مؤسسة دائمة. ومع مرور السنوات، توسّع دورها ليشمل التعليم والصحة والإغاثة وتوفير فرص العمل. وهكذا، أصبح وجود «الأونروا» بحد ذاته شهادة دولية مستمرة على عدم حلّ قضية اللاجئين، وهو ما يشكّل سبباً رئيسياً للضغوط التي تتعرّض لها اليوم.
اليوم، تجد «الأونروا» نفسها أمام تحدّيات غير مسبوقة تهدّد وجودها المؤسّسي ودورها السياسي، ليس فقط بسبب الأزمات المالية التي تُلاحقها، بل أيضاً بسبب تحوّلات عميقة في البيئة الدولية وإعادة تعريف بعض القوى الكبرى لملف اللاجئين الفلسطينيين.
الأزمة المالية التي تواجهها «الأونروا» ليست جديدة، لكنها وصلت إلى مستويات خطرة. تعتمد الوكالة بنسبة تتجاوز 90% على التبرّعات، ولا تمتلك صندوقاً مالياً ثابتاً أو مصدر دخل مستقرّاً، ما يجعلها تحت رحمة المزاج السياسي للدول المانحة كل عام.
أدّى ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات داخل الوكالة، أبرزها: تقليص عدد المعلّمين والموظفين، وتقليص الخدمات الطبية والدوائية في العيادات، وانخفاض تقديمات الغذاء والمواد الأساسية، وتزايد نسبة الفقر في المخيمات كافة، خصوصاً في غزة ولبنان. على أن أخطر ما في هذه الأزمة هو أنها تشلّ قدرة الوكالة على التخطيط الطويل المدى، وتجعلها مؤسسة تعمل دائماً «على حافة الانهيار».
غير أن وجود «الأونروا» لا يقتصر على التقديمات الإغاثية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين؛ فالبعد القانوني، وانعكاساته السياسية، لا يقلّ كلّ ذلك أهميةً عن الدور الإنساني. يرتبط وجود الوكالة من الناحية القانونية بقرار الأمم المتحدة الرقم 194 الذي ينصّ على حق اللاجئين في العودة والتعويض. وبالتالي، فإنّ إنهاء «الأونروا» أو إضعافها ليس خطوة تقنية بل هو قرار سياسي يؤثّر مباشرة في مستقبل هذا الحق.
فوجود الوكالة يعني، قانونياً، الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما هو مُعترف به دولياً، وهو ما يعيق محاولات إسرائيل والإدارة الأميركية من إعادة تعريف اللاجئين أو شطب حق العودة. كما يشكّل وجود «الأونروا» وثيقة قانونية حيّة تُسجّل عدد اللاجئين وتاريخهم وحقوقهم، ما يجعل منها «خطّ الدفاع الأوّل» عن قضية اللاجئين في المحافل الدولية.
هذا الدور القانوني هو الذي يؤرّق إسرائيل والإدارة الأميركية وهو ما تسعيان إلى التخلّص منه عبر تفكيك الوكالة وإنهاء عملها، بطريقة أو بأخرى.
شهدت السنوات الأخيرة مساعيَ أميركية عديدة للتخلّص من الوكالة، يكمل بعضها بعضاً. بدأت هذه المساعي بالتقليص التدريجي لخدمات الوكالة، لأجل تقليص دورها ووجودها. بموجب هذا التقليص، تستمرّ الوكالة في الوجود، لكنها تصبح أصغر وأضعف. وبالتوازي مع هذا التقليص، تدفع الإدارة الأميركية باتجاه نقل جزء من مسؤوليات «الأونروا» تدريجياً إلى الدول المضيفة، بينما يظلّ تمويلها غير مستقرّ. هذا التقليص لا يلغي الوكالة، لكنه يُفرِغها من مضمونها السياسي.
الهدف الرئيسي الذي تسعى الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى تحقيقه هو استبدال الوكالة بنظام أممي جديد، وعلى وجه الخصوص، نقل صلاحيات «الأونروا» إلى المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). يقضي هذا الدمج على أي بعد سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث لا تعترف مفوّضية اللاجئين بحقّ العودة كحقّ خاصّ بالفلسطينيين.
في المقابل، يدعم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية وأميركا اللاتينية اتجاهاً آخر، يقوم على أساس تعزيز الوكالة ودورها. يرتكز هذا الموقف على الخشية من أن إنهاء عمل «الأونروا» من شأنه زعزعة الاستقرار الهشّ في المنطقة، وستكون له انعكاسات أمنيّة واجتماعية كارثية، قد تطاول أوروبا نفسها عبر تدفّق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها.
تعزيز هذا الاتجاه يحتاج إلى زيادة تمويل الوكالة، وتحسين إدارتها، وإنشاء صندوق مالي مُستدام خاصّ بالوكالة، والحصول على ضمانات سياسية لعدم تسييس التمويل. وهذه كلها قضايا تعتمد على توازن دولي غير مُتحقِّق حالياً، ولا سيما في ظل الضغوط الأميركية.
أيّ انهيار للوكالة سيكون كارثياً على المستويات الإنسانية والسياسية والاجتماعية؛ سيؤدي ذلك إلى انقطاع التعليم عن أكثر من نصف مليون طفل، وتوقّف العيادات الطبية في جميع مناطق عمل الوكالة الخمس، وتفاقم الفقر والبطالة والجوع. هذا إضافة إلى الآثار السياسية، من فقدان لرمزية حق العودة، وتمهيد الطريق لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ما يفتح المجال أمام توطين اللاجئين في الدول المضيفة، فيضغط على ميزانيات الدول المضيفة نفسها، ويفجّر الغضب في المخيمات، وتوسّع العنف بسبب الفقر وغياب الخدمات.
تمرّ «الأونروا» بمنعطف تاريخي غير مسبوق. إنها ليست مجرد مؤسسة تقدّم خدمات إنسانية، بل هي عنصر أساسي في البنية القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية. فالتحدّيات التي تواجهها الوكالة اليوم تتجاوز نقص التمويل، لتصل إلى محاولة إعادة تشكيل الرواية التاريخية للصراع وشطب أحد أهمّ أسس حقّ العودة.
المستقبل مرهون بقدرة الدول الداعمة والفاعلين الإقليميين على حماية الوكالة وتعزيزها، وبمدى وعي المجتمع الدولي بأنّ تفكيك «الأونروا» لن يؤدّي إلى حلّ قضية اللاجئين، بل إلى تفجّر أزمات إنسانية وسياسية أكبر.
* باحث وسياسي فلسطيني