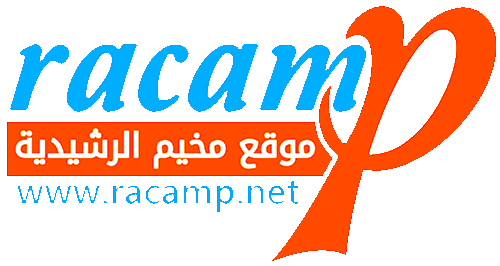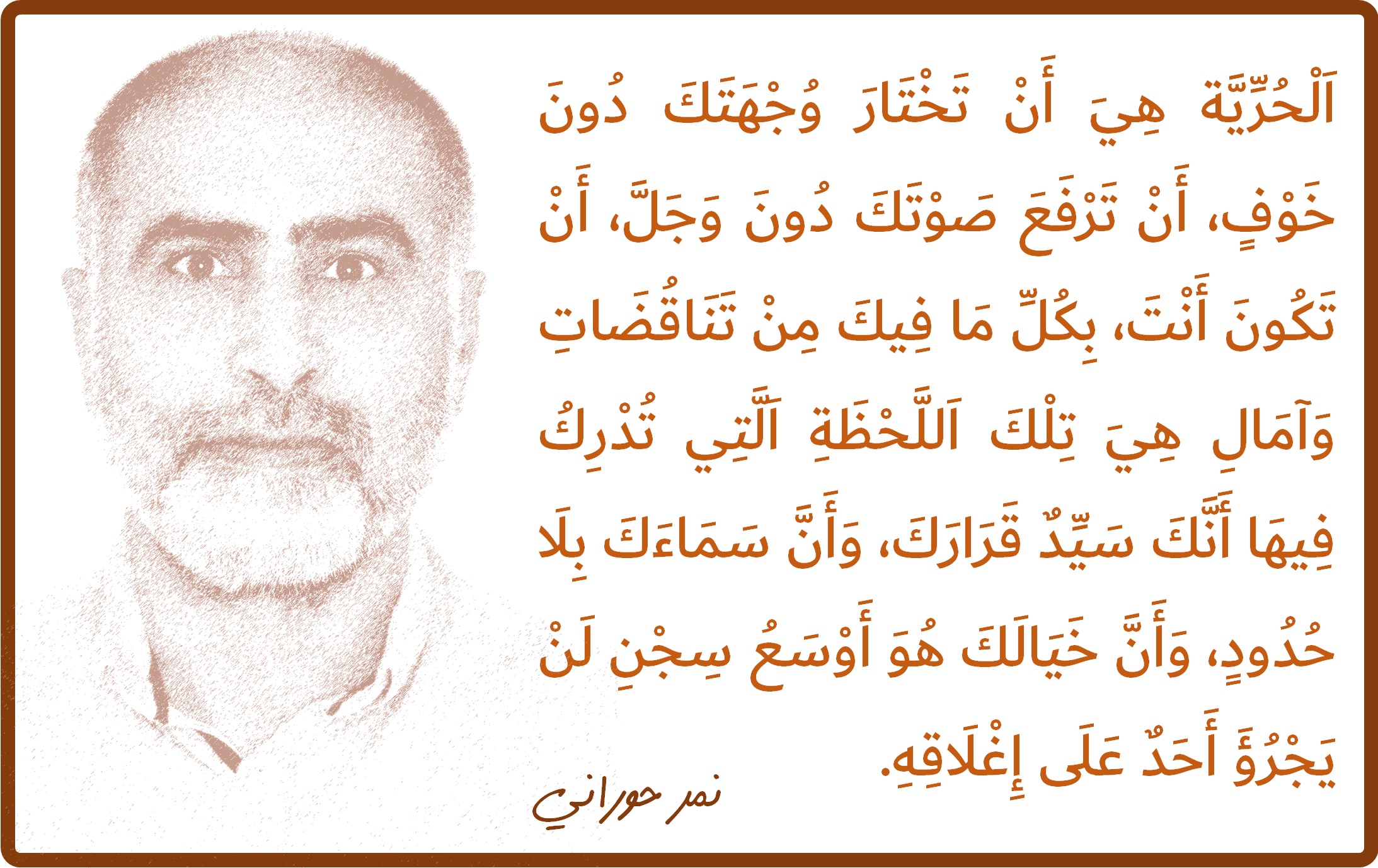سعد الله مزرعاني
ستُظهِر متابعة واقع الثبات والاستقرار في الوضع اللبناني منذ الاستقلال إلى اليوم، وجود قدر عالٍ من هشاشة تتزايد وتتفاقم مع مرور الزمن. تمثّلت تلك الهشاشة في حصول، أو الوقوع، في سلسلة من الاضطرابات الصاخبة التي كانت ذروتها (حتى الآن!) الحرب الأهلية التي استغرقت عقداً ونصف عقد من السنوات بين عامي 1975 و1990.
من الأسباب/ النتائج، أن التسويات التي كانت تضع خاتمة للأزمات، قد كانت، دائماً، ظرفية وترقيعية. هي كانت كذلك لأسباب عدة:
• الأول، حضور العامل الخارجي لاعباً أساسياً: في كل المراحل وفي كل الأوقات. ذاك العامل كان دائماً خليطاً متنوعاً من السياسات والمصالح والعلاقات التي توجّهها تناقضات وصراعات كبيرة. كان هذا العامل إقليمياً أو دولياً، أو محصلة تفاعل الاثنين معاً. يجدر التأكيد أن العامل الخارجي لم يكن يوماً أمراً طارئاً أو مفتعلاً أو مؤقتاً.
لقد كان ولا يزال في صلب البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية. إنه، للتذكير، عامل تأسيسي مندرج في بنية النظام: بذريعة «ضمانة» أو حماية، أو طلباً لاستقواء، أو مرجعية هويةٍ وانتماء!
هذا ينطبق على الخارج الغربي خصوصاً: منذ ما قبل التأسيس الرسمي (تدخّل القناصل)، إلى «لبنان الكبير» (الفرنسي) عام 1920، إلى الوصاية الأميركية التي تتعاظم الآن بشكل غير مسبوق. هذه الوصاية تتنكّر، كالعادة، بصيغة «وساطة» منذ «اتفاق وقف الأعمال العدائية» بين العدو الإسرائيلي (وراعيه الأميركي!)، من جهة، والحكومة اللبنانية والمقاومة (ممثلة بـ«حزب الله» خصوصاً)، من جهة ثانية.
ثم أن العامل الخارجي لم يكن عنصراً مضافاً في مراحل الأزمات والتسويات فحسب، بل كان أيضاً أحد أسباب حدوثها: بمقدار ما ترسخ في المعادلة اللبنانية («المعجزة»!) أن كل طرف من أطراف السلطة قد اتخذ لنفسه مرجعية خارجية في لعبة الاستقواء دفعاً للضعف، أو طلباً للتوازن، أو سعياً وراء الغلبة كما ذكرنا. هذا المستوى من التفاعل الاستثنائي بين الداخل والخارج، جعل لبنان يستقبل الأزمات الناجمة عن التحولات والصراعات الإقليمية والدولية، ولا ينتجها أو يصدّرها فقط.
• العامل الثاني، الأخطر، هو الخلل القائم في «طبيعة» وبنية النظام السياسي اللبناني. وهو خلل تأسيسي أيضاً. باختصار: الإلحاح، ضمناً أو علناً، على أن نظام لبنان يكون طائفياً أو لا يكون لبنان، هو أساس الخلل. كأن التعدّد والتنوّع الطائفي والعرقي والقومي والإثني… «هبة» لبنانية دون سائر البلدان! إدراج التمثيل الطائفي في صلب مؤسسات الإدارة والسلطة عبر تحاصص وتقاسم فئويين على حساب عافية الدولة وسلامة العلاقات في المجتمع، كان اختياراً توسلته القوى (البورجوازية الكبرى) النافذة والإقطاع الموروث. هو كان وما يزال أداتها للإمساك بالسلطة ولحصريتها واحتكارها، في علاقة وثيقة مع قوى خارجية باتت، غالباً، هي الأكثر تقريراً وتأثيراً في تحديد سياسة لبنان ومصائره عموماً.
المعادلة التي جرت بلورتها، بإصرار وعناية، لجهة ربط وجود لبنان بنظامه السياسي (خصوصاً بعض «المكونات» المؤسسة فيه)، جعلت التغيير والإصلاح عامل تهديد للوحدة الداخلية، من جهة، ولوجود جماعات بعينها قبل سواها، من جهة ثانية. هذا الأمر شكَّل دائماً عامل إعاقة لأي إصلاح. هكذا فإن ما فرضته التوازنات في بعض المراحل، من إقرار إصلاحات جزئية، كما حصل في تسوية «الطائف» لعام 1989، قد تمّت عرقلتها في التنفيذ، بتواطؤ من كل الشركاء في السلطة مهما تباينت توجهاتهم في ميادين أخرى، ولو كان البند الإصلاحي ماثلاً في النص الدستوري، بشكل قاطع ومبرمج!
• الثالث، المرتبط بنيوياً بالثاني والناجم عنه إلى حد كبير، تجسّد دائماً في شلل المؤسسات، في مراحل لأزمات خصوصاً. نجم عن ذلك دائماً عجز مزمن عن إنتاج التسويات الداخلية الضرورية والصحيحة بشأنها، الأمر الذي فاقم تلك الأزمات ومعها التدخل الخارجي وانكشاف البلد وانتهاك السيادة. هذا بالإضافة إلى «فضائل» التحاصص والعصبيات، وبهما وعبرهما، تقاسم النفوذ والسلطة والإدارة والموارد، وتغطية الفساد، وتعطيل المحاسبة، وإشاعة الهدر والزبائنية، وانتهاك الدستور والقوانين.
يبرز هذا الخلل اليوم أكثر من أي مرحلة سابقة، بسبب ضراوة ووحشية الصراع الدائر في المنطقة بأبعاده العالمية البارزة، وبسبب حجم الاستهداف الذي يتعرّض له الشعبان الفلسطيني واللبناني بسبب المخطط التوسعي الهمجي الأميركي الصهيوني.
غذّت جذرية تلك المخططات، ووحشية الوسائل المستخدمة، رغبةً جامحة ومتطرّفة لدى الورثة الحاليين لـ«الانعزالية» اللبنانية، للانطلاق في مغامرة جديدة (رغم خيبات تجارب سابقة مماثلة)، ولو أدّى ذلك إلى احتراب داخلي أهلي، أو إلى تسهيل استباحة أو حتى احتلال لبنان من قبل قوى عدوة، قريبة أو بعيدة.
تلعب واشنطن الدور الأساسي في كل ذلك من خلال دعمها المطلق للعدو الصهيوني. إلى ذلك، تتولّى الشقّ الأكثر خطورة في محاولة تحقيق أطماعه المفتوحة في المنطقة وفي لبنان. وهي توظِّف وتجنِّد، لهذا الغرض، كل رصيدها وإمكانياتها وضغوطها في الحقول كافة.
إزاء كل هذه المخاطر والتهديدات الاستثنائية، يقف لبنان منقسماً، ومفتقراً إلى الحد الأدنى من الحصانة الداخلية. طبعاً هكذا كان شأنه دائماً كما ذكرنا آنفاً! هذا يعني، حكماً، أنّ القوى الوطنية والحريصة ستكون أمام اختبار كفاحي جديد لجهة الظروف والشروط على الأقل.
لقد نشأت المقاومة في ظروف مشابهة وأخطر حيث الانقسام والحرب الأهلية. لم تكن موضع إجماع يوماً. وهي استطاعت، رغم ذلك، ولو بتضحيات وخسائر فادحة، تقديم تجربة منتصرة واستثنائية ومحفّزة. لا مكان للحياد، أو للاكتفاء بالمراقبة، أو إصدار البيانات المندّدة… إنها مسؤولية استحقاق وطن، ومسألة وجود وكرامة وحرّية.
* كاتب وسياسي لبناني