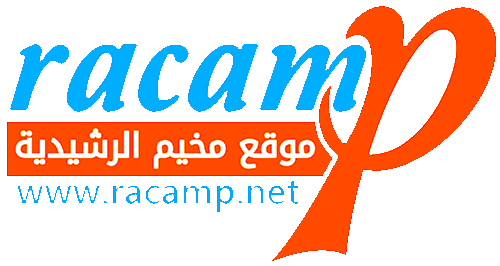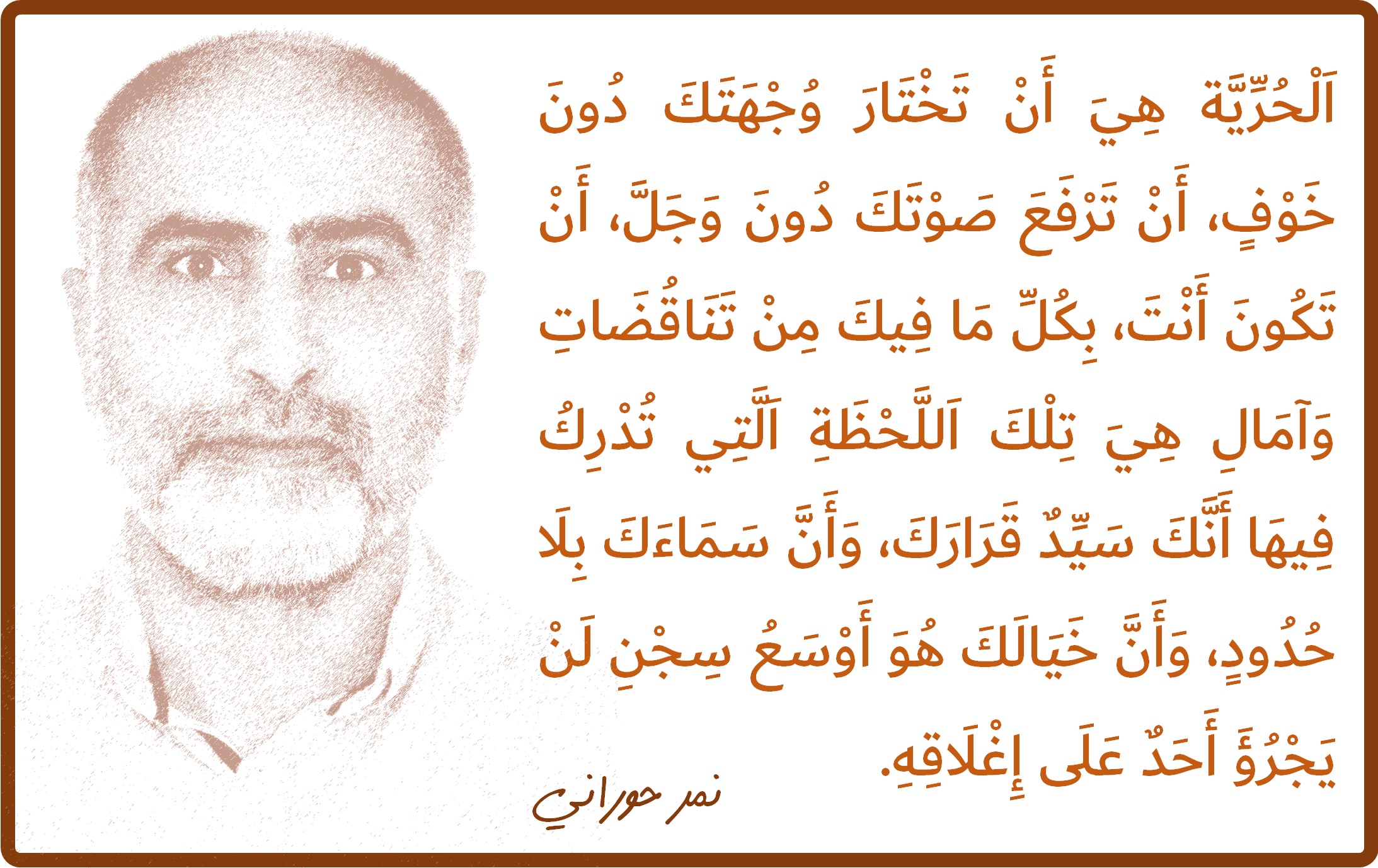الفضل شلق
أدت الفتوحات العربية في القرنين السابع والثامن الميلاديين إلى نشوء ثقافة عربية في المجال العربي الإسلامي الممتد من شواطئ المحيط الأطلسي إلى حدود الصين. انتشر الإسلام بعدها في مناطق أخرى من الهند وأسيا الشرقية، بما فيها أندونيسيا الأكثر تعدادا سكانياً من أي بلد آخر سواء كان عربياً أو إسلامياً. يُشكّل العرب الآن في جميع أقطارهم، المسلمون منهم، حوالي ثلث مسلمي العالم. وهم أصحاب جغرافيا تُشكّل 10% من مساحة العالم، و5% من سكانه.
لم يكن انتشار العروبة أو الإسلام بالفتح والغلبة دوماً بل بالثقافة، التي اعتمد توسعها في كثير من الأحيان على اللغة العربية، وعلى انتشار اللغة العربية كلغة القرآن والدين. الذين صارت العربية لديهم لغة محكية إضافة إلى كونها لغة الدين هم الذين يسمون عرباً، وإن كان الانتماء بالوعي أو بفعل ظروف مادية عسكرية أو سياسية فرضت نفسها.
المهم أن اللغة العربية صارت هي “اللينغوا” (اللغة العليا) في المجال الحضاري الإسلامي كله. وقد امتدت أثارها الثقافية عند الازدهار الثقافي إلى أنحاء من العالم غير إسلامية، مما يؤكد أن النهضة الأوروبية في القرون الوسطى ما كانت ممكنة لولا الترجمة عن اللغة العربية. ازدهرت الثقافة العربية الإسلامية من قبل عن طريق الترجمات من حضارات أخرى كالأغريق، والهند، والصين، وغيرها، والعالم كان وما يزال موحداً أكثر مما يظن الباحثون الذين قال أحدهم (جون كامبل في مطلع كتابه “أقنعة الله”) أن العالم سيمفونية واحدة تتألف من أنغام متعددة؛ فانتشار الثقافة العربية ثم العربية-الإسلامية لم يكن عسكرياً، وما الغلبة العسكرية إلا في فترات محدودة، بل كان في معظم الأحيان عن طريق التجارة وتماس الشعوب ببعضها البعض، والأخذ من الآخرين.
ما من أحد يستطيع القول إن الثقافة العربية الإسلامية وليدة نفسها أو كانت مجتمعاً أو مجتمعات مغلقة، إلا وكان مخطئاً. وما يسمى الآن إدعاءات أوروبية عن مركزية ثقافتها ما كان موجوداً من قبل إلا في حالات نادرة، ليس هنا مجال البحث فيها. فالمركزية الثقافية الأوروبية التي انضمت إليها الولايات المتحدة الأميركية ما كانت إلا أداة استعمارية. إذ سادت في وقت سادت أوروبا على العالم، وحملت لواء الثقافة العالمية بالتقدم العلمي، واعتبرت أن مهمتها تنمية العالم، أو نقله من حال البربرية إلى المدنية بالقوة؛ ففي معظم مراحل التاريخ، بهذه المقاييس، كانت أوروبا هي البربرية، وانقلبت الحال مع الاستعمار الذي حدث معظمه بعد الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. قبل ذلك كانت الفتوحات الأوروبية منذ القرن السادس عشر، و”اكتشافهم” العبور إلى آسيا بالمرور حول رأس الرجاء الصالح في آخر القرن السادس عشر، وبداية عنف ندر إن كان مسبوقاً. فقد اضطرت أوروبا إلى استخدام العنف في التبادل التجاري لأنه لم يكن لديها، بسبب تأخرها الاقتصادي، شيئاً تبيعه من أجل التبادل التجاري. قبل ذلك كانت تجارة المحيط الهندي سلمية في معظم الأحيان. لكن ما سهّل تجارة أوروبا مع آسيا كان تدفق الذهب والفضة من أميركا الوسطى والجنوبية، وبخاصة البيرو، وكانت هذه القارة قد اكتشفها الأوروبيون في نفس الوقت الذي اكتشفوا فيه آسيا. وتأسست شركات الهند الشرقية وشركة الهند الغربية للتجارة. وفي نفس الوقت تأسست شركة “اللافنت” (أي شرق المتوسط)، والأرجح أن الأرباح من هذه كانت إلى وقت ما أكثر من أرباح شركات الهند الشرقية.
في المحصلة كانت سفن أوروبا تأتي إلى آسيا محملة بالسلاح والحجارة لتثقيلها، وبالرهبان كي يجمع هؤلاء ما أمكن من التراث الثقافي عند الشرق، وللهداية طبعاً للدين القديم في نظرهم. المهم أن التجارة، وما يحدث خلالها من تبادل ثقافي، كانت تمهيداً لعلاقة استعمارية لم تتحقق فعلاً إلا في القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية. وقبل ذلك وبعده القضاء على صناعات آسيا. على كل حال، كان استهلاك الصين من الفحم الحجري للصناعة يفوق استهلاك أوروبا منه حتى بعد الثورة الصناعية. والقضاء على اقتصاد آسيا لم يحصل بالتبادل التجاري الصرف، بل بالقسر والإكراه واستخدام وسائل العنف التي صارت هي جوهر الاستعمار في القرن التاسع عشر. لم يكن إرهاق الدولة العثمانية ومصر بالديون إلا احدى وسائل العنف. إذ تطلب سداد الدين العام لجاناً مكونة من ممثلي دول أوروبا للإشراف على الاقتصاد المحلي، وإفراغه من مقوماته الصناعية والزراعية. وما صارت التجارة الحرة مبدأً عالمياً إلا مع تفوّق أوروبا في القرن التاسع عشر لاستكمال فتح أسواق آسيا لها.
إن كتابة تاريخ التجارة الدولية والمحلية أهون بكثير من كتابة تاريخ التبادل الثقافي. وعلى كل حال، إن من حاول تحديد بداية عصر الانحطاط بثورة الزنج في أواخر القرن التاسع الميلادي، أو مع الحملات الصليبية، أو حملات المغول التي أدت إلى خراب بغداد والمنطقة، يُخطئ. إذ لا يأخذ بالاعتبار الازدهار، أو على الأقل التقدم الثقافي في العلوم المادية والرياضيات وغيرهما. ما يعني أن نظرية الانحطاط ليست فقط مُجحفة بحق تاريخنا، بل هي ذات آثار مخربة وتدميرية في وعينا، إذ تؤدي إلى حذف ألف عام من تاريخنا، مما يقود إلى خلل في الوعي التاريخي الذي يتهاوى عندما لا يكون سلسلة متصلة أو عندما تُحذف منه حلقة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. في هذه الفترة صار الانتقال إلى العربية كلفة محكية، وذلك على الأقل في بدايتها. وهذا معناه صيروة أكثرية الناس إلى تبني العروبة التي هي تتعلّق باللغة أكثر من الأصول الإثنية. فالعروبة صيرورة وجود وليست اجتماع الجماعة في أصل إثني. نظرية العروبة تنفي الصيرورة أو تحيلها إلى عكس ما يجب أن تكون، وتشلّع التاريخ، مما يؤدي إلى تشليع الوعي والشخصية لحاملي هذا الوعي.
وإذا قيل أن تبني العربية كلغة محكية، فهذا الأمر لا يناقض أن المحكية مفرداتها مأخوذة كلها من الفصحى، ولا بدّ من الأخذ بالاعتبار قول ابن جني في أن كل ما قيس على كلام العرب فهو من لغتهم.
لقد انضمت على مدى قرون بعد الفتوحات شعوب كثيرة إلى اللغة العربية. هذا أساسي في تكوين هويتها بغض النظر عن الدين أو التحوّل. واللغة في أساس التحوّل الثقافي، أو بالأحرى نشوء ثقافة جديدة فوق الثقافات المحلية. وكما أن هناك “لينغوا فرانكا”، هناك ثقافة عامة جمعت شعوباً ما كان لها ذلك لولا اللغة.
إن نظرية الانحطاط التاريخي قبل الاستعمار هي تبرير له عن قصد أو غير قصد، إذ تحيلنا إلى برابرة دون أن نكون كذلك. لكنها تعطي الغرب حجة من أجل جلب المدنية إلينا. فما حدث من تأخر في الفترة السابقة للاستعمار إن هو إلا نتيجة سياسات الامبراطورية العثمانية التي ارتكزت على اعتبار الشعوب بما فيها العرب مجرد رعايا أو أدوات إنتاج، مهمتها العمل لتأدية الضريبة التي تخدم بقاء الامبراطورية وبذخها وحروبها. فالجريمة الكبرى التي ارتكبتها الامبراطورية العثمانية، كما الدين السياسي، وكما الاستبداد لاحقاً بعد ما يسمى الاستقلال، هي في احتقار الشعوب العربية وغيرها من الشعوب الخاضعة، واعتبارها ماكينات إنتاج، لا أكثر أو أقل، لا بل إن وجود هؤلاء الخاضعين لا مبرر له إلا في خدمة الدولة العليا، وبذل الأنفس في العمل من أجل دفع الضرائب التي تؤمن استمراريتها. وذلك أخذاً بالاعتبار اعتماد الدولة العليا على الغرباء الانكشارية في جيشها، وإخراج من يمت إليها بنسب أو قرابة (السباهية) من الجيش. وفي النهاية، أي في بداية القرن التاسع عشر تم القضاء على الانكشارية نفسها واعتماد وسائل حديثة في الجيش والقتال.
لا بدّ من التحدث عن ما لحق بشعوبنا نتيجة السياسات العثمانية اللاإنسانية، وانتهاكها لمقومات وجودهم، واعتبار الفلاحين، وهم أكثرية السكان، مجرد أدوات أو قطعان تم تجهيلها كي تستحق هذا اللقب، واستخدامها لإغراق الطبقة الحاكمة التي ما كانت تملك الأرض بل تعمل فقط لفترة وجيزة في جباية أهل الأرض، وكانت مراكزها ومناصبها تتبدل بسرعة، أو تتجدد كل عام ليتولى ملتزم الضرائب، أو الوالي منصبه وهو خائف من عدم التجديد له. فليس أمامه إلا جباية الحد الأقصى، وتشليح كل ما يمكن من الفلاحين وبقية الناس، وما دخل في اعتباره عمارة الأرض لأنه معرض في كل لحظة لأن يتركها إلى مكان آخر إذا أتيح له. فالطبقة العليا لم تكن تتشكّل من ملّاك لهم مصلحة في عمارة الأرض لما تدر عليهم من فوائد؛ بل تتشكّل من مقاولين ليس لهم مصلحة إلا في اعتصار خيرات الأرض قبل مغادرتها. قامت الفيودالية الأوروبية على الثبات في الأرض والمصلحة في عمارتها، بينما ارتكز نظام المقاطعجية العثمانية على عدم الثبات في الأرض والخوف الدائم من حلول آخرين في الالتزام الضريبي. فما يهمهم هو المدى القصير، بينما الفيودالية الأوروبية كان في وسعها اعتماد المدى الطويل. فالغابة التي يقطعها ويحرثها كان بحاجة إلى تجديدها، بينما المقاطعجية (ملتزمو الضرائب) العثمانيون ما كانوا بحاجة لتجديد أرض كانوا يعرفون سلفاً أنهم لن يدوموا في حيازتها. وقد بدأ التصحّر قبل نهاية الامبراطورية العثمانية بزمن طويل، مما لم يحدث في الفيودالية الأوروبية. فهؤلاء أيضاً نهبوا الفلاحين واستولوا على المشاعات. لكنهم كانوا بحاجة إلى الاعتناء بالأراضي التي اغتصبوها للرعاية أو للزراعة، لكنها كانت لهم على المدى الطويل. في حين أن الأراضي عند المقاطعجية لم تكن ملكاً لهم بل كانت نظرياً ملكاً لحاكم الدولة المركزية. وفي واقع الأمر لم تكن ملكاً لأحد. ملكية السلطان للأرض كان مؤداها أن تكون لا ملكاً لأحد. فلا يهتم بها من يتصرف بسكانها. ولا يرى فيهم إلا ماكينة تُعتصر منها الضرائب. وإذا كانت المدن العثمانية قد حافظت على حرفها وتجارتها فإن ذلك ما كان إلا لأن المجتمع حافظ على بعض حيويته، برغم سياسات الدولة العليّة. كانت الدولة العثمانية تحمل بذور فنائها في أحشائها، فجاءت الحرب العالمية الأولى إعلاناً لذلك.
وعندما يتساءل أحدهم عن أسباب عدم نمو رأسمالية وطبقة بورجوازية، يمكن أن يكون الجواب في المصادرة وعدم اعتبار الملكية الخاصة للأرض أو للأموال المنقولة. إذ المعروف أنه ما كان يفقد أحدهم منصبه في الدولة العليّة حتى تبدأ دورة التعذيب لمعرفة مكان تخبئة ماله. فلم يكن المال ملكاً أبدياً لصاحبه، بل كان حيازة مؤقتة ما دام في السلطة. كان السلطان هو الآمر الوحيد، وبالتالي المالك الوحيد الذي يحق له بسبب القوة الغاشمة استرداد ماله من ملتزمي الضرائب، الذين يفقدون حيازتهم حالما يفقدون منصبهم، مما جعل التراكم أمراً مستحيلاً.
ما كان هم الدولة العليّة نمو التراكم ولا قيام طبقة بورجوازية. فهي لم تكن لها منافسة مع طبقة فيودالية غير موجودة. والمعروف أن الدولة الحديثة مع ملكية أو بدونها قامت بتحالف السلطة مع البورجوازية ضد الفيودالية. وهذا الأمر لم يكن متاحاً في الدولة العثمانية، التي كان بقاؤها مستنداً إلى المدى القصير والعشوائية في السلطة وفي ملكية الثروات. كانت السلطة الأوروبية، لسبب أو لآخر، تبني دولة بينما كانت السلطنة العثمانية تُهدّم مجتمعات. وقد كان لهذه المجتمعات خزين كبير جعل العشوائية العثمانية قادرة على البقاء قروناً. وما كان البقاء ممكناً لولا هذا الخزين الذي عملت على تبديده. الخراب الكبير الذي تحدث عنه فولين كان حصيلة التدبير الذي أدى إليه الحكم العثماني، الذي كان شأنه سياسياً وعسكرياً وحسب، بينما شأن الامبراطوريات الفيودالية الأوروبية كان اجتماعياً إضافة إلى ما هو سياسي وعسكري.