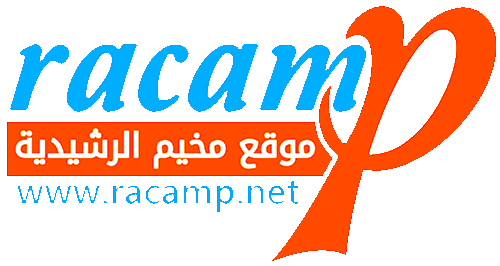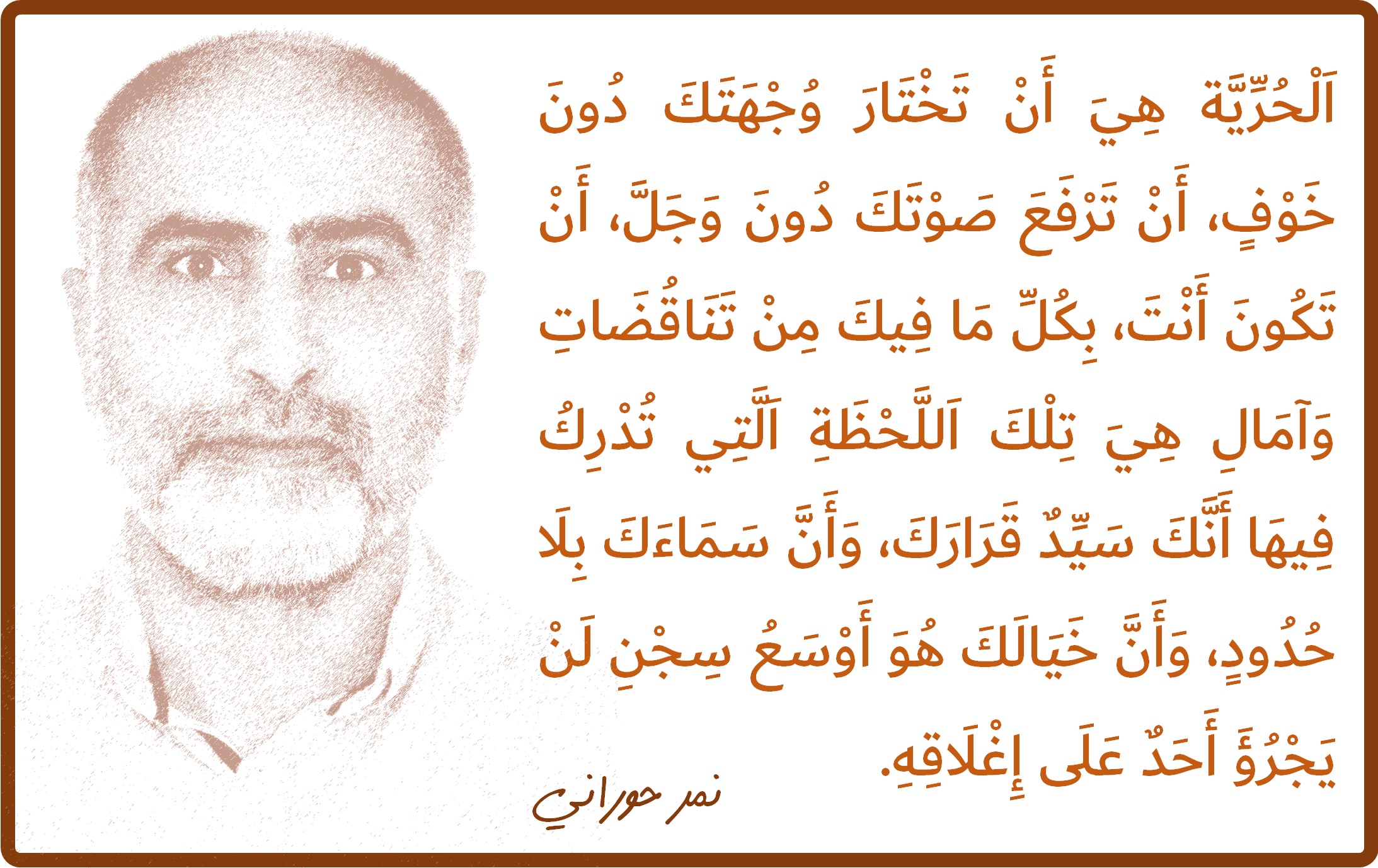عصام الحلبي
في بلد يشهد واحدًا من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، ويترافق فيه تدهور العملة مع تراجع الخدمات الطبية وارتفاع تكاليف الاستشفاء إلى مستويات تفوق قدرة الإنسان العادي، يجد اللاجئ الفلسطيني في لبنان نفسه أمام واقع أشد قسوة. الفلسطيني محروم من الضمان الاجتماعي اللبناني، ولا يتمتع بأي تغطية صحية رسمية، فيما تقتصر خدمات وكالة الأونروا على الرعاية الأولية التي لا تغطي حاجاته المتزايدة والملحة، نتيجة أزمتها المالية الصاغطة، وسط هذا الفراغ، برزت مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني بوصفها مظلة أساسية تحاول حماية ما أمكن من صحة الفلسطينيين، وتخفيف العبء الطبي عن عشرات الآلاف من العائلات.
بدأت فكرة الضمان الصحي الفلسطيني من الحاجة الفعلية، وليس من رفاهية المؤسسات. إذ جاء لتأمين حد أدنى من التغطية للأمراض المزمنة، والعمليات الجراحية الأساسية، والفحوصات المخبرية، والأدوية التي يعجز كثيرون عن شرائها. ومع تراجع قدرة المستشفيات على استقبال المرضى من غير المضمونين، بات وجود الضمان أشبه ببطاقة نجاة تتيح للعائلات الدخول إلى منظومة استشفاء كانت محرّمة عليهم سابقًا.
وفي وقت تتضاعف فيه كافة بدلات الاستشفاء والطبابة، يتدخل الضمان لتسديد جزء من فاتورة العلاج، بعد تسديدة جزء من قبل وكالة الأونروا ” في الآونة الأخيرة أصبحت تحويلات بدل الاستشفاء من قبل الأونروا تتناقص بشكل كبير ، بعد الأزمة المالية التي تعيشها نتيجة عدم التزام الدولة المانحة الايفاؤ بالتزاماتها نتيجة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية”ويترك العبء المتبقي ضمن قدرة العائلة عندما يكون ذلك ممكنًا. ومع مرور الوقت، توسع دور الضمان ليشمل التعاون مع المستشفيات والمختبرات والصيدليات، ما أتاح للاجئ الفلسطيني الوصول إلى شبكة صحية أوسع وأكثر تنسيقًا. وقد ساهم هذا العمل المنظم في تخفيف الفوضى الصحية التي كانت تنتشر داخل المخيمات، وفي خلق مسار واضح يمكن للمريض اتباعه حين يحتاج إلى علاج أو دخول مستشفى.
صحيح أن إمكانات الضمان محدودة، لكنه استطاع، عبر إدارة دقيقة للموارد، أن يصمد في وجه موجات التضخم التي شهدها لبنان، ويستمر في مساعدة المئات يوميًا ولو جزئيًا حسب الإمكانيات المتاحة. ورغم القيمة الكبيرة لهذه الجهود، تعمل المؤسسة في ظروف استثنائية تتجاوز قدراتها. فعدد المرضى يرتفع سنويًا، سواء بسبب ازدياد عدد السكان داخل المخيمات أو بسبب الظروف المعيشية القاسية التي تجعل الأمراض المزمنة أكثر انتشارًا. وفوق ذلك، رفع الانهيار الاقتصادي أسعار المستشفيات والأدوية إلى مستويات لم تعد المساعدات المعتادة كافية لتغطيتها، ما دفع المؤسسة إلى السعي باستمرار لتحديث عقودها مع المستشفيات وإعادة تقييم قوائم الأدوية التي تدعمها.
مع ذلك، ظلت المؤسسة تحافظ على فلسفتها الأساسية، وهي مساعدة كل محتاج بقدر الإمكان ومنع الانهيار الصحي الكامل داخل المخيمات. فالفلسطيني الذي لا يملك ضمانًا صحيًا رسميًا ولا شبكة حماية اجتماعية، وفي ظل تغطية جزئية من قبل الأونروا، يجد نفسه أمام خيارات ضيقة، وأي تأخير في العلاج قد يقوده إلى مضاعفات خطيرة. وفي هذا السياق، لعب الضمان الصحي الفلسطيني دورًا إنسانيًا ووظيفيًا بالغ الأهمية، إذ لم يكن مجرد مؤسسة تقدّم المعونة، بل مظلة لحماية مجتمع كامل من الانهيار الصحي.
إن متابعة عمل المؤسسة تكشف عن مزيج من الجهد المهني والإحساس العميق بالمسؤولية. فالعاملون فيها يتحركون يوميًا بين الضغوط المالية وارتفاع حالات المرض وطلبات الاستشفاء الطارئة التي لا تحتمل التأجيل. ومع أن موارد المؤسسة لا تكفي لتلبية كل الطلبات، فقد نجحت في خلق توازن بين الحاجة والقدرة، وبين ما هو ممكن وما ينبغي فعله. وهذا التوازن هو ما سمح لها بالاستمرار رغم العواصف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.
وربما تكمن القيمة الأهم للضمان الصحي الفلسطيني في كونه خط الدفاع الثاني بعد مؤسسة محمود عباس التي تدعم التعليم، فالتعليم والصحة هما الركيزتان الأساسيتان لأي مجتمع يسعى إلى البقاء والصمود. وإذا كان التعليم يفتح أبواب المستقبل للشباب، فإن الصحة تحمي أسرهم وتحفظ كرامتهم. ومن هنا، تتكامل المؤسستان في خدمة الفلسطينيين في لبنان، كلٌّ حسب اختصاصه، ولكن بالروح نفسها: روح الالتزام تجاه شعب يعيش في ظروف استثنائية منذ أكثر من سبعين عامًا.
إن استمرار مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني في تقديم خدماتها رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، وازدياد الحالات المرضية وارتفاع التكاليف الطبية، ليس مجرد إنجاز إداري، بل تعبير عن قدرة المجتمع الفلسطيني على حماية ذاته بموارده المحدودة، فهذه المؤسسة، كما غيرها من المؤسسات الفلسطينية، تمثل شبكة أمان تسند آلاف العائلات، وتوفر لها حدًا من الطمأنينة في واقع لا يرحم، وتؤكد أن التضامن الداخلي لا يزال أقوى من كل الظروف المحيطة.