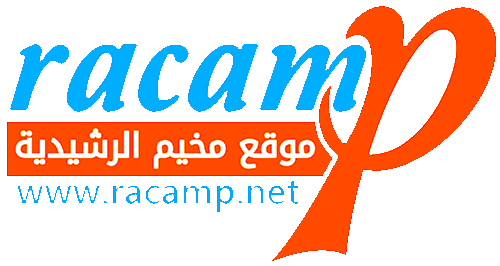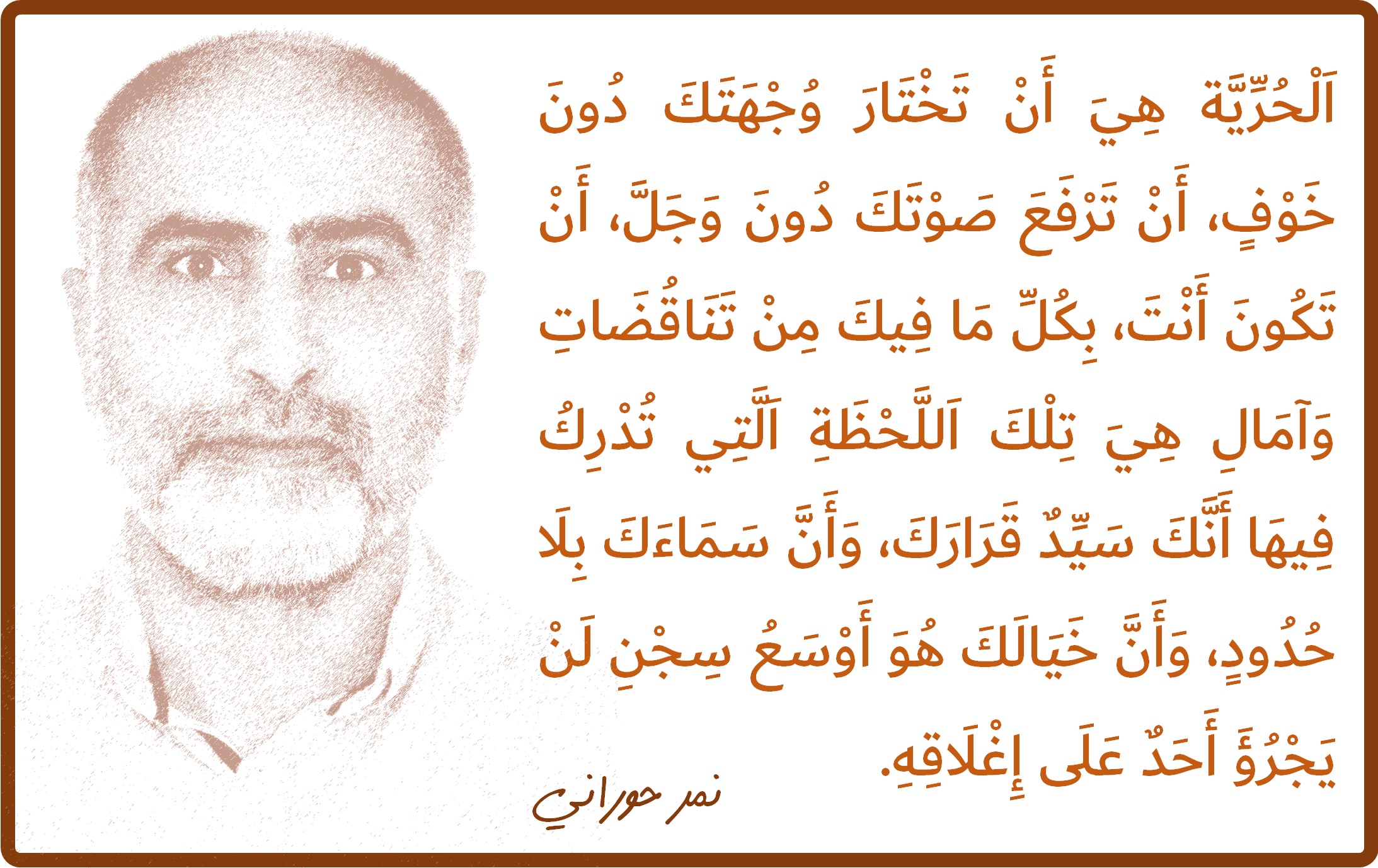خالد بركات
أثبتت المقاومة الفلسطينية، خلال حرب الإبادة المستمرة، قدرتها العالية على الصمود والمبادرة، ونجحت في ترسيخ حضورها بوصفها الفاعل المتقدّم في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري. غير أنّ هذه الحقيقة، على أهميتها، لا تُلغي أزمة جوهرية تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية عموماً، وفي القلب منها المقاومة المسلحة على وجه الخصوص: غياب المشروع السياسي التحرري، وغياب الجبهة الوطنية القادرة على تحويل الفعل المقاوم إلى مسار تحرري سياسي واجتماعي شامل.
فلا يمكن لأي حركة تحرّر تواجه استعماراً استيطانياً إحلالياً أن تنتصر بالبطولة العسكرية وحدها، مهما بلغت تضحياتها، إن لم تكن هذه البطولة مسنودة برؤية فكرية وسياسية واضحة، وباستراتيجية وطنية يشارك الشعب في صياغتها، تُحدِّد الهدف، وتدير الصراع، وتمنع الالتفاف على الإنجازات.
غياب الجبهة الوطنية الموحدة بعد موت منظمة التحرير
لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية، في لحظة تأسيسها، مجرد إطار تمثيلي شكلي، بل كانت جبهة وطنية جمعت مختلف الطبقات الاجتماعية وقوى الثورة في مواجهة الاستعمار الصهيوني. غير أنّ هذا الدور انتهى عام 1974 (تبنّي شعار الدولة بدل التحرير) ثم انتهى عملياً مع مسار أوسلو (1993) حيث جرى تفريغ المنظمة من مضمونها التحرري، وتحويلها إلى جسم منزوع الإرادة، خاضع لمنظومة السلطة والتزاماتها الأمنية.
اليوم، لم تعد منظمة التحرير تُشكّل جبهة وطنية، بل تحوّلت إلى «ختم» ويافطة سياسية تُستخدم لتوفير غطاء شكلي لقوى التنسيق الأمني، وشرعنة مسار سياسي منقطع كلياً عن مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحررية. هذا الموت السياسي للمنظمة خلق فراغاً وطنياً خطيراً، يتمثّل في غياب جبهة وطنية قادرة على إدارة الصراع بوصفه صراع وجود، لا نزاعاً على سلطة وصلاحيات.
وفي ظل هذا الفراغ، تعمل قوى المقاومة دون إطار وطني موحِّد، ما يجعل فعلها، رغم بسالته، عرضة للتجزئة والاستنزاف، ويمنع تحويل الإنجازات الميدانية إلى رصيد سياسي تحرري متراكم. وهذا هو درس التاريخ على مدار قرن من الصراع؛ إذ لم تكن الأزمة في استعداد الشعب الفلسطيني للعطاء والتضحية، بل في قيادة سياسية كانت تأخذه، بعد كل ثورة وانتفاضة، إلى اتفاقيات وأوهام، وإلى حصار أشد وأرض أقل.
ارتباك قوى المقاومة أمام وهم «المصالحة» و«الوحدة الوطنية»
تُظهر قوى أساسية في المقاومة ارتباكاً سياسياً واضحاً في مقاربتها لمسألة ما يُسمّى «الوحدة الوطنية»، حيث يجري الخلط بين الوحدة على أساس برنامج ثوري تحرري واضح، وبين الشراكة مع قوى السلطة والتنسيق الأمني. هذا الخلط لا يُنتج وحدة، بل يخلق وهماً سياسياً يُكبّل المقاومة بدل أن يعزّزها، ويصبّ في مصلحة قوى مهزومة وطبقات باعت فلسطين من أجل تأمين امتيازاتها الطبقية.
إنّ السعي إلى وحدة مع قوى ثبت، بالوقائع، دورها الوظيفي في «ضبط الشارع الفلسطيني» وحماية أمن الاحتلال، لا يمكن أن يكون مدخلاً للتحرير، بل يعكس غياب الرؤية السياسية لدى بعض قوى المقاومة في تحديد طبيعة المرحلة، والعدو الرئيسي، وحدود التناقض.
وقد أدّى هذا الارتباك إلى القبول العملي بمعادلات تُبقي المقاومة في موقع الدفاع السياسي، وتمنح قوى فقدت شرعيتها الوطنية قدرةً على ابتزازها باسم «الشرعية» و«المصالحة الوطنية»، في حين تُفرَّغ هذه المفاهيم من مضمونها التحرري الحقيقي.
الضعف أمام التحالفات الإقليمية وحدودها
لا يمكن فصل أزمة المشروع السياسي للمقاومة عن علاقتها بتحالفاتها الإقليمية، وبخاصة مع قطر وتركيا ومصر. فهذه العلاقات، رغم ما توفّره من هوامش «دعم» أو حركة، تفرض في المقابل قيوداً سياسية واضحة، وتدفع المقاومة إلى مراعاة حسابات أنظمة لا تنظر إلى فلسطين من زاوية التحرير، بل من زاوية إدارة الصراع وتدويره.
إنّ الارتهان النسبي لهذه التحالفات، أو التعامل معها بوصفها بديلاً من العمق الشعبي العربي والإسلامي والأممي، يُضعف استقلالية القرار السياسي للمقاومة، ويحدّ من قدرتها على بلورة خطاب تحرري جذري، ويتناقض مع طبيعة الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني.
فالدول المذكورة، مهما اختلفت أدوارها، تظل حليفة لواشنطن، وتشترك في السعي إلى ضبط المقاومة لا إلى تفجير طاقاتها، وإلى الاحتواء لا إلى التحرير. وأي مشروع سياسي يتجاهل هذه الحقيقة سيبقى مشروعاً ناقصاً، قابلاً للالتفاف والتفريغ.
وهم «الدعم العربي» ودور النفط في تخريب الثورة الفلسطينية
تقول التجربة التاريخية الفلسطينية إن ما سُمّي طويلاً بـ«الدعم العربي الرسمي» لم يكن، في جوهره، سوى وصفة لتخريب الثورة الفلسطينية وإفساد بنيتها القيادية والسياسية، وقد استُخدم هذا «الدعم» أداةً للضبط والاحتواء، وربط القرار الوطني الفلسطيني بحسابات الأنظمة لا بمصالح التحرير.
لم يكن المال النفطي دعماً بريئاً، بل وسيلة لإعادة هندسة القيادة، وتشجيع البيروقراطية، وإضعاف الطابع الشعبي الكفاحي، وتحويل الثورة إلى جهاز يعتمد على التمويل الخارجي ويخضع لشروطه وسقوفه السياسية. هكذا انتقل الخطاب الفلسطيني من «الثورة» إلى «الدولة» إلى «السلطة» وصولاً إلى العدم.
ومع تراجع هذا «الدعم»، انتقلت هذه المهمة إلى ما يُسمّى «الدول المانحة» الأوروبية، وإلى «الدعم» الأميركي المباشر وغير المباشر، حيث جرى تقاسم وظيفي أوروبي–أميركي لربط التمويل بشروط سياسية وأمنية وقانونية، تهدف إلى نزع الطابع التحرري عن القضية الفلسطينية وتحويلها إلى «ملف إنساني-أمني» منزوع عن طبيعة الصراع وحقائقه.
وفي هذا السياق، جرى تفريع المؤسسات الوطنية، والسيطرة شبه الكاملة لما يُعرف بـ«المنظمات غير الحكومية»، التي لعبت دوراً محورياً في تفكيك البنية الوطنية الجامعة، واستبدال النضال السياسي من أجل الحقوق الوطنية إلى خطاب «حقوقي» و«مدني» لا صلة له بجوهر القضية.
وبالتوازي، تعرّض الفلسطينيون في الشتات لعملية مصادرة ممنهجة لدورهم التاريخي في المشروع الوطني. جرى تدجين سلاحهم، وتدمير اتحاداتهم النقابية والشعبية، وتحويلها إلى هياكل شكلية أو أطر خاضعة لشروط الدول المضيفة. واليوم تُنفَّذ هذه العملية علناً، عبر محاولات منع فلسطينيي الشتات من المشاركة في أي عملية تغيير أو إعادة بناء للمشروع التحرري. يُراد لهم أن يكونوا «جاليات» بلا دور سياسي، في حين أنّ الشتات كان ولا يزال العمود الفقري لأي مشروع تحرر فلسطيني.
خلاصة
إنّ على المقاومة الفلسطينية أن تُقدّم للشعب الفلسطيني، دون تردد، مشروعها السياسي الوطني الشامل، بوصفه استحقاقاً فرضته التضحيات والتحولات التي أحدثها «طوفان الأقصى». وليس مطلوباً منها العودة مرة أخرى إلى ما سُمّي بـ«المصالحة الفلسطينية»، بعد أن أثبتت التجربة أنّ هذا المسار لم يكن سوى آلية لإعادة إنتاج منظومة الفشل والتنسيق الأمني. فما جرى بعد السابع من أكتوبر قد جبّ ما قبله، وفتح مرحلة جديدة لا يمكن إدارتها بأدوات قديمة.
اليوم، نحن أمام شرعية ثورية جديدة، مدعومة بشرعية شعبية واسعة وغالبية فلسطينية حقيقية، رأت في المقاومة ممثلاً لإرادتها وكرامتها، في مقابل قوى تخلّت عن غزة وشعبها ومقاومتها الباسلة. وأخطر ما يمكن أن تواجهه المقاومة هو أن تظل متفرجة على هذه الألغام القاتلة وهي تزرع في العلن، وعلى مؤامرة هدفها تفريغ منجزات «طوفان الأقصى»، على يد واشنطن وتل أبيب وأنظمة التطبيع ومَن فقدوا ضميرهم وشرعيتهم الوطنية.
* كاتب فلسطيني