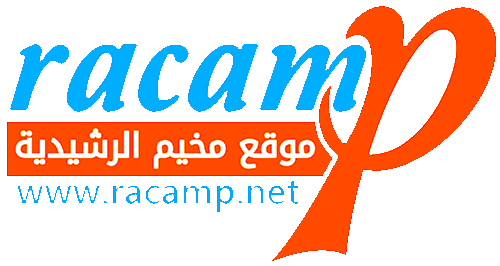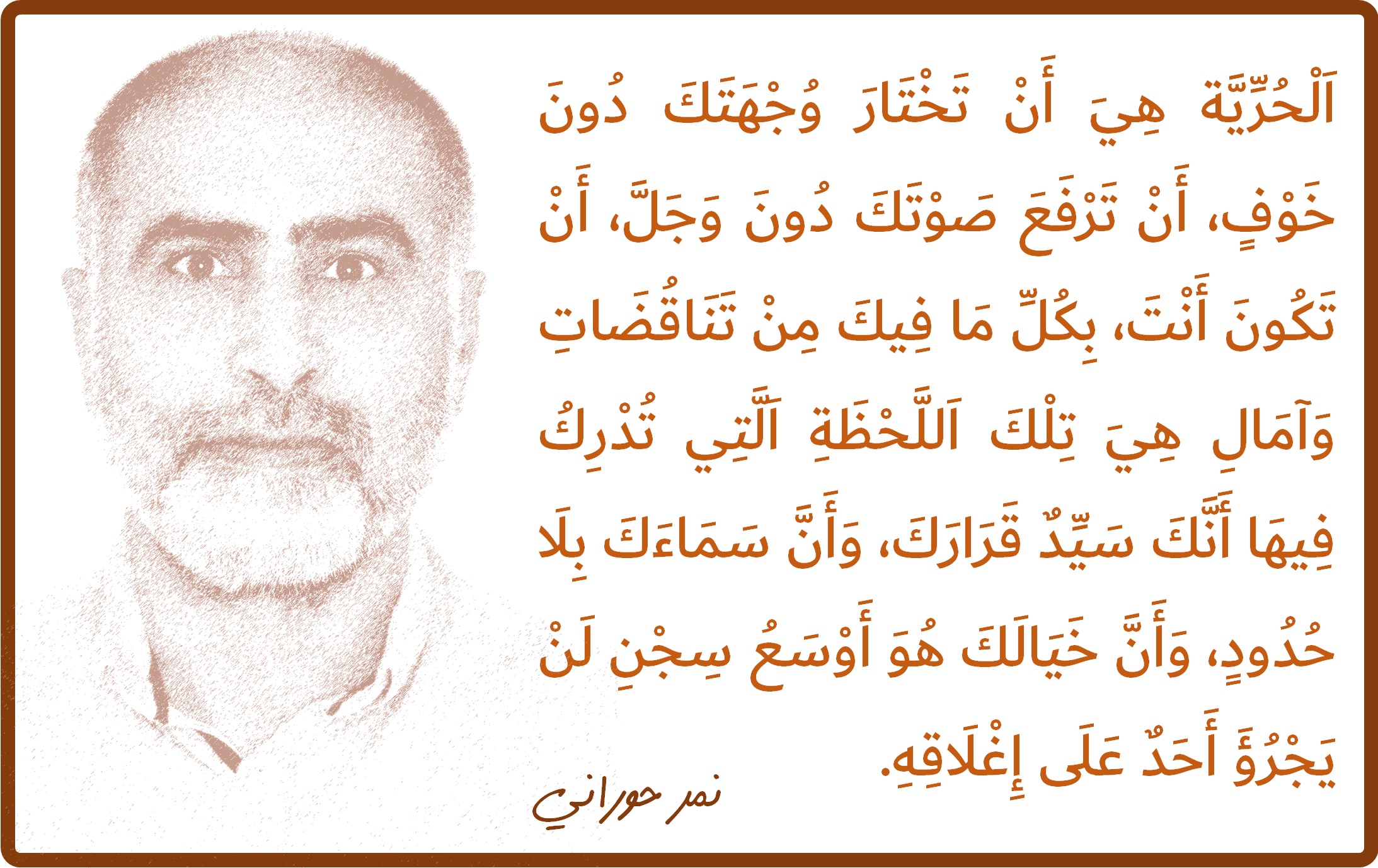بقلم د. عبدالرحيم جاموس
ليس الوهم مجرّد سوء تقدير، بل حالة سياسية خطيرة تُنتج شعورًا زائفًا بالطمأنينة، في اللحظة التي يُعاد فيها تشكيل الواقع قسرًا ، وهذا بالضبط ما نشهده اليوم في قطاع غزة تحت عنوان مضلِّل اسمه: “المرحلة الثانية”.
ما يُعلن عن هذه المرحلة لا يعكس حقيقتها الكاملة. فالأخطر أن ما يجري فعليًا لا يشبه الحرب، ولا يقترب من التسوية، بل يقع في منطقة رمادية شديدة الخطورة: إدارة باردة للصراع، هدفها منع انفجاره دون منحه أي معنى سياسي أو وطني، ودون الاعتراف بجذوره وأسبابه.
التحول الجوهري لم يكن ميدانيًا، بل استراتيجيًا. فالسؤال الدولي لم يعد: كيف نُنهي الحرب؟ بل أصبح: كيف نمنع عودتها دون أن نمنح أي طرف نصرًا سياسيًا؟ هنا تغيّرت قواعد اللعبة.
لم تعد القضية سيادة وقرار وحقوق، بل “استقرارًا قابلًا للاختبار”، يُقاس بالانضباط لا بالعدالة.
المرحلة الثانية لم تبدأ مع الإعلان عنها، بل بدأت منذ غاب النقاش السياسي الحقيقي، وتأجل ملف الشرعية، وجرى التركيز على “الإدارة” بدل السيادة. حين يسبق التنفيذ الإعلان، فهذا يعني أن القرار قد اتُّخذ، وأن ما يُطرح لاحقًا ليس سوى إدارة نتائجه لا مناقشتها.
الحديث عن “إدارة تكنوقراطية” يُقدَّم كحل محايد، لكنه في جوهره أداة تفكيك ناعمة: سحب الوظائف من الفصائل، تجفيف مصادر النفوذ، وإضعاف مراكز القوة دون مواجهة مباشرة.
لا يُطلب تسليم السلاح، لكن يُطلب تحمّل كلفته اقتصاديًا وخدميًا وشعبيًا، ليُستنزف تدريجيًا ويتحوّل من عنصر قوة إلى عبء داخلي.
أما الإعمار، فيُستخدم كسوط ناعم ، فهو ليس شاملًا ولا مستدامًا، بل مجزأ، مشروط، وقابل للإيقاف عند أول “خرق”.
كل مشروع، وكل شاحنة إسمنت، وكل راتب، يُربط بسؤال أمني غير مكتوب: هل الوضع “منضبط” بما يكفي؟ وفي الخلفية، يُنقل القرار من الداخل الفلسطيني إلى آليات دولية مغلقة، فيما تبقى إسرائيل خارج الإدارة المباشرة، لكنها داخل التحكم، تملك حق تعريف الخرق وحق تعطيل المسار دون أن تتحمل كلفة الفشل.
الأخطر في هذا المسار أنه لا يُغلق دفعة واحدة، بل يُقفل بالتدريج.
كل يوم يمر دون موقف وطني جامع، تُنتزع فيه ورقة جديدة من اليد الفلسطينية: مرة باسم الإعمار، ومرة باسم الاستقرار، ومرة باسم منع الحرب.
وحين يكتمل المشهد، لن يُقال إن القرار سُرق، بل سيُقال إن الفلسطينيين تخلّوا عنه طوعًا، لأنهم لم يعترضوا في اللحظة التي كان فيها الاعتراض ممكنًا وذا أثر.
في المقابل، يُروَّج لخطاب “الانتصار” بوصفه تعويضًا نفسيًا عن غياب القرار، ووسيلة لتسكين الضمير الجمعي، خصوصًا خارج غزة.
خطاب لا يغيّر الوقائع، ولا يحمي الشرعية، ولا يمنع الاستنزاف، لكنه يمنح شعورًا زائفًا بالرضا الأخلاقي. وهنا يكمن الخطر الحقيقي: أن يتحول الوهم إلى بديل عن الفعل، وأن يُسوَّق الصمت كحكمة، والانتظار كاستراتيجية، فيما يُعاد تشكيل الواقع بهدوء.
أخطر ما في الوهم أنه لا يمنح الأمل، بل يعفي من المسؤولية، بينما يُدفع الناس ثمن واقع لم يشاركوا في صناعته، ليكتشفوا متأخرين أنهم خرجوا من المشهد، لا لأنهم هُزموا، بل لأنهم سلّموا وعيهم للوهم.