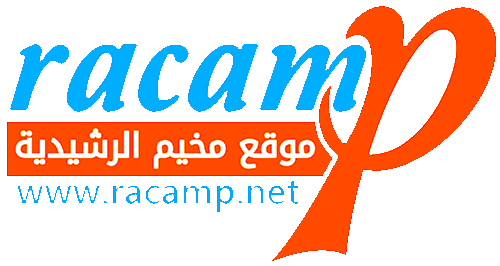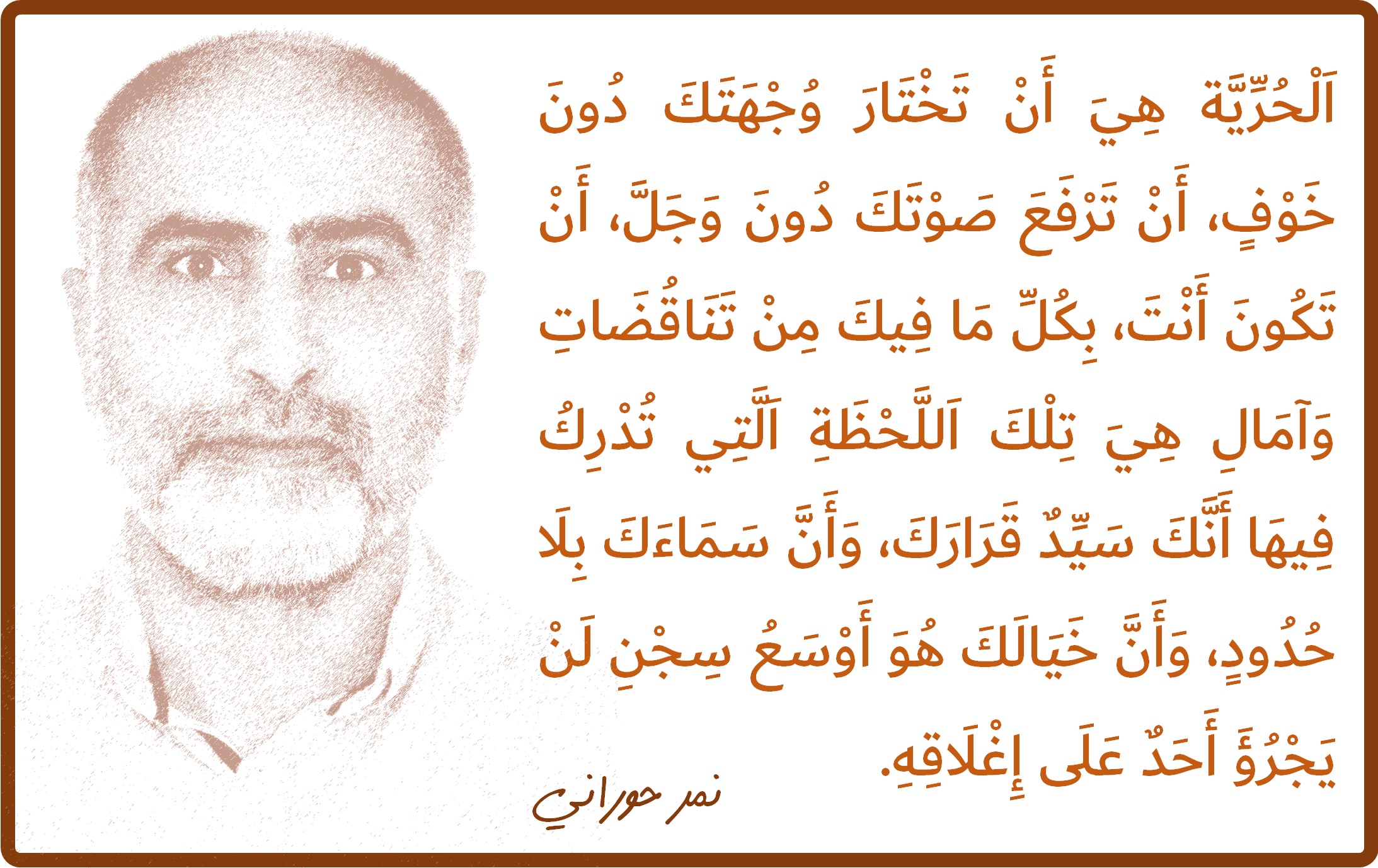أيهم السهلي
لمّا انطلقت الحركة الوطنية الفلسطينية، في أواسط القرن العشرين، وقبل النكبة، في ثلاثينيات القرن الماضي، كانت تقوم بالمستحيل. وكانت خطواتها الأولى تحبو، أيضاً، نحو المستحيل.
وكان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، في أواسط خمسينيات القرن الماضي، بعضه «يسكن» في الخيام، وقد بدأ يكوّن نواة الحراك التحرري من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، عبر الكفاح المسلح.
وهذا ما دعا إليه «بيان حركتنا» عام 1959، بقلم أصحاب فكرة «فتح» في الكويت، الذي يبين واقع الشعب الفلسطيني في تلك الأيام تحت عنوان «حتمية انبثاق الحركة»، بالقول: «أياً كانت الأسباب التي أدت إلى ضياع فلسطين، فإن ذلك لا يغيّر حقيقة الواقع الذي يعيشه شعب فلسطين الآن… إن شعبنا يعيش الهزيمة الوطنية… ويقاسي نكبتها الأليمة منذ نشأتها. ولم تتح الحكومات العربية لشعبنا أن يتجمع ويوحّد صفوفه، ويخطط منهاجاً ثورياً بنّاء لاسترداد وطنه.
ولذا استمرت أوضاعنا تسير من سيئ إلى أسوأ، وتمزَّق شعبنا وتفرقت صفوفه وتعددت به السبل، وظهرت بينه مختلف الشعارات، لكن بارقة أمل لم تظهر. بل أصبح الجو مليئاً بأصوات الخيانة وتسريحات المتخاذلين، ووجدت هذه من يدافع عنها حينما يخمد كل صوت يبرز لمعارضتها».
ما سبق، وإن كان تاريخياً يوصّف الشعب الفلسطيني في سنوات ما بعد النكبة، إلا أنه أيضاً يوصّف شيئاً من واقع الشعب الفلسطيني اليوم. هذا مع الفارق الرئيسي؛ أن الفلسطينيين بعد النكبة كانوا يلملمون شتاتهم، ويستوعبون الكارثة التي حلت بهم، ويسعون إلى إطلاق هويتهم الوطنية. بينما اليوم، لديهم كيانيّتهم الوطنية، ولديهم كيانهم الهش، المسمى «دولة» تحت الاحتلال، وأكثر من نصف الشعب في الداخل والخارج، في شتات عميم.
سنوات الجمر ما بعد النكبة، ومنذ ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الانتفاضتين، وقبلهما مواجهة الاجتياح والصمود في بيروت 1982، ومواجهة اجتياح لبنان 1978، كلها عوامل أعطت الشعب الفلسطيني طاقة أمل وإقدام، كما أعطت العرب قدرة على المناورة السياسية والعسكرية.
جاء يوم السابع من أكتوبر، وفجّر طاقات كامنة لدى الفلسطينيين، قلة منهم فقط من كرهوا أو رفضوا الحدث، بينما الغالبية العظمى تجاوبت وتفاعلت، والمعظم عبّر عن قناعاته ومشاعره قولُ الشاعر الفلسطيني الكبير تميم البرغوثي «تحريرها قد بدأ»، و«تحريرها كلها ممكن». الذين لم يجدوا في الحدث، حدثاً هائلاً، ووجدوه هولاً، كانوا ينظرون إلى اللحظات التالية، إلى ما ستفعل إسرائيل.
الكل محق في رد فعله، الذي تحمّس، لأن واقعه كما وصّفه «بيان حركتنا». والذي تخوّف ورفض، لأن إسرائيل موغلة في القتل والسفك، منذ أن بدأ العالم بدفع المستوطنين إلى استيطان أرضنا.
ولأننا بعد أكثر من عامين على «طوفان الأقصى»، وأكثر من 60 عاماً على انطلاقة الثورة الفلسطينية، من البديهي أن نقوم بمراجعة لكل ما حدث في تلك السنين، وفي السنتين الماضيتين، والمراجعة عليها أن تشمل الجانب المتعلق بالناس، كون كل عمل مسلح، هدفه الأرض صحيح، إنما من أجل الشعب.
لن تخمد مواجهة الاحتلال في يوم من الأيام، ولن تتوقف في لحظة من اللحظات، لكن الشكل المسلح منها قد يدخل في مرحلة كمون إرادي، يعيد فيها تأسيس الإمكانات التي تضعف بالضرورة مع الوقت. وفي حالة غزة، خاضت المقاومة حرباً امتدت لعامين، لم يتمكن في نتيجتهما الاحتلال من تركيع المقاومين، ولا سحب السلاح منهم، كما لم يحقق نصراً عسكرياً عليهم.
بالتوازي، يستمر الاحتلال بحربه على المقاومة في فلسطين، وعلى حلفائها في الخارج، الذين أصيبوا بضربات قوية. إلا أن المقاومة ظلت في غزة، هي الطرف المفاوض، بمعنى أنها الطرف المقرر. كما إن قوى المقاومة في الخارج، يدها عالية، وتمتلك القدرة على المناورة، وإن كانت تتلقى الضربات ولا تقاتل، على الأقل إلى الآن.
ما يحدث بعد إيقاف إطلاق النار، في تشرين الأول 2025، أن الحرب لم تتوقف، بل استمرت من قِبل إسرائيل. أما المقاومة، فترد بين حين وآخر، لتقول إنها مستمرة ولن تنتهي، وأن المشاريع المرسومة، لن تمر، أو لن تمر من دون تصويب وحساب لمصالح الفلسطينيين. وفي هذا الأداء من المقاومة في غزة، حكمة وإدارة معقولة للوضع الراهن، وفي ذلك فهم لـ«موافقتها» على إدارة غزة بـ«تكنوقراط» تم تشكيله دولياً. لا شك أن إمكانية الرفض لديها موجودة، بحكم الأمر الواقع، وبحكم ما هو موجود فوق الأرض وتحتها ربما، لكن مع مليوني فلسطيني يحتاجون، بعد عامين من حرب الإبادة، إلى كل شيء، فعلياً وعملياً، لم يكن أمام قوى المقاومة سوى القبول بما فُرض.
وإن كان المشهد البادي أمامنا، فيه إجبار، إلا أنه أيضاً كسب للوقت، حتى تتغير بعض موازين القوى، وربما بانتظار أن يعيد التاريخ دورته، كما حدث بعد النكبة، فيقصي حكاماً وحكومات من العرب، كان يمكن لهم أن يمنعوا كل ما حدث في فلسطين، أو بعضه على الأقل، هذا لو أن من شيمهم الوطنية، والإيمان بما لديهم من قوة شعوبهم.
ما يريده أعداء فلسطين، هو تفكيك قضيتها، عبر طرد شعبها من أرضه، وإنهاء ملف اللاجئين في الخارج، وإبعاد العرب والمسلمين عن هذه القضية. لذا يمكن النظر إلى الوضع الفلسطيني الراهن من زاوية جديدة، هي فهم الواقع بعناوين واضحة، معركة البقاء في الأرض، وإعادة الحياة لأهالي قطاع غزة، والحفاظ على المواجهة، من أجل تحقيق الأهداف، في الحرية والتحرير.
إن قوى المقاومة اليوم، تدرك أن «الكفاح المسلح» هو استراتيجية من أجل تحقيق الهدف النهائي، وهو تكتيك من أجل إنجاز المهمات المرحلية. والحرب الممتدة منذ أكثر من عامين، أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، شهداء القتل والتدمير، والتجويع، والمرض، وحققت أيضاً إنجازات كبيرة وكثيرة، إذ عادت فلسطين إلى واجهة اهتمام العالم، وجعلت إسرائيل منبوذة في كثير من المجتمعات في البلدان التي كانت راعية ومتعاطفة معها، وكذلك عرّت قوى العالم المتصالحة مع القتل والتدمير، والمبررة لما فعلته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، والمنطقة، والعالم.
يستحق الشعب الفلسطيني الحياة، ويستحق أن يحيا فوق أرضه بعز وكرامة، ولا بد من أجل تحقيق ذلك، من خوض الكفاح، والإقدام والإيمان بأن إمكانية النصر ممكنة، لكنها تحتاج إلى مشروع يجمع الجميع تحت راية فلسطين، وتقوده ثلة من الصادقين العارفين المؤمنين بأن الحق حق مهما طال الزمن، ومن أجله يُخاض المستحيل.
* كاتب فلسطيني