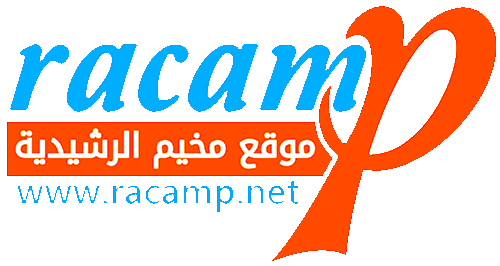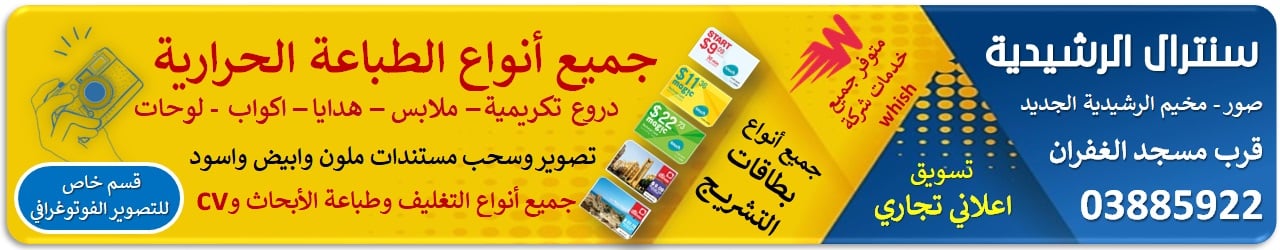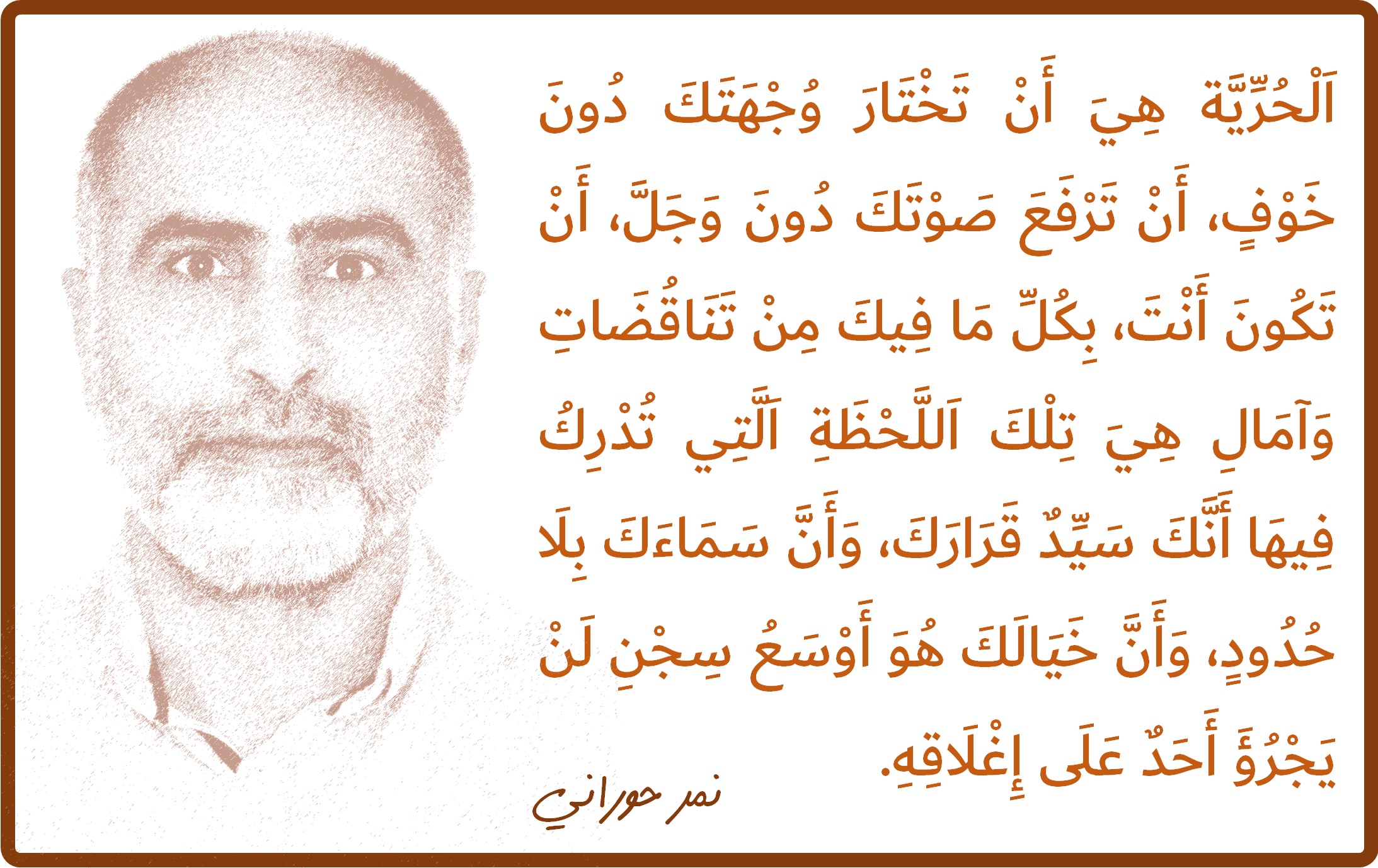مجد درويش
قبل 63 سنة، أنهى غسان كنفاني روايته «رجال في الشمس» بسؤال لاذع يهزّ الوجدان الفلسطيني والعربي: «لماذا لم يدقّوا جدران الخزان؟». سؤال موجّه إلى فلسطينيّي الخارج بالأخص، وهدفه تحفيزنا لنغيّر من واقعنا الزائف بما أنه يدور حول أكذوبة «الخلاص الفردي» في «بلاد الشمس»: أن نكون فلسطينيين «موسميين». أو تكون فلسطين، في نظرنا، عبارة فقط عن فولكلور نتفاخر به أمام الآخرين.
وهو ما يحدث لدى العديد منّا لمّا يندلع أيّ حدث كبير في فلسطين: نغرق في النشر على وسائل التواصل من أخبار ومواقف عن الحق الفلسطيني ومعاناته وكيف يظلمنا العالم وما شابه، ونتابع الأخبار أولاً بأول، ونخرج في تظاهرات، إذا سُمح لنا، وعند «انتهاء الحدث» نعود إلى روتيننا الطبيعي كما قبل كأنّ شيئاً لم يحدث، أو نعتاد المشهد ونعود إلى روتيننا السابق كما حصل مع الكثيرين أثناء حرب الإبادة.
لنفهم ما الذي يجب أن نفعله، فمن واجبنا أن نبحث عن أجوبتنا من خلال التعرّف إلى الذين عاشوا معنا في «بلاد الشمس» لكنهم عزموا على العودة إلى الوطن ولعبوا دورهم في مشروع «الخلاص الجماعي»، وخوض الصعاب مع شعبهم. ولا أقول -ومَن أنا لأقول- إنّ دربهم هو السبيل الوحيد للانخراط الصحيح في القضية الفلسطينية، لكنّ طريقهم هو الأوضح والأسمى.
أستاذ جامعة برنستون الذي وجد جدواه في الثورة
حنا ميخائيل، عمل أستاذاً جامعياً في أميركا حيث أقام فترة طويلة وذاع صيته هناك، لكن بعد نكسة 1967 قرّر أن يترك كل ذلك من أجل قضيته، وكان متأكّداً من قراره ولم يتردّد. بل رأى أن حصوله على الدكتوراه من جامعة هارفرد، وعمله أستاذاً في كل من جامعة برنستون وجامعة واشنطن، كانا بلا جدوى -على حدّ تعبيره- وأن «الجدوى في العمل لتغيير الواقع هنا»، أي في فلسطين.
سافر حنا ميخائيل إلى الأردن، مقر الثورة الفلسطينية آنذاك، من أجل أن ينضم إلى حركة «فتح». عاش بين الكادحين والمقاتلين في قواعد الفدائيين وفي أزقة المخيمات، وكان حريصاً أن يعيش كما يعيشون وأن لا يستفيد من موقعه وتضحياتهم كما فعل بعض القيادات. ساهم في وضع برنامج تثقيفي سياسي واعتمد الكلمات البسيطة والعامية لتكون الأفكار جماهيرية ومفهومة عند العامّة. وكان يفعل ذلك عن وعيٍ منه بأن الثورة لا يمكن أن تكون حكراً على النخب، بل هي ملكٌ للشعب كله. رفض أن يترك القوات الفدائية وحدَها في أحراج عجلون، بعدما طُردت فصائل الثورة من كل مواقعها الأخرى في الأردن بسبب أحداث «أيلول الأسود»، فقرّر البقاء مع الفدائيين في الأحراج وبقي صامداً فيها إلى أن أنهى الجيش الأردني وجود الثورة فيها.
انتقل إلى بيروت وبعد بضع سنين اندلعت الحرب الأهلية وكان وقتها يعمل على مشروعه الأبرز والأهم في نظره وهو كتابة تاريخ العرب الحديث من منظور عربي تقدّمي يفنّد أعمال المستشرقين. اعتبر هذا المشروع حلمه وواجبه تجاه الثورة وشعبه وأمته ومن شدّة تعلّقه به كان يقول لزوجته، إنه لا يريد أن يموت قبل «استكمال كتابة تاريخنا الحديث».
أولويات حنا ميخائيل تغيّرت عندما واجهت الثورة الفلسطينية خطراً وجودياً في شمال لبنان بسبب الحصار اليميني الكتائبي والسوري المميت على طرابلس، فلم يقبل فكرة عدم مشاركته بمهمة أوعزت إليه ومجموعة من رفاقه وهي الذهاب إلى شمال لبنان بزورق، لا عن طريق البر بسبب السيطرة اليمينية على الطرقات، للمساهمة في التخفيف عن قوات الثورة وأبناء شعبها في الشمال. ركب حنا ميخائيل ورفاقه الزورق واختفوا في ظروف غامضة ولم يُكشف عمّا حدث بالتحديد إلى يومنا هذا (على الأغلب قد تمّ خطفهم من قبل الكتائبيين وأُعدموا).
لقد ضحّى حنا ميخائيل بمستقبله الأكاديمي في أميركا من أجل قضية شعبه، وضحّى بنفسه ومعه مشروع الحلم لتوثيق تاريخ العرب من أجل إنقاذ الثورة وشعبه في شمال لبنان.
وجدير بالذكر أن حنا ميخائيل كتب قصيدة باللغة الإنكليزية اسمها «عندما بلغت الأربعين» وفيها يقول، إن عطاءه الحقيقي لم يبدأ إلا عندما انضم إلى الثورة الفلسطينية.
أميركا لن تكون المحطة النهائية
لم يكن حنا ميخائيل وحده من تخلّى عن الحياة الأكاديمية المُريحة في أميركا من أجل القضية الفلسطينية؛ فإلياس شوفاني، وهو من فلسطينيّي الـ48، ترك مهنته كأستاذ في جامعة «ميرلاند» وتنازل عن كل من جنسيتيْه الأميركية والإسرائيلية ليلتحق بصفوف «فتح» بعد حرب أكتوبر 1973. كان تخلّيه عن الجنسية الإسرائيلية وإصراره على عدم العودة إلى فلسطين إلا بعد تحريرها تجسيداً عملياً لجملة معبّرة لغسان كنفاني في روايته «عائد إلى حيفا»: «كل الأبواب يجب ألّا تُفتح إلا من جهة واحدة، وأنها إذا فُتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مُغلقة لا تزال».
ومثلما فعل شوفاني وميخائيل في زمنهما، ظهر بعد عقود قليلة نموذجٌ آخر لتلك الروح المقاومة الرافضة لفكرة الخلاص الفردي على حساب القضية الفلسطينية، مُمثّلةً في جمال الزبدة، المسؤول السابق عن دائرة التصنيع العسكري في «كتائب القسام» والذي اغتيل خلال معركة «سيف القدس»؛ فقد ترك عمله في وكالة «ناسا» في أميركا وعاد إلى قطاع غزة حيث وُلد ليدرس في الجامعة الإسلامية ويرأس قسم الهندسة الميكانيكية فيها، مساهِماً -في الخفاء- في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة.
سُئل يوماً ما من قبل أحد تلاميذه: «حد بسيب أمريكا وبرجع ع غزة؟»، فأجاب: «هذه البلاد أمانة وقضية ومن عنده انتماء إلى قضيته لا أميركا ولا ألف أميركا تغريه». هذه الإجابة، في جوهرها، إجابتهم جميعاً؛ جواب كل من حنا ميخائيل وإلياس شوفاني وجمال الزبدة والآخرين الذين تركوا الترف في أميركا وقرّروا أن يربطوا مصيرهم بمصير شعبهم.
العودة من الشمس وتحقيق التطابق النهائي
جمعة الطحلة، وُلد عام 1962 في الأردن، وهو أكبر تجمعات الفلسطينيين في خارج حدود فلسطين، وعايش أحداث «أيلول الأسود»، التي قاتل فيها ثلاثة من أخوال والده في صفوف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ومن تلك اللحظة بدأت القضية الفلسطينية تأسر وجدانه. اجتاح الكيان الصهيوني لبنان عندما كان شاباً بعمر الـ19، وقتها كان في الخدمة العسكرية الإلزامية والتحق بقوات جيش التحرير الفلسطيني، وكان له الحق كأردني من أصل فلسطيني أن يختار ما بين الخدمة في الجيش الأردني أو في جيش التحرير. شارك جيش التحرير في حرب الدفاع عن لبنان بالدفعة العسكرية التي سبقت الدفعة التي ينتمي إليها جمعة، وغضب بشدّة واقتحم مكتب المقدّم وهدّد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يتم إرساله إلى لبنان، ضحك المقدّم وقال: «طالعوا هالوحش طالعوه».
وفي لبنان، لم يلتزم، ومعه مجموعة من المتطوّعين الآخرين في صفوف جيش التحرير، بمواقع تمركز الجيش في الجبل والبقاع اللذيْن لم يشهدا مواجهات كما في جنوب بيروت التي هرعوا إليها للدفاع عنها وعن المقاومة الفلسطينية واللبنانية. شاركوا في معركة المتحف حيث كان المحور الأعنف في حصار بيروت ونجا من الموت بأعجوبة أكثر من مرة. صمدوا لثلاثة أشهر وهم يقاتلون حتى أُعلن عن اتفاقية الهدنة التي بموجبها خرجت قوات الثورة الفلسطينية من لبنان، فعاد ورفاقه إلى الأردن.
انتقل إلى عدة بلدان عربية وإسلامية ما بين عامي 1984 و2004 لكنه كان يرى أن أيّ عمل يقوم به في أيّ من هذه الدول يجب أن يكون من أجل مصلحة فلسطين في النهاية، فكان حريصاً كل الحرص على تطوير نفسه علمياً من خلال تعلّم الميكانيك والإلكترونيات وعلم الحاسوب للمساهمة في تطوير قدرات المقاومة من الناحية العسكرية والتقنية عندما يأتي وقت المساهمة المباشرة. وكان في الوقت نفسه على ارتباط مع حركة «حماس» في فترة غربته.
في عام 2004، انتقل الطحلة إلى سوريا للعمل ضمن جهاز التصنيع العسكري لـ«حماس» وكان له دور مهم جداً وفعّال في تطوير سلاح المُسيّرات والصواريخ لدى المقاومة. وبعد أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة عامي 2008 و2009 توجّه إلى مصر من أجل الذهاب إلى قطاع غزة لكنه اعتُقل وسُجن في مصر.
تحرّر من السجن مع اندلاع التظاهرات العارمة عام 2011 والتي عُرفت في ما بعد بثورة 25 يناير. تسلّل إلى قطاع غزة بطريقة هوليوودية، ونفّذ حق العودة بيديه، ولم ينتظر أن يمنّ عليه أحد بأبسط حقوقه وهي أن يكون في موطنه، بدون إذن من محتلّ. وفي القطاع، ساهم في تطوير السلاح النوعي لـ«القسام» وعمل على تأسيس وحدة السايبر في الكتائب وقد لعبت الوحدة دوراً مهماً في الاختراق الإلكتروني للاحتلال. استشهد في أول أيام معركة «سيف القدس» برفقة جمال الزبدة باستهداف صهيوني غادر.
الطحلة والزبدة قد أجابا محمود درويش في رثائه لغسان كفناني، حين طلب من الرجال في الشمس أن يترجّلوا ويعودوا من رحلتهم ليصبحوا فلسطينيين بحق كما كان كنفاني؛ فقد عادوا من إقامتهم في «الشمس» وحقّقوا التطابق النهائي بينهم وبين الوطن عندما تبعثرت أشلاؤهم وتكاملت، كما حدث مع غسان كنفاني قبل خمسين سنة.
لم يكن حنا ميخائيل، ولا إلياس شوفاني، ولا جمال الزبدة، ولا جمعة الطحلة، مُجبَرين على أن ينخرطوا في النضال الوطني الفلسطيني بما أنهم وجدوا أنفسهم غير مُستهدفين بشكل مباشر من قبل الكيان الصهيوني في اللحظات الحرجة التي واجهها الشعب الفلسطيني، بل كانوا أناساً عاديين وناجحين على المستوى الفردي لكنهم استيقظوا على مسؤوليتهم تجاه قضية شعبهم المنكوب وقرّروا دقّ جدران الخزان.
اليوم، وفي ظل حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة، يجب علينا نحن أيضاً أن نجيب على سؤال غسان كنفاني. وفي لحظة الإبادة الاستثنائية، على مستوى حجمها وإجرامها، أصبحت الإجابة على السؤال ضرورة وجودية أكثر من أيّ وقت مضى.
أختم المقال بمقولة للشهيد وليد دقة، فقد تُحفِّزنا على إيجاد أجوبتنا على السؤال:
«أنا لست مناضلاً مع سبق الإصرار والترصّد، بل أنا ببساطة كنت من الممكن أن أكمل حياتي كدهّان أو عامل محطة وقود كما فعلت حتى لحظة اعتقالي… وكان من الممكن أن أتزوج زواجاً مبكراً من إحدى قريباتي كما يفعل الكثيرون، وأن تنجب لي سبعة أو عشرة أطفال، وأن أشتري سيارة شحن، وأنْ أمتهن تجارة السيارات وأسعار العملات الصعبة… كل هذا كان ممكناً، إلى أن شاهدت ما شاهدت من فظائع حرب لبنان وما أعقبها من مذابح صبرا وشاتيلا التي خلقت في نفسي ذهولاً وصدمة».
* باحث فلسطيني