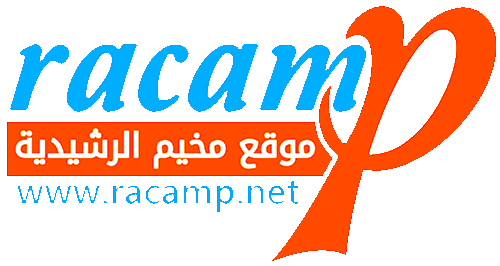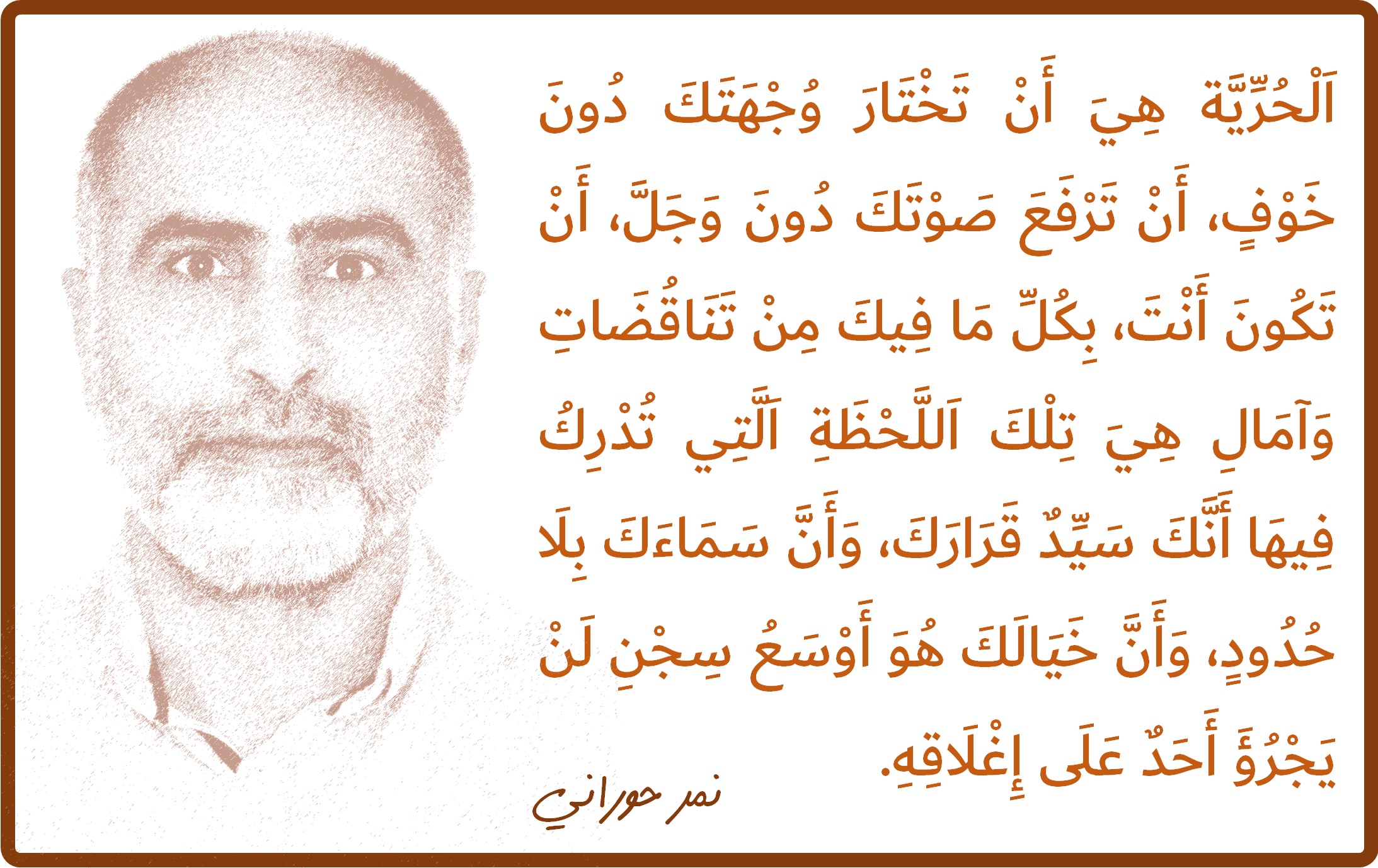في بيتٍ غزّي صغير يفيض دفئًا وإيمانًا، نشأ محمود وادي، كان طفلًا مميزًا منذ سنواته الأولى، يحمل فضولًا أكبر من عمره وموهبة تشقّ طريقها بثقة.
اشترى له والده – المصوّر وصاحب الاستوديو – جهاز كمبيوتر خاصًا به وهو في السادسة فقط، إيمانًا منه بأن الضوء الأول في حياة الفنان يبدأ من لحظة اكتشافه.
كبر محمود بين كاميرات والده، وبين بيئة تربوية تمزج العلم بالدين، والالتزام بالحب، والجدّ بالإنشاد.
لم يكن التصوير بالنسبة إليه مهنة… بل كان لغة يرى بها العالم، ويحتفظ بها لنفسه ولمن يحبّ، كما تقول شقيقته الدكتورة سمية لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام.

ومن بين كل تلك التفاصيل التي بنت شخصيته، بقيت الكاميرا الأقرب إلى قلبه، تلتقط ما يعجز اللسان عن قوله.
روح البيت… ورفيق العائلة
لم يكن محمود مجرد شاب موهوب؛ كان الظلّ الطيّب الذي يُسند الجميع، تقول شقيقته الدكتورة سمية إنه كان يسمع هموم أمه كصديق، ويعمل مع أبيه كشريك، ويقوّي إخواته بكلمة وحضور وبساطة.
كان يظهر في أصعب اللحظات كجبلٍ ثابت… يخفّف، يساند، ويصلح ما يجب إصلاحه، وفي أوقات النزوح المتكرر، كان هو اليد التي تُمسك بالعائلة، توفر لهم المأوى والحاجات الأساسية، وتسبقهم إلى الطريق ليضمن سلامتهم.
ومع كل قصة تُروى عنه بعد رحيله، تتضح صورة شابٍ لم يكن يعيش لنفسه بقدر ما كان يعيش للآخرين.
عشقه للكاميرا… وحكاية الدرون التي سبقت زمنها
في عام 2011، وفي ذروة الحصار، استطاع محمود أن يجلب أوّل كاميرا درون إلى غزة، بعد أن دخلت قِطعًا مفكّكة على يد أصدقاء.
ثم تعلّم استخدامها على يد الشهيد مصطفى ثريا، وأحبّها كما لو أنها جزء من روحه.
بها أصبح يرى غزة من الأعلى، لا كأرضٍ محاصرة، بل كلوحة تستحق الحياة، استخدمها لإسعاد الناس، لتوثيق أفراحهم، لتخليد لحظاتهم الجميلة. ثم جاءت الحرب، فأصبحت الكاميرا شاهدًا على ما تغيّر… وما فُقد، وفق سمية التي تواصل حديثها لمراسلنا.
كان يرسم عبرها مقارنة بين المشهد قبل الحرب وبعدها، يصنع فيديوهات تُعيد للناس ذاكرة المكان، وتُذكّرهم بأن الخراب لا يمحو الحياة تمامًا.
طموح لا يعرف السقف
كان حلمه كبيرًا وبديعًا… أراد أن يبني شركة تصوير رائدة، وأن يصنع مدرسة فنية خاصة به، افتتح شاليه تصوير وطوّر استوديو والده، وجمع فريقًا يثق بقدراته.
لكن الحرب دمّرت بيته والاستوديو الخاص به مرتين. ومع ذلك بقي متماسكًا، يجمع ما تبقى من أمله ليواصل عمله. كان يؤمن أن الصورة يمكن أن تُعيد للناس بعضًا من الحق والحياة.
الأخ والصديق… حكايات تبقى حيّة
تقول شقيقته سمية: “محمود كان يكبرني بعام، لكنه كان سابقًا بسنوات من الحكمة. كان ملجئي في التفاصيل الصغيرة، وفي القرارات الكبيرة. في أصعب أيام الحرب، لم يتركني أحتاج شيئًا… كان يقاسمني كل شيء”.
وتتذكر موقفًا لا ينسى: حين نزح والداها عندها وكانت تملك لوح طاقة صغيرًا، أحضر محمود سيارة كاملة لنقل اللوح، ثم استبدله بآخر أكبر حتى يضمن راحة الأسرة. هكذا كان… يفكر بالآخرين قبل نفسه، ويصنع للناس حياة أوسع مما يملك.
اليوم الأخير… يوم يظلّ معلقًا في الذاكرة
كان صباحًا يشبه أي يوم، هادئًا على غير عادة الحرب، خرج محمود بملابسه المرتبة وكأنه ذاهب إلى بداية جديدة. سلّم على العائلة فردًا فردًا، جلس مع أصدقائه، ومرّ على أخته في خانيونس.
لم يكن أحد يعلم أن تلك التفاصيل العادية ستتحوّل لاحقًا إلى إشارات وداعٍ هادئة.
ما تبقى من الضوء…
تقول سمية: “محمود كان يحب الحياة، ويحبنا جميعًا، ويحب ابنه الصغير الذي كان يحملُه طويلًا ويحدّق فيه بحنان لا ينتهي”.
كان الطفل يرافقه في الأيام الأخيرة، وكأنهما يحاولان اختصار العمر في لحظات صغيرة.
وبعد رحيله، ظلّ صغيره يسأل بدموع مؤلمة: “امسحوا الدم عن بابا… خلّوه يصحى”، أسئلة طفولة لا تعرف معنى الفقد، ولا تستطيع فهم كيف يخرج أبٌ بهذا القدر من الضوء… ثم لا يعود.
رحل محمود وادي في السادس من ديسمبر، عن 34 عامًا، لكن سيرته لم ترحل، بقيت في الكاميرات التي أحبها، وفي الصور التي التقطها، وفي قلوب من عرفوه، بقيت في كل موقف صغير كشف عن رجلٍ عطوف، شجاع، بسيط، ثابت… ومليء بالإنسان.