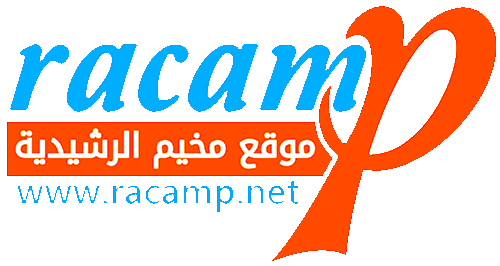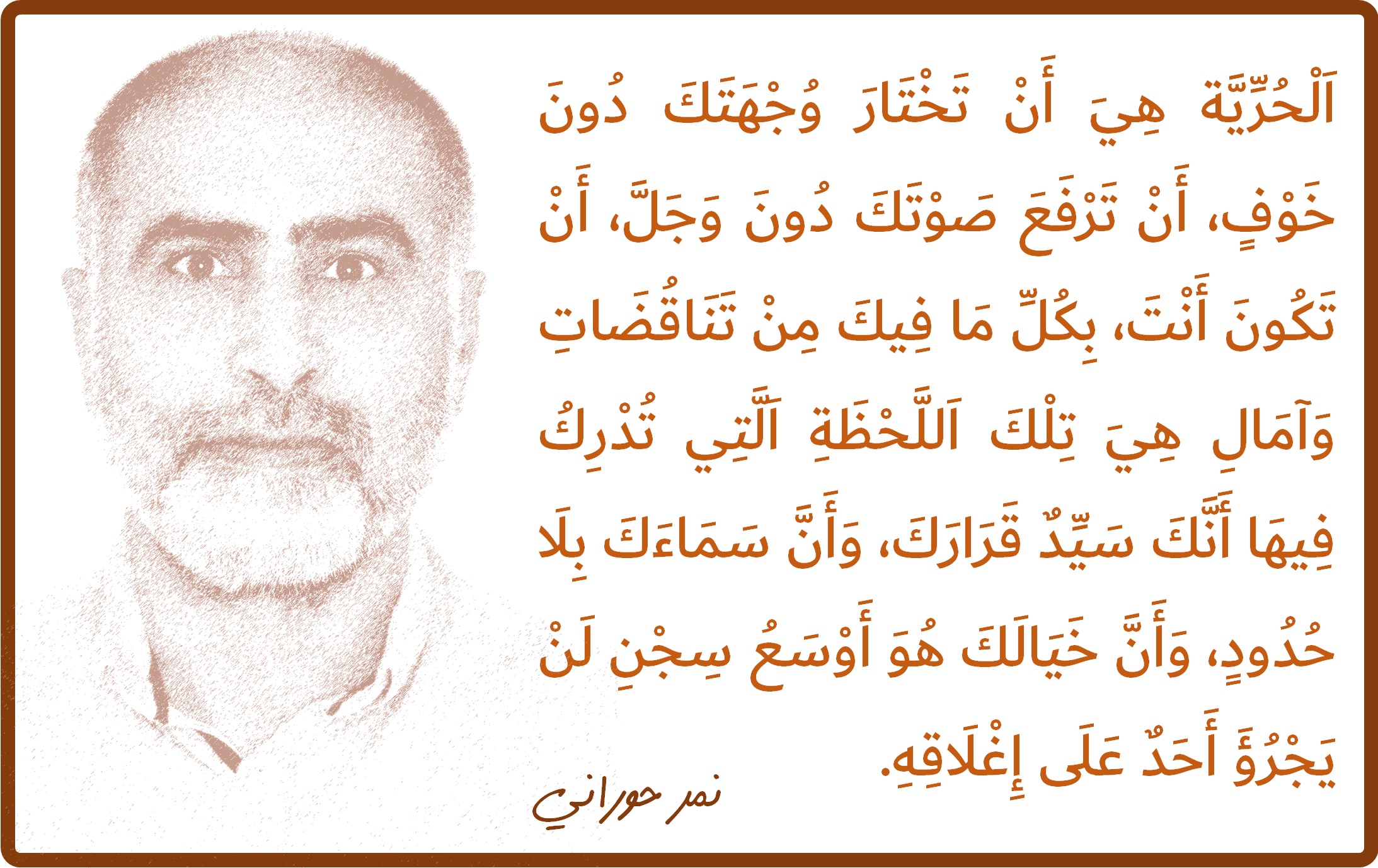ليلى الشايب
إعلامية تونسية
اعتاد الناس مع اقتراب نهاية كل عام (عن قناعة ووعي أو من دونهما) على استعجال النهاية وإغلاق آخر أيامها، ودخول عام جديد أملاً في أن يأخذ العام الذي يمضي معه ما رافقه من أزمات ومشكلات وعثرات، خاصّة وعامّة، وأن يحمل الجديد حلولاً وعلاجات، ويفتح ما أُغلق من أبواب وآفاق. والمستجدّ في هذا المزاج، وهذا التطلّع الإنساني المشترك، أن السنوات الماضية أحدثت فيهما تغييراً كبيراً لافتاً، فأصبحت توقّعات الناس تتجاوز الشأن الشخصي والأحلام والطموحات الفردية إلى الشأن الأشمل على مستوى الدول والعالم، ولسان حالهم يقول سرّاً وعلناً: يا تُرى، هل سنرتاح قليلاً في العام الجديد؟ هل سيأتي الخلاص؟ ولو كان عام 2026 رجلاً، لقرّر عدم المجيء تحت وابل التوقّعات والآمال التي وُضعت على كاهله وهو لم يهلّ بعد.
اليوم، لا تكاد منطقة في العالم تخلو من أزمات تتفاوت في خطورتها وتشابك خيوطها وقابليتها للانفراج، وقدرة أهلها على تحمّلها، أو المشاركة في تفكيكها أو تحجيم آثارها. وحديثاً انضمّت أميركا اللاتينية إلى نادي المأزومين بعدما وضعها الرئيس ترامب في مرمى سهامه، واختار منها فنزويلا صيداً سميناً ليبدأ به. وتبقى منطقة الشرق الأوسط بؤرة العواصف الثابتة التي حولها (تقريباً) تدور معظم الأزمات وترتبط بها، بغضّ النظر عن العامل الجغرافي، فجزء من مشكلات أوروبا يرتبط بالشرق الأوسط، وتحديداً بعلاقاتها مع إسرائيل وموقفها من الحرب على غزّة، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تحوّلت حرباً روسية أوروبية تستنزف قدرات القارّة العجوز التي ترسل السلاح ووسائل الدعم الأخرى إلى إسرائيل بلا هوادة، من دون التطرّق إلى الحرب السودانية التي تتخفّى فيها أطراف وراء المتحاربين المباشرين الظاهرين، ونذر الحرب الأميركية على كاراكاس بذريعة عجيبة، جديد ما صدر منها: الدعم الذي تقدّمه حكومة نيكولاس مادورو لإيران وحزب الله بالمال المغسول من المخدّرات والسلاح، حسب مصادر استخباراتية أميركية إسرائيلية (!)، ومن دون التطرّق أيضاً إلى الحروب (الثمانية) الأخرى التي أنهاها الرئيس الأميركي بعصاً سحرية، وتتوزّع بين قارّتي آسيا وأفريقيا.
في هذا الجرد محاولة لاستقراء خريطة الأزمات التي عصفت بالعالم واشتدّت وطأتها في عام 2025، وقابلية كل منها للانفراج أو لمزيد من التدهور، بناءً على مؤشّرات اللحظة الراهنة.
لم يعد الشرق الأوسط “إقليماً مأزوماً” ضمن خريطة العالم؛ بل صار مركزَ جذبٍ للأزمات العابرة للقارات
غزّة، الجرح الغائر الذي لا يزال ينزف، لكن بعد سكب ماء شديد البرودة على حرارة المشاعر العالمية التي صعّدت مأساة القطاع (سيحفظها التاريخ) إلى أعلى سقوف التضامن الإنساني الكوني، ونُسفت بها أدبيات الغرب عن الحقّ والعدل والقانون، باحتفالية “سلام”، ونهاية افتراضية لحرب وحشية. فغلب البهرج على قوة التزام ما وُقِّع عليه، وكأنّ الهدف من ذلك التجمّع كان التجمّع في حدّ ذاته: الأضواء والكلمات الكبيرة… ليؤول الأمر إلى ما يشاهده اليوم العالم ذاته المحتفي: استمرار القتل بأدواتٍ جديدة ونسق مختلف، وبمشاركة الطبيعة في شتاءٍ لا يرحم، مع دخول عنصر “سياسي” جديد يرافق أخبار موت من بقوا من الغزّيين: المرحلة الأولى من الاتفاق، والخطوط الحمراء والصفراء في القطاع المنكوب، وتشكيلة القوة الدولية التي ستحلّ في غزّة، و”تركيبة” مجلس السلام العالمي، والطُّعم الموعود به الرئيس الأميركي الذي لم يتحقّق له بعد، لأن شروطاً أخرى ما زالت موضوعة على لائحة الوصول والحصول على “غزّة الجديدة”.
لا يؤشّر هذا المشهد المُشوَّش عمداً (لا استمرارية فيه إلا لقتل أعداد جديدة من الصامدين في القطاع، قد تزيد أو تنقص) إلى أيٍّ من أشكال الانفراج، بل إلى أجندة خفيّة سيعمل أصحابها على تنفيذها بتوقيت وأساليب مُبتكَرة تستفيد أساساً من الإنهاك وتشتيت الانتباه إلى أزماتٍ أخرى. وفيه قدر كبير من الابتزاز لأطراف عديدة في المنطقة وخارجها. وهو وضع يؤدّي بالضرورة إلى مزيد من الحرائق المقبلة، ومنها ما هو في طور الاشتعال، على غرار اعتراف بنيامين نتنياهو بما تسمّى جمهورية أرض الصومال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويض لاستقرار منطقة القرن الأفريقي شديدة الأهمية والحساسية. وكذلك التحرّش بمصر في كل فرصة مواتية، رغم ظاهر العلاقة البراغماتية، بل والاستكثار على القاهرة اتخاذ ما تراه مناسباً من ترتيباتٍ ضرورية لأمنها وأمن شعبها وأرضها، على أرضها، بتعلّة الشكوك والمخاوف التي تختلق منها إسرائيل ما يعجز الخيال البشري السليم عن ابتداعه؛ بل جعلت منها قاعدة للفكر السياسي والفعل الأمني والعسكري “المُبتكَر”، يبيح لها (باطلاً) الاستباق بالإيذاء، قبل أن يلحقها أيُّ أذى، حتى لو كان وهماً، وهي تدرك ذلك تمام الإدراك.
لبنان، ورأس حزب الله المطلوب على طبق يُقدَّم إلى إسرائيل بأيدي جيشه وحكومته، هو الفصل الجديد الذي فُتح في الأشهر الأخيرة من عام 2025 في معركة طويلة لم يشبع فيها مقتل قادة الحزب، ورأس حربته الأقوى والألمع على الإطلاق، نَهَم قادة الكيان الذين يريدون كل شيء، وليس أقلّ. وبين الزيارات المكوكية الضاغطة لمبعوثَي ترامب إلى بيروت، توم برّاك ومورغان أورتاغوس، والمهل المتكرّرة للجيش لنزع سلاح الحزب، في لعبة بالغة الخطورة على السلم الأهلي في البلاد، وبين اغتيالات بالمُسيَّرات لمزيد من عناصر الحزب في أيّ بقعة من الأراضي اللبنانية حتى أصبحت خبراً مألوفاً، وبين إغراءات بـ”الازدهار” وعودة الاستثمار مقابل إدخال حزب الله بيت الطاعة، يعيش لبنان المنهك على جميع الصعد على إيقاع وعيد بالعودة إلى حرب ستكون ساحقة ماحقة هذه المرّة، إذا لم تُنفَّذ شروط استبعادها. ومع تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام أن لبنان اختار أخيراً إجراء مفاوضات مع إسرائيل لتجنّب جولة أخرى من العنف (مرغمين، بلا سلام أو تطبيع كما يُروَّج رسمياً)، يجدّد حزب الله التذكير بالخطوط الحمراء. ويذهب العارفون بالشأن اللبناني المُعقَّد إلى قراءة موقف بيروت المُستجدّ شراءً للوقت اتقاءً لسيف المُهل المسلّط على الجميع. أمّا إسرائيل التي تملي وتراقب، فتجد ثغرة جديدة قديمة وسط هذا المشهد المتغيّر، لتتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله، ما يفتح صفحة أخرى في العلاقة بين بيروت وتل أبيب، سِمتها الأساسية فارق مخيف في ميزان القوة، وفائضها لصالح الثانية (ولو ظاهرياً)، وبداية طريق طويلة ومضنية من محاولات التطويع بكل أساليب إسرائيل المعهودة، ستصطدم حتماً بمن لن يصبر عليها، في وضع قابل للانفجار في كل ثانية.
لا يختلف الحال في سورية عن لبنان إلا في تعدّد الأطراف المنخرطة في دوامة العنف المتجدّدة كل بضعة أيام، في تزامن غير مفهوم مع انفراجات كبيرة على المستويين، الاقتصادي والسياسي، أبرزها إلغاء قانون قيصر العقابي الذي أعاد الاقتصاد السوري، وحياة السوريين، عقوداً إلى الوراء، وتوقيع اتفاقات وشراكات إقليمية ودولية مهمّة في قطاعات حيوية كالكهرباء. ولذلك يتواتر السؤال الكبير عن هذا التناقض في مسار التعافي السوري، وعن الطرف أو الأطراف المستفيدة من استمرار التعثّر والاقتتال وعدم الاستقرار، لتكون إسرائيل الجواب الذي لا يحتاج طول تفكير. نعم، تعتقد إسرائيل أنها تمتلك أثمن وأندر فرصة في تاريخها المشبوه للتحكّم في صياغة المشهد في سورية التي لطالما سبّبت لها جغرافيتها الكوابيس وحرّكت أطماعها في آن، لذلك لن تتركها تفلت وهي تخطو خطواتها الأولى في مسارها الجديد، فلا تكتفي بتحريك الداخل ضدّ الداخل، بل إنها تنظر إلى سورية الجديدة أداة محتملة (عند الضرورة) لإحداث فوضى مع لبنان، وسيكون حرص الدولة اللبنانية على تجنّب هذا السيناريو أقرب إلى سباقٍ ضدّ الساعة وضدّ الآجال التي تُوضع أمامها.
ترسم حركة النزوح الهائلة في السودان الحدود الجديدة بفعل الأمر الواقع، ولن يكون في الأشهر المقبلة متّسع لمصالحات أو نهاية للحرب بالجغرافيا نفسها التي بدأت فيها
السودان: لا يمكن في زحمة الجبهات المفتوحة هذه، الحديث عن مشهدية الحرب الضارية في السودان بتفاؤل من يرى فيها حرباً أقلّ أهمية من مواجهات إسرائيل المتعدّدة مع الجوار، إذ تبدو وتيرة هذه الحرب بالذات، واشتدادها في الأشهر القليلة الماضية، رافداً آخر يصبّ (أو هكذا يُراد له) في نهر هادر تندفع فيه تيارات التقسيم والتفتيت. وقد بدأت ملامحه تتشكّل في ما بقي من السودان الحالي، والأرجح أن حركة النزوح الهائلة ترسم الحدود الجديدة بفعل الأمر الواقع، ولن يكون في الأشهر المقبلة متّسع لمصالحات أو نهاية للحرب بالجغرافيا نفسها التي بدأت فيها.
جنوب اليمن و”أرض الصومال” يلتحقان بالركب في غفلة مريبة، وفي اللحظات الأخيرة من عام 2025 العاصف، حتى تكتمل صورة تقريبية للمنطقة، كما رسمها أرباب مشروع الشرق الأوسط الجديد، بعناوين “الانفصال” الصادمة، على أن يُتداول في التفاصيل في مرحلة لاحقة بعد امتصاص الصدمة. ويكفي الانتباه إلى أن إسرائيل أول من أعلن الاعتراف بما سمّته “جمهورية أرض الصومال” في الدفعة الجديدة من المعترفين لفهم ما يجري. أمّا جنوب اليمن أو “دولة الجنوب العربي”، فدون إعلان انفصالها الفعلي عقبات كبيرة من اليمنيين أنفسهم ومجلس القيادة الرئاسي في رأسهم، رغم ما يُشاع ويُكرَّر عن انفصاله الفعلي منذ 2017 بهدف فرض أمر واقع والقبول به. وبين فرض الانفصال (حتى لو افتراضياً) وبين ردّات الفعل الشديدة ضدّه في اليمن والصومال الرسميين، لا تنتهي القصّة ولا تُطوى صفحة وتُفتح أخرى عنوة، بقدر ما يُفتح فصل صراع جديد آتٍ.
تسابق إسرائيل ويمينها المتطرّف، ومعاولها هنا وهناك، الزمن لتحويل مقولة “إسرائيل الكبرى” واقعاً مرئياً وملموساً، بعدما جعل رئيس حكومتها من شعار “نحن نغيّر الشرق الأوسط” درعاً ومفخرة يردّ بها على الخصوم، ويتوعّد بها من يدعو إلى لجم دولته ومعاقبتها وعزلها بعد مقتلة غزّة المستمرّة. ويتحرّك وفق آجال ومواعيد ونبوءات يتداولها مع عتاة المتطرّفين من دائرته، وبخطاب ديني مثير للجدل، وهو يُسرع الخطى نحوها في نهايات هذا العام العاصف.
وإذا ما ابتعدنا قليلاً من منطقة الشرق الأوسط، تلوح الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تدنو من عامها الرابع، وتدخل مع قدوم الرئيس ترامب مرحلة كان يُفترض أن تكون انفراجة، بحكم موقفه المعروف من هذه الحرب من الأساس، ومن دور إدارة سلفه في اندلاعها، ودعم الطرف الأوكراني فيها بكل ما تتطلّبه مواجهة ضدّ قوة نووية مثل روسيا. إلا أن تباين حسابات الأطراف المنخرطة فيها وعامل الجغرافية خفّضا كثيراً منسوب الأمل في إنهائها؛ فالأوروبيون، المتصادمون مع ترامب في التجارة والاقتصاد والسياسة، مختلفون معه في هذه الحرب أيضاً، وبشكل جذري يكاد يبلغ مرحلة القطيعة العابرة للأطلسي. وفي نهاية 2025، وبعد جولات من التفاوض العسير، تحرّكت مياه راكدة وجليد قاسٍ، لكن لا تُسمع بعد عبارة “اختراق” لاقترانها بتنازلات مطلوبة من خصوم شديدي العداء والعناد، ولأن هذه الحرب تحديداً يرسم الرابحون فيها معالم توازنات دولية جديدة، ولا يبدو أنهم سيتخلّون عن هذا “المكسب العظيم” بعد “تضحيات” جسيمة.
ترامب، “صانع السلام” ومطفئ الحروب العشر، اختار (أمام دهشة العالم) أن يكون مشعلها في أماكن أخرى. في نيجيريا الشاسعة، ذات التعداد السكّاني الكبير والثرية باحتياطات نفط ضخمة، بذريعة تعرّض المسيحيين فيها للاضطهاد. ولم يفعلها بعد، وكأنّه قام بعملية حسابية للمسافات والتكلفة العسكرية والسياسية والبشرية، ففضّل هدفاً آخر مشابهاً لنيجيريا، لكنّه أقرب وبذرائع أكثر قابلية للهضم، ولم تُهضم: فنزويلا اليوم في عين العاصفة، محاصرة بقوات البحر والجو، يُختطف نفطها بأسلوب القراصنة، وهو لا يزال محمّلاً في سفن الشحن في البحر الكاريبي، وتُؤخذ طواقمها إلى وجهات غير معروفة، ويُطلب من رئيسها بعبارات صريحة ترك السلطة ومغادرة البلاد، ويبلغه ترامب مهلة تلو الأخرى للاستسلام، في شكل جديد من الحروب المبتكرة تماماً.
ومن دون أن يخفى عن عين المراقب الملمّ بالحيثيات الأهم، أن ترامب نفسه واقع تحت ضغط وابتزاز شديدين لأخذ فنزويلا في اتجاه محدّد. وإن لم تُعلن “اللحظة صفر” بعد، فلأن فترة الأعياد أجّلتها، وبعدها ستكون كل الاحتمالات واردة بقوة مع حلول السنة الجديدة التي تشرئب لها الأعناق تطلّعاً وخشية.
في سورية انفراجات اقتصادية كبرى، وعنفٌ متجدّد يطرح سؤال المستفيد من تعطيل التعافي
ترافقت هجمة ترامب على فنزويلا مع هجمة شرسة على المهاجرين، كل المهاجرين، من كل الأعراق والقارّات والثقافات والأديان، فيما أطلق عليها اسم حملة “تنظيف أميركا” ممَّن يعتبرهم ترامب عبئاً وخطراً، وبصفات أخرى فيها قدر كبير من البذاءة، ربطها ببلدان “وسخة ومتخلّفة… ومصدر لقمامة غير مرغوب فيها”. وتوّج ذلك بوضع لائحة بأسماء الدول التي سيُمنع القادمون منها من دخول “الجنّة الأميركية” الموعودة. وامتدّت الحملة ضدّ المهاجرين إلى أوروبا، ولكن بأسلوب أكثر تحفّظاً وتكتّماً ومراعاة للكرامة الإنسانية في حدودها الدنيا، عجّلت بها الأوضاع الاقتصادية المتأزّمة في أهم بلدان القارة العجوز، والأوضاع الأمنية حسب الخطاب الرسمي لجلّ حكوماتها، ولدواعٍ انتخابية يتجنّب الخوض فيها علناً. وقد كان الحراك الشعبي والمجتمعي العظيم الذي هزّ أركان أوروبا خلال عامَيْن من حرب غزّة، هو القطرة التي أفاضت كأس الهجرة التي لم تتوقّف أبداً عن الغليان. ويتساءل المهاجرون: إلى أين يعودون بعد أن أصبحت جلّ بلدانهم غير صالحة لحياة كريمة، وضاقت بمن بقي فيها من الأساس ورضي أن يكابد صراع المعيشة والبقاء؟ فيما تتساءل سلطات بلدانهم الأصلية (سرّاً) كيف ستستوعبهم، وكيف ستجابه الأزمات الإضافية التي ستظهر سريعاً مع عودتهم؟
في خطاب بمناسبة أعياد الميلاد، وفي تهنئة بالعام الجديد، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية للإيطاليين: “لقد قاتلنا معاً طوال عام 2025 الذي كان عاماً صعباً علينا جميعاً… لكن لا تقلقوا، العام المقبل (2026) سيكون أسوأ بكثير… لذلك أنصحكم بأن تنالوا قسطاً كافياً من الراحة خلال هذه الإجازة حتى نستعدّ جيّداً”، وهي رسالة صالحة للنسخ والتعميم على العالم، ولا تقف عند الإيطاليين فقط. ولا شكّ أن جورجيا ميلوني قصدت هذا تحديداً.