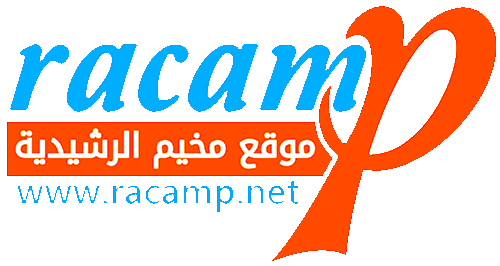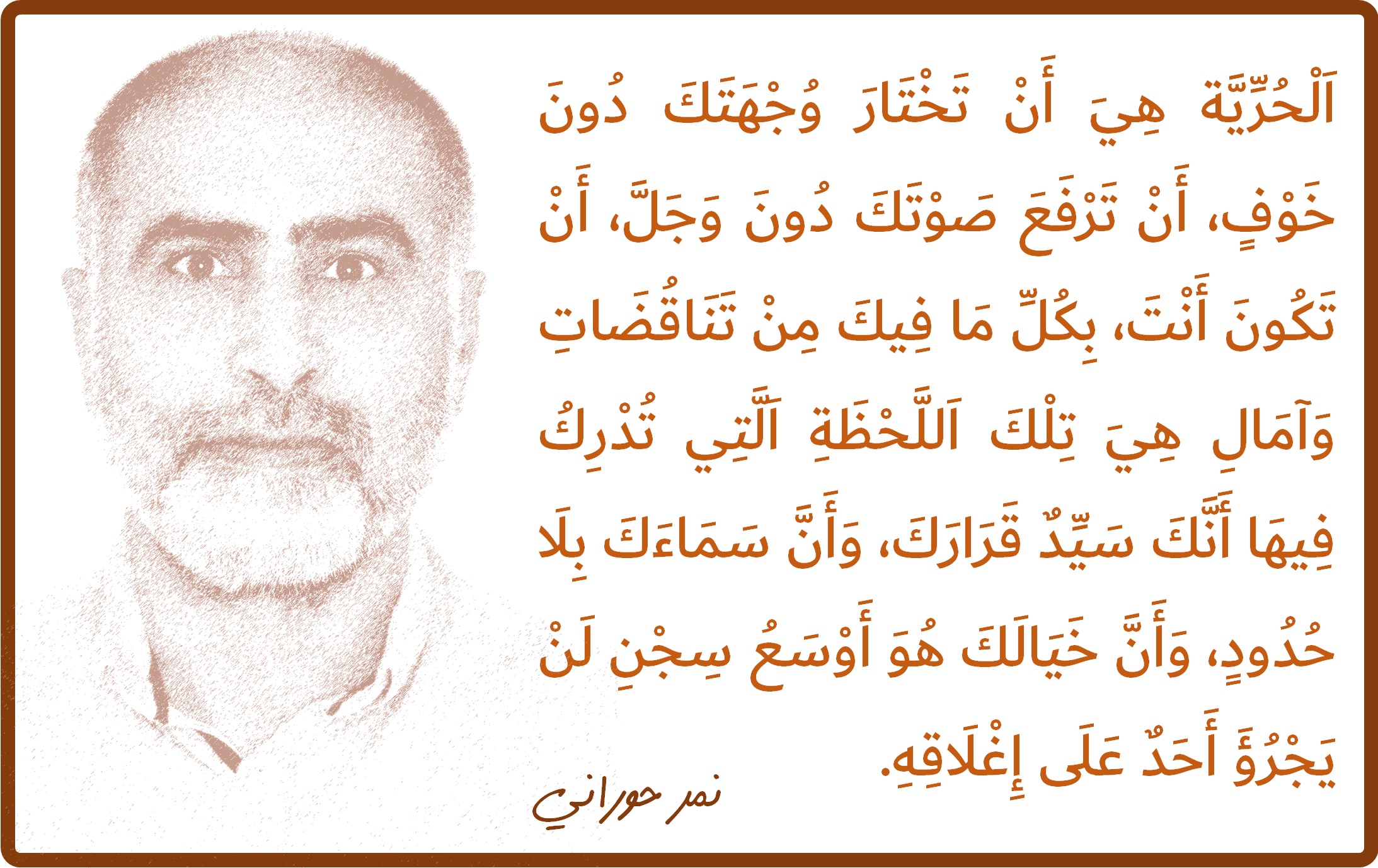بقلم: عصام الحلبي
لا تكاد المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان تخلو من لافتات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حتى بات عددها يفوق المنطق والحاجة، في مشهد يوحي ظاهريًا بحيوية المجتمع المدني، لكنه يخفي في جوهره أزمة حقيقية في الفعالية والمسائلة، فلو قيس عدد اللاجئين الفلسطينيين بعدد هذه الجمعيات، لبدت الصورة عبثية. عشرات المؤسسات مقابل خدمات لا ترقى إلى الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، وشكاوى يومية لا تجد آذانًا صاغية.
تتضاعف خطورة هذا الواقع في ظل التدني غير المسبوق في خدمات وكالة الأونروا وتقديماتها، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيسها، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإغاثة الاجتماعية. ومع انكفاء الدور الأساسي للأونروا، كان يُفترض أن تشكل الجمعيات الأهلية شبكة أمان بديلة أو مساندة، إلا أن الواقع كشف عكس ذلك، حيث اتسعت الفجوة بين حجم التمويل المعلن وحجم الأثر الفعلي على حياة اللاجئين.
السؤال الذي يفرض نفسه بحدة، لماذا هذا التقصير المزمن؟ هل هو فشل إداري؟ أم سوء تخطيط؟ أم فساد مالي وإداري مقنّع؟ أم أن منطق المحسوبيات والاستنسابية بات هو القاعدة في توزيع المساعدات؟ الأكيد أن جزءًا من الأزمة يعود إلى غياب أي معايير واضحة، وافتقار الجمعيات إلى قواعد بيانات موحدة، ما يسمح بتكرار الأسماء نفسها على لوائح المستفيدين، فيما تُترك عائلات أكثر فقرًا وعوزًا خارج دائرة الاهتمام.
ولا يمكن تجاهل ممارسات باتت شائعة، حيث تُربط المساعدات بشروط غير معلنة، كالحضور القسري لنشاطات أو محاضرات أو فعاليات ذات طابع ديني أو اجتماعي أو سياسي، في انتهاك صارخ لمعنى العمل الإنساني، الذي يفترض أن يقوم على الكرامة والحياد، لا على الابتزاز المعنوي وبناء الولاءات.
الأخطر من ذلك، أن بعض القائمين على هذه الجمعيات تجاوزوا دورهم الإغاثي أو الاجتماعي، وسعوا إلى تحويل مؤسساتهم إلى منصات نفوذ شخصي، أو أدوات لبناء “زعامات محلية” موازية، تُصرف في سبيلها أموال الجمعيات على مظاهر بذخ لا علاقة لها بحاجات اللاجئين، من تنقلات وسفرات ورواتب وامتيازات وسيارات وبعضها عقارات، في وقت تغرق فيه المخيمات في الفقر والبطالة وانعدام الأفق.
ولا يحتاج هذا الواقع إلى كثير من التدقيق، فالمشهد مكشوف لأبناء المخيمات، الذين يرون بأعينهم الفجوة الصارخة بين نمط حياة بعض إدارات الجمعيات، وبين الواقع القاسي للعائلات التي يُفترض أن تكون في صلب اهتمامها. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا، من يراقب هذه الجمعيات؟ من يقيّم أداءها؟ من يحاسبها على مصادر تمويلها، وآليات صرفها، ومدى التزامها بثقافتنا الوطنية والاجتماعية، وبحقوق اللاجئ الفلسطيني الأساسية؟
إن استمرار هذا الخلل، في ظل انهيار اقتصادي خانق وتراجع دور الأونروا، لا يهدد فقط الأمن الاجتماعي داخل المخيمات، بل ينسف الثقة بأي عمل جماعي أو أهلي. فاللاجئ الفلسطيني ليس مادة إحصائية في تقارير المانحين، ولا وسيلة لفتح صنابير التمويل، بل إنسان له كرامة وحقوق، ويستحق خدمة حقيقية لا موسمية ولا مشروطة.
من هنا، فإن الحاجة ليست إلى مزيد من الجمعيات، بل إلى غربلة جدية، ورقابة شفافة، وتنسيق إلزامي، ومعايير واضحة لتحديد العائلات الأكثر حاجة، والوقوف إلى جانبها فعلًا لا قولًا. فالجمعيات التي تفشل في أداء هذا الدور، ولا سيما الإغاثية منها، تفقد تلقائيًا مبرر وجودها، وتتحول من جزء من الحل إلى عبء إضافي على مجتمع أنهكته الأزمات.