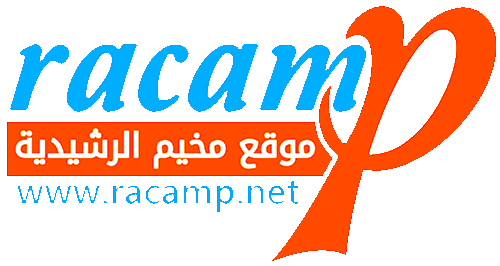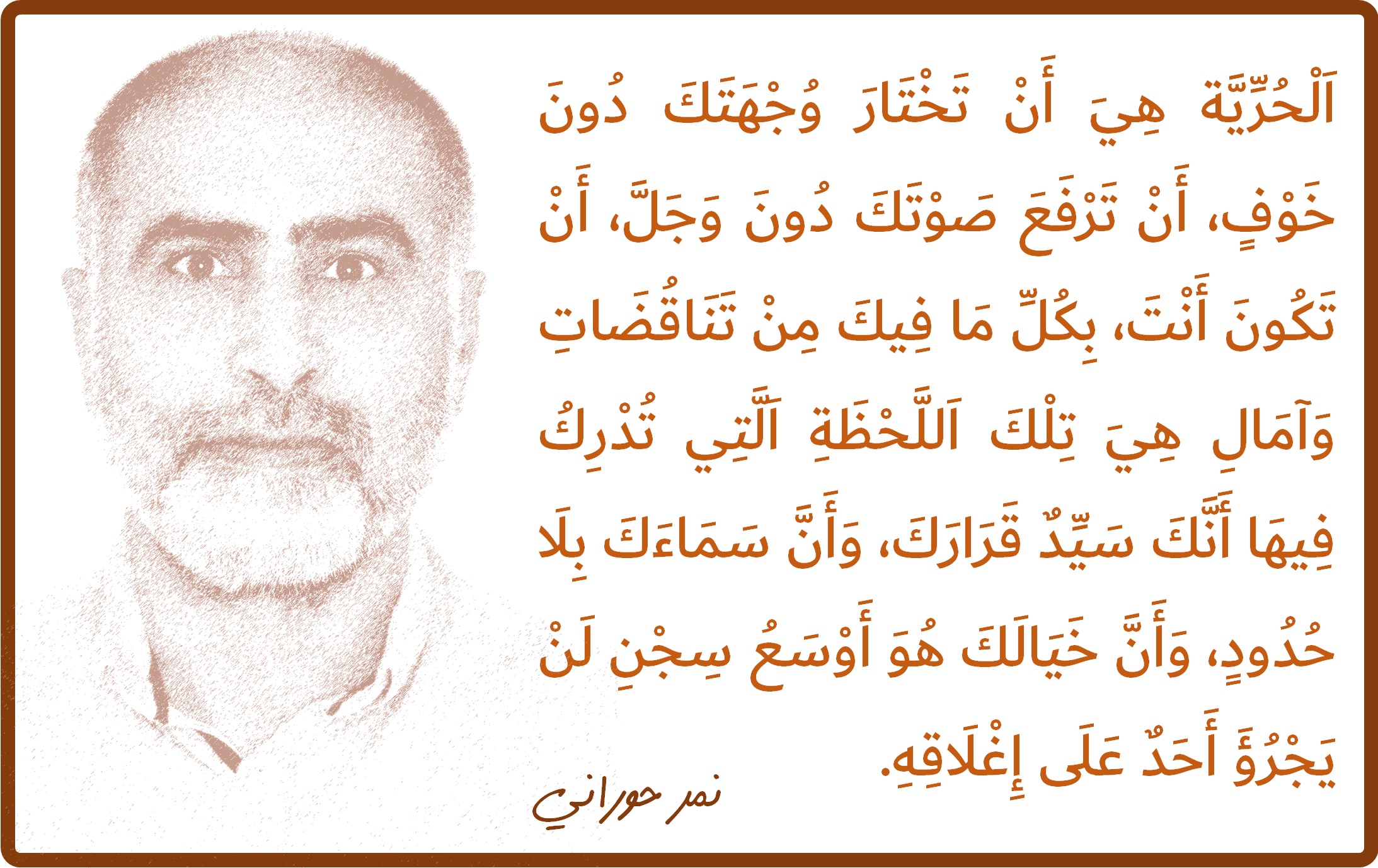حسين قاسم
ما قبل «الطوفان» ليس كما بعده. وأوّل ما ينطبق هذا، على القيادة الفلسطينية. إذ لا يمكن للحريصين على المصالح الوطنية الفلسطينية، أن يقبلوا، وبعد كل ما حصل، باستمرار النمط القيادي الحالي. فمن أوليّات المرحلة العمل على تشكيل قيادة من نمطٍ جديد تستجيب للدروس المستفادة من الماضي ومن «الطوفان». فالقيادة هي التي تقوم بالتخطيط ووضع البرامج والأهداف وتشرفُ على تنفيذها. وهي التي تمكّننا من النجاح، وهي التي يمكن أن تجرّنا نحو الفشل، وهي التي يمكن أن تخرجنا من الأزمات. لكن، قبل الخوض في الموضوع لا بدّ من التدقيق في مصطلح القيادة.
يتكرّر في الأدبيات الفلسطينية مصطلح «القيادة المتنفِّذة»، ويُقصد به قادة «فتح» بزعامة عرفات، ومن ثمّ عبّاس، المهيمنين على القرار الفلسطيني في منظمة التحرير والسلطة. وهذا خطأٌ شائع، إذ يوجد فرق بين مفهومَيْ القيادة والقائد (أو القادة). والفرق بين المفهومين كالفرق بين قائد السيّارة وقيادتها. إذ إنّ القيادة هي الطريقة والأسلوب والوسائل والأسس التي يلجأ إليها القائد (الهيئة القيادية) لممارسة مهامّه في قمة هرم الدولة، الحزب، والمؤسسة. والقيادة لا تُختَصر بالقائد، لأنها تشمل، إلى جانب ذلك، كل العلاقات التي يُقيمها وسير العمل (سيرورة) الذي ينتهجُه.
ومن أجل القيام بتقويمٍ موضوعي وسليم، سوف أعتمد التعريف الأكاديمي التالي: «القيادة هي السيرورة التي بواسطتها يقوم شخصٌ بالتأثير في مجموعة من الأشخاص لتحقيق هدف مشترك» (بيتر نورثْوَسْت، «القيادة: النظرية والممارسة»).
والشخص هنا، هو القائد، ويمكن أن يستبدل بالهيئة القيادية إذا كانت القيادة جماعية. أمّا مجموعة الأشخاص، فهم أعضاء المؤسسة التي يرأسها القائد، وكذلك المناصرون والبيئة الاجتماعية الحاضنة. ومهمّة القائد هي أن يقوم بالدور الأبرز، ضمن الهيئة القيادية، في تحديد الأهداف ورسم الاستراتيجيّات والبرامج المرحلية والإشراف على التخطيط والتمكين والتنفيذ والتقويم والقيام بكل ما يلزم لتحقيق الأهداف التي من أجلها تشكّل الإطار السياسي الذي يقوده، ومن أجلها انضمّ الأعضاء إليه.
لذلك، يجب أن تكون الأهداف الاستراتيجية والمرحلية واضحة وضوحاً لا لبس فيه للجميع بمن فيهم العناصر غير القيادية. وعموماً، العلاقة بين القائد وباقي الأعضاء تفاعلية، وتسير في الاتجاهين، بين القمّة والقاعدة، خدمةً للأهداف والمبادئ والقيم المشتركة، وحرصاً على أفضل استثمارٍ للطاقات والموارد المتوفّرة. وفي نهاية الأمر المعيار الأساسي لنجاح القائد أو فشله هو مدى إنجاز البرامج والأهداف المرسومة مسبقاً.
انطلقت منظّمة التحرير وفصائل الثورة المكوّنة لها، وكان هدفها تحرير فلسطين. وعلى إثر حرب 6 أكتوبر 1973 انتقلت القيادة إلى هدف «إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلّة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتمّ تحريرها»، وسرعان ما حوّلته إلى «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة» في الضفة والقطاع، وفي 1986 انتقلت إلى هدف الكونفدرالية مع الأردن، وفي سنة 1988 أصدرت إعلان استقلال فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينة في حدود الرابع من حزيران 1967، ثمّ قامت، تلبية لشروط واشنطن، بإعلان قبولها بقراري الأمم المتحدة 242 و338، والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود ونبذها للإرهاب.
لقد اختارت القيادة هذا المسار لتكون مقبولة على طاولة المفاوضات في مدريد، وبعد ذلك في أوسلو التي أدّت إلى إقامة سلطة فلسطينية منزوعة السيادة. وكما تبيّن لاحقاً، فإنّ اتفاقيات أوسلو كانت بمثابة الثقب الأسود الذي يبتلع كل الإنجازات والمقدّرات الفلسطينية خدمة للمصالح الصهيونية والأميركية.
والملاحظ أنّ كل هذه التغييرات قد تمّت بداية بقرار فردي من «الزعيم»، ومن ثم فرضها أمراً واقعاً في الأطر الرسمية. والملاحظ أيضاً، أنّ عند كل محطة من هذه المحطات كانت تنشأ معارضة تبدأ قوية ثم تضعف تدريجيّاً إلى أن تقبل بالأمر الواقع.
صحيح أنّ القادة لا يصنعون، وحدهم، التاريخ، وأنّ ما ينجزونه يستند إلى بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية مناسبة، إلّا أنّ قراراتهم غالباً ما تؤدّي دوراً حاسماً. وأهم دور للقيادة هو صناعة الفرص وتهيئة الظروف المناسبة للسير نحو تحقيق الهدف. لهذا يجب أن تُعطى دراسة القيادة ومتابعة تقويم برامجها وقراراتها وممارساتها أهمية قصوى. للأسف، هذا ما لم نقُمْ به رغم العمر الطويل لـ«الثورة الفلسطينية».
قيادة منظمة التحرير هي قيادة السلطة؛ نفس الأشخاص، نفس النهج، نفس الممارسات، ومن أهم شوائبها:
-الزعامة بدل القيادة. نجح عرفات في أن يكون زعيماً، بلا مُنازع، لمنظمة التحرير وعموم الشعب الفلسطيني. وكان رغم المعارضة التي يواجهها، عند تفرّده بالقرار وخروجه عمّا كان قد اتّفِقَ عليه، ينجح في نهاية الأمر أن يطوّع معظم المعارضين وأن يُضعف أو أن يُقصي الآخرين. وبالنتيجة، كان عرفات يسير، ويسير خلفه المعارضون في المنظمة وهم يردّدون «نختلف معه ولا نختلف عليه»!
-الدولة بدل الثورة: منذ إقرار البرنامج المرحلي عام 1974، والذي نصّ على «إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلّة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتمّ تحريرها»، وَقَعَتْ القيادة أسيرة لوهم الدولة. فانتقلت سريعاً من هدف «السلطة الوطنية المقاتلة» إلى إقامة «الدولة الفلسطينية المستقلّة»، وباشرت في تعزيز البُنيان المؤسّساتي الدولتي على حساب بنية حرب العصابات. وبدل أن يكون التحرير لإقامة الدولة، تمّت المراهنة على مؤتمرات ومفاوضات برعاية دولية (أميركية)، فوصلت إلى أوسلو، وليس في أوسلو سوى وَهْم الدولة.
-احتكار جميع السلطات (المال، الإدارة، العلاقات الخارجية، والقرارات المصيرية) بيد القائد وحده، مع السماح بهامش واسع لأعضاء الهيئات القيادية بالتصرّف على هواهم ضمن إداراتهم بما لا يتعارض مع ما يريده القائد.
-الفساد لشراء الولاء بدل القناعة والمبادئ. والأصح أن يُقال الإفساد، لأنّ القيادة كانت تشجّع على ذلك، لدرجة أنّها قنّنت الفساد على شكل موازنات للمسؤولين ومساعدات لعناصر، هذا عدا الاختلاس واستغلال المنصب لمنافع خاصة وغياب المساءلة والمحاسبة. كما اعتمدت توظيف كثيرين بدون أن يكون لهم وظائف فعلية لصرف راتب شهري ومن أجل تشكيل بيئة اجتماعية اقتصادية خاضعة لمشيئة القيادة.
-اعتماد القيادة المطلق على التمويل من جهات خارجية لا تتناسب مصالحها مع المصلحة الوطنية الفلسطينية ممّا جعلها أسيرة لسياساتها، إضافة الى أنّ وفرة المال شكّلت بيئة خصبة للفساد.
الخلاصة: يُستنتج ممّا تقدّم، أنّ هذا النمط القيادي لا يمكن إلّا أن يؤدّي إلى المأزق الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية. لكنّ القيادة الحاكمة ليست وحدها المسؤولة، إذ كانت قوى المعارضة شريكة بما حدث، ولذلك سوف يتمّ تسليط الضوء على النمط القيادي لهذه القوى لاحقاً.
* كاتب وباحث فلسطيني