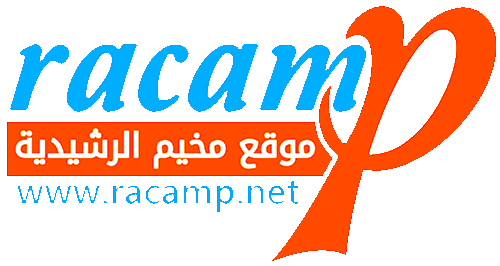محمد شقير
في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، من جنوبه إلى بقاعه، إلى ضاحية عاصمته بيروت، ستبقى بعض المنابر الإعلامية تروّج لسردية بعض النخب وأصحاب المصالح، التي قد يصحّ وصفها بأنها مصابة بأكثر من عمى إستراتيجي، بل وطني، في منهجية مقاربة الموضوع، والتي يمكن صياغتها في هذا السؤال: أن المشكلة في لبنان تكمن في المقاومة وسلاحها، أم أنها تكمن في العدوان الإسرائيلي وما يترتب عليه؟ هل الأولوية لمصلحة إسرائيل وإملاءات الولايات المتحدة الأميركية، أم الأولوية لمصلحة لبنان، وحمايته، وردع العدوان عليه؟
ربما نحتاج إلى أكثر من تحليل سياسي للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، أي إلى تحليل تاريخي، اجتماعي، نفسي، حتى نستطيع تفكيك عقل هؤلاء، والمعايير الحاكمة لديهم، واستمرارهم في منطقهم، رغم ما يرونه من ديمومة العدوان، وتوحّشه، وقتله اليومي للبنانيين، وخرقه الدائم للسيادة.
لكن سنترك هذه المقاربة لفرصة أخرى، كي نجيب الآن عن هذا السؤال: ما الذي يترتّب على استمرارية العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه، وما هي النتائج المنتظَرة لإمعانه في توحشه هذا، من حيث منطق التدافع بينه وبين المقاومة؟
بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أن العدوّ الإسرائيلي يبتغي، من اعتماد إستراتيجية التوحّش هذه، أن تفضي إلى كسر الإرادة، وكي الوعي، لدى المقاومة وبيئتها، للوصول إلى تحقيق جملة أهدافه الإستراتيجية وغيرها، فهل هذا ما يحصل عبر عدوانه، أم إنّ ما يحصل هو عكس ذلك تماماً؟
قد نحتاج إلى معالجة منفردة لإستراتيجية التوحّش الإسرائيلية ونتائجها، ولكن في موضوع مقالنا، ينبغي القول: إنّ ما تُثبته الوقائع المعاصرة، والتجربة التاريخية، أن المقاومة -في ظروف أو أخرى- قد تسعى إلى التكيّف مع بعض المستجدات، أو ممارسة شيء من المرونة في جملة من المتغيرات، ولكن ليس من الصحيح أن يُقرأ هذا على أنه يعني انكسار إرادتها، أو سقوط وعيها، أو هزيمة مشروعها.
وبيان ذلك، أنّ إمعان العدوّ الإسرائيلي في إجرامه وعدوانه، سيفضي – بخلاف ما يتوقّع- إلى ما يلي:
1. المزيد من المشروعية: إذ إنّ المقاومة، في فلسفة وجودها، هي ابنة العدوان والعجز، العدوان الخارجي وعجز المؤسسة الرسمية (الدولة) عن فعل الردع وحماية الوطن والمواطن والسيادة، فتكون المقاومة، كبديل اضطراري، عن انكفاء الدولة عن قيامها بواجبها، في الدفاع والحماية.
وهذا يعني أنّه كلما ازداد العدوان، ازدادت مشروعيّة المقاومة، وكلما أمعن العدوّ في توحّشه وإجرامه، أضحت المقاومة أشدّ مشروعيّة وطنية، وأخلاقية، ودينية، وطبيعية…
وعليه، إن كان العدو الإسرائيلي يروم، من استمرار عدوانه، القضاءَ على المقاومة، فما يفعله، في الواقع، أنّه يزيدها مشروعيّة، فتصبح حجّتها أشدّ منطقية، وقوّتها أشدّ حاجة، وحضورها أكثر ضرورة.
2. عقم البدائل: رغم وجود ألف دليل ودليل، على أنه في مقابل إستراتيجية التوحّش الإسرائيلي، لا أجدى من الردع القادر على لجم هذا التوحّش، ومنع العدوان. مع ذلك، هناك من يزعُم أننا قادرون على منع العدوان، فقط وفقط بالكلام، واستجداء الدول، والفعل الديبلوماسي، مع أنه من الواضح أن الديبلوماسية -على أهمية دورها- حتى تستطيع أن تحقق أهدافها، يجب أن ترتكز على عناصر قوة مادية وغيرها، تجعل دورها فاعلاً ومؤثراً.
ومن أهم عناصر القوة هذه، قوّة الردع، ووجود عناصر قوّة عسكرية وأمنية تلجم العدوان، وتجعله يدرك وجود ثمن كبير لعدوانه، لا يقدر على تحمّله، فإنّه إن حصل ذلك، عندها يأتي دور الديبلوماسية من أجل استثمار عناصر القوة هذه، في تحقيق الأهداف الوطنية. أي إن الديبلوماسية هي استثمار معادلات القوة وفعل الردع، ولكن بلغة سياسية. أمّا ديبلوماسية تفتقر إلى عناصر قوة كافية، فإنها تستحيل إلى استجداء سياسي، وأحياناً إلى نوع من العبث، الذي لا يؤتي ثماره في منطق الدول ومصالحها.
إنّ المدة الزمنية التي أعقبت الاتفاق الحالي -الذي كان يجب تطبيقه بالتزامن والتناسب- والتي قاربت النصف عام، تُثبت أنّ جميع البدائل الأخرى هي بدائل فاشلة، وعقيمة، عن أن تحمي لبنان، وأرضه، وسيادته، ومواطنيه، بدليل آلاف الاعتداءات، ومئات الشهداء والجرحى، والاستباحة الكاملة للسيادة والأرض، وعدم الالتزام بالاتفاق وبنوده، مع وجود هذه الديبلوماسية، والعلاقات الطيّبة مع الدول الضامنة للاتفاق، والاستجابة (غير السيادية) لكثير من الإملاءات وفعل الوصاية، والسبب: عدم وجود عناصر قوّة كافية تردع العدوان.
وعليه، إنّ ما يفعله العدوّ، هو أنه، مع كل اعتداء، يقدّم دليلاً إضافياً على فشل جميع البدائل عن المقاومة وردعها، وعلى أن هذه البدائل، لو كانت قادرة على لجم العدوان ومنعه، لفعلت ذلك، لكن لَمّا لم تفعل، فهو ما يدلّ على عقمها، وعدم جدوائيتها.
3. جدوائية الردع: إن استمرارية العدوان دليل على أهمية الردع، وضرورة العمل على استعادته وترميمه، لأنّه وحده الذي يمكن عبره استرجاع الأمن، ومنع العدوان من استباحة الوطن.
وهنا مغالطة، يعمل بعض الإعلام المتصهين على الترويج لها، بهدف إفشاء ثقافة الهزيمة والاستسلام أمام العدوّ وغطرسته، وهي أن مقولة الردع أثبتت فشلها في الحرب الأخيرة.
والجواب أن هذه الحرب -بخلاف قولهم- دليل إضافي على جدوائية الردع، إذ إن العدو عندما وجد -نتيجة الخرق الأمني والتكنولوجي- أنه قادر على الإضرار بمعادلة الردع التي أرستها المقاومة، فإنه بادر إلى العدوان، ولكنه قبلها، عندما لم يكن في حسابه أنه قادر على هذا الإضرار بمعادلة الردع، فقد كان ملجوماً عن المبادرة إلى فعل العدوان. وهذا يعني أن وجود معادلة ردع، قادرة على إيجاد توازن رعب، وعصيّة على الاختراق والاستهداف، هو الذي يُفضي إلى حماية الوطن من العدوان الإسرائيلي.
هذا فضلاً عن الانتقائية التي يمارسها هؤلاء، عندما يستندون إلى حرب الإسناد للاستدلال على فشل المقاومة، مع أن هذا الاستدلال ينطوي على مغالطة، بيانها أن المقاومة فشلت في تحقيق بعض الأهداف، لكن لا يلتفت هؤلاء إلى أنها نجحت في تحقيق أهداف، لا تقل أهمية عن تلك التي فشلت فيها. لكن سنتجاوز هذا النقاش إلى طرح السؤال التالي: لماذا يستند هؤلاء فقط إلى حرب الإسناد، ولا يستندون إلى تجارب عقود من الزمن، أثبتت فيها المقاومة جدوائيتها، وقدرتها على تحرير الأرض، ونجاحها في ردع العدوان، فلماذا هذه الانتقائية؟ وهل كان هؤلاء مقتنعين بخيار المقاومة وجدوائيتها، عندما كانت المقاومة تحقق الكثير من الإنجازات، بعيداً من فشل أو آخر؟
ألا يصحّ القول، إنه في مسار المقاومة، في التاريخ، قد تحصل انتكاسة أو أخرى، في زمن أو آخر، وعندها، من كان مؤمناً بخيار المقاومة، سيرى في تلك الانتكاسة فرصة للمراجعة والانطلاق من جديد، ومن لم يكن مؤمناً بخيار المقاومة، سيتّخذ منها ذريعة لاستكمال هجومه، وعدوانه المعنوي على المقاومة وبيئتها.
ولا شكّ أن المقاومة، رغم ما أصابها، قادرة بإرادتها، وإيمانها، وإمكاناتها، على ترميم معادلة الردع هذه، لأنها السبيل الوحيد لمنع العدوان، وحماية السيادة، وتحرير الأرض، وحفظ الأرواح، واستعادة الأمن، وهو ما تثبته جميع تجارب التاريخ.
لكن هناك من يروّج لمنطق فيه الكثير من الاستغباء السياسي، ومفاده أن ممارسة الردع تقتضي عدمَ الردع، وهو هذا المنطق يستلزم الإضرارَ بعناصر القوة التي تمتلكها المقاومة، أي تلك العناصر التي هي في رصيد الوطن وحمايته، غير آبهين بقاعدة بديهية، تعمل عليها الدول التي تحترم ذاتها، ويعنيها أمرُ مواطنيها، والدفاع عنهم، وحمايتهم، وهي ضرورة العمل على بناء معادلات الردع، والاستفادة من جميع عناصره المتاحة، عندما يكون هناك عدوان، أو تهديد، وأخطار تمسّ الدولة ومواطنيها، ولكن السفسطائية السياسية لدى هؤلاء لا تمانع حتى قلب الحقائق ومخالفة البديهيات.
بل أكثر من ذلك، عندما يصرّ العدوّ على تجريدك مما تبقى لديك من عناصر قوة، تسهم بمستوى أو آخر في ردعه؛ ألا يستدعي هذا المزيدَ من التعقّل، والحذر، والتبصّر بعواقب الأمور؛ أن إصراره هذا قد يستبطن نوايا عدوانية إضافية، وأنه يبيّت المزيد من العدوان ومشاريع الهيمنة والاحتلال، وإلّا لماذا هذا الإصرار المريب على تجريد الوطن ومقاومته من عناصر قوته تلك. وهو ما يقتضي من العقلاء التحسّب لنوايا العدو هذه، والعمل خلاف إرادته.
فهل يمكن لعاقل أن يستجيب لعدوه، الذي هو غاية في التوحّش والعدوان، في سعيه إلى تجريده مما تبقى لديه من عوامل قوة تحميه، في وقت يقدّم هذا العدو، كل يوم، دليلاً إضافياً، على أنه إنما يريد تجريدَه من سلاحه وعوامل القوة لديه، ليُمعِن فيه قتلاً وعدواناً.
4. الحافزية: أي إن من يعمل على قراءة وتحليل عقل بيئة المقاومة ووجدانها، ومنظومة القيم والمفاهيم الحاكمة لديها، سيدرك أن هذا العدوان لا يضعف إرادة المقاومة، بل -على العكس من ذلك- سيزيدها حافزية، ودافعية، لمزيد من العمل والجهد، للتغلّب على هذه الظروف المستجدة، واستعادة معادلات الردع، وإعادة الأمن والأمان إلى مجتمعها، وكل الوطن، في مقابل هذا التغوّل الإسرائيلي وعدوانه.
وأيضاً هنا نقول: إنه إن كان العدوّ الإسرائيلي يُشبع غرورَه وتوحّشه ببعض الإنجازات الموضعية، فإنّ ما يترتّب على عدوانه، من جهة تخصيب جميع الدوافع لدى المقاومة إلى ترميم الردع، واستعادته، سيكون مآله إستراتيجياً أشدَّ خطراً على هذا العدوّ، من أي مكاسب يسعى إلى تحصيلها موضعياً.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية