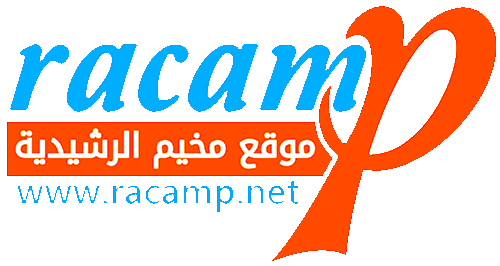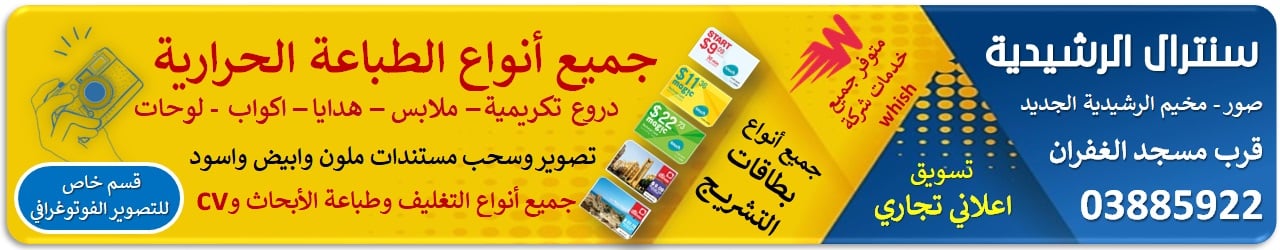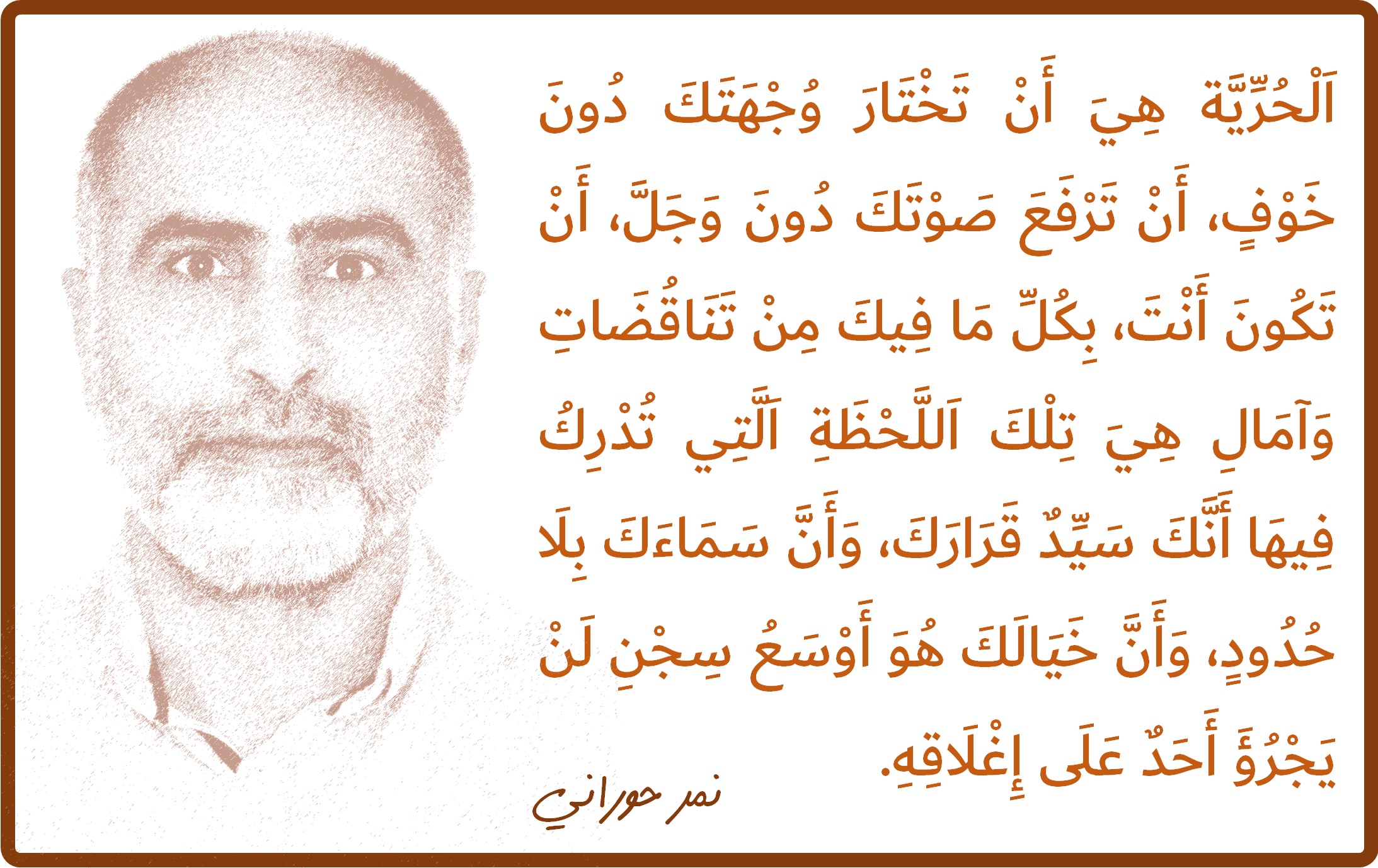فراس صالح
■ مع اقتراب شهر آذار/مارس 2026، تقترب ولاية فيليب لازاريني كمفوض عام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من نهايتها، بعد أن شغل المنصب لولايتين متتاليتين بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ست سنوات قضاها الرجل في موقع بالغ الحساسية، لم تكن مجرد فترة إدارية عابرة، بل مرحلة سياسية مركبة ارتبطت بتوازنات دولية وإقليمية ضاغطة على الوكالة، ومحاولات متسارعة لتصفية دورها التاريخي كأحد العناوين الكبرى لجوهر القضية الفلسطينية «حق العودة». وإذا كانت القاعدة السائدة في تاريخ الأونروا منذ تأسيسها تقضي بألا يتولى أي مفوض عام أكثر من ولايتين، فإن تجربة لازاريني، وإن انتهت عند هذا السقف، ستبقى علامة فارقة في مسار الوكالة، لا لكونها إدارة ناجحة أو إصلاحية، بل لأنها جسدت ذروة الانزياح عن جوهر التفويض الأممي، والاقتراب أكثر من منطق «الإدارة التصفوية» تحت ضغط الممولين والابتزاز الإسرائيلي.
لم يأت لازاريني إلى منصبه من فراغ، بل جاء من خلفية أممية ودبلوماسية عميقة الارتباط بالسياسات الغربية في المنطقة. ومنذ لحظة تعيينه، بدت الوكالة وكأنها تدخل مرحلة جديدة لا تقتصر على مواجهة العجز المالي المركب، بل تتصل بمسار سياسي خطير يستهدف وجود الأونروا نفسه. فالرجل الذي تَقدّم خطابه الأولي بالوعود عن «الحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان استمرارية الدعم للاجئين»، سرعان ما كشف في الممارسة عن نهج مختلف، جعل من العجز المالي شماعة دائمة لتقليص الخدمات، ومن الابتزاز السياسي للممولين بوابة للتراجع عن الدور التاريخي للوكالة.
خلال ولايته، شهدت مناطق عمليات الأونروا الخمس (غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، سوريا) سلسلة من القرارات التي أضعفت الثقة بالوكالة بين اللاجئين أنفسهم. في قطاع غزة مثلاً، حيث يعتمد أكثر من معظم السكان على خدمات الأونروا في التعليم والصحة والإغاثة، قاد لازاريني سياسة «التقليص الممنهج»، بدءاً من تقليص السلال الغذائية وخفض ميزانيات الصحة، وصولاً إلى تهديد مستمر بتعليق البرامج التعليمية.
هذه السياسة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل شكلت ضغطاً يومياً على حياة اللاجئين، وحولت الأونروا من مصدر حماية نسبية إلى مصدر قلق دائم. أما في الضفة الغربية والقدس، فقد تماهى مع الضغوط الإسرائيلية التي سعت إلى تقليص نشاط الأونروا في المخيمات وداخل المدينة المقدسة، فكانت النتيجة إضعاف الحضور المؤسسي للوكالة في واحدة من أكثر الساحات حساسية سياسياً.
الأخطر من ذلك، أن لازاريني لم يتعامل مع الأونروا باعتبارها مؤسسة سياسية بُنيت على الاعتراف الدولي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل حصرها في إطار «المؤسسة الخدماتية». فبينما كان الاحتلال الإسرائيلي يشن حملاته الدبلوماسية الواسعة في الأمم المتحدة والبرلمانات الغربية للمطالبة بإلغاء الأونروا أو دمجها في مفوضية شؤون اللاجئين الدولية، كان لازاريني يقدّم خطاباً متماهياً مع هذه الرؤية من حيث الجوهر، إذ ركّز في بياناته على «استدامة الخدمات» و«تأمين التمويل»، متجاهلاً تماماً البعد السياسي الذي يجعل من وجود الوكالة بحد ذاته اعترافاً أممياً بقضية اللاجئين وحق العودة. لقد تحوّل المفوض العام من «مدافع عن التفويض» إلى «مدير أزمة مالية»، بل إلى ما يشبه «الوسيط» بين الممولين واللاجئين، يقدّم للممولين ضمانات الطاعة، ويقدّم للآخرين وعوداً سرعان ما تتبخر أمام ضغط السياسات.
ومن أبرز محطات الانزياح الخطير في ولاية لازاريني، قرار إنشاء مكتب رئيسي جديد للأونروا في جنيف، حيث اختار أن يقضي ما تبقى من ولايته بعيداً عن ساحات اللجوء. هذا القرار لم يكن بريئاً ولا إدارياً بحتاً، بل جاء ليكرّس فك الارتباط بين المفوض العام والميدان. فالوجود في غزة أو عمان يحمل معنى سياسياً ورمزياً بأن المفوض العام يقف وسط معاناة اللاجئين، أما الوجود في جنيف فيحمل معنى معاكساً: تحويل الأونروا إلى مؤسسة أوروبية الطابع، تُدار من مكاتب بعيدة، ويجري التعامل معها كإحدى هيئات التنمية أو المنظمات الدولية العادية. بهذا القرار، تم استكمال عملية «تغريب» الأونروا، ليس فقط جغرافياً، بل أيضاً سياسياً، وهو ما يخدم عملياً هدف إسرائيل التاريخي المتمثل في إنهاء ارتباط الوكالة بمخيمات اللاجئين.
سياسات لازاريني لم تقتصر على تقليص الخدمات وتغريب المكاتب، بل شملت أيضاً إضعاف البنية الداخلية للوكالة نفسها. فقد خاض مواجهات متكررة مع اتحادات الموظفين، محاولاً كبح دورهم النقابي والسياسي. ففي غزة مثلاً، اصطدم مراراً مع اتحاد العاملين الذي رفض خطط التقليص، ولجأ إلى أساليب إدارية تهدف إلى تفكيك وحدة الموظفين وتقليص هامش حركتهم. هذا المسار أدى إلى إضعاف قدرة العاملين على الدفاع عن أنفسهم وعن مصالح اللاجئين، وحوّل بيئة العمل داخل الأونروا إلى بيئة متوترة، تسودها الشكوك بين الإدارة والموظفين. ومعلوم أن استقرار الجهاز الوظيفي للوكالة هو أحد الشروط الرئيسية لاستمراريتها، لكن لازاريني فضّل الدخول في صراعات داخلية على بناء الثقة مع الموظفين.
على المستوى السياسي الأوسع، يمكن القول إن لازاريني كان جزءاً من منظومة أممية خضعت في السنوات الأخيرة لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ففي أعقاب اتهامات إسرائيلية متكررة للوكالة بدعم «الإرهاب» أو «التحريض»، لم يقف المفوض العام موقف المدافع الصلب، بل سارع إلى تبني خطاب دفاعي ضعيف، وأحياناً متهاون، منح المهاجمين فرصة إضافية لفرض شروطهم. يكفي أن نتذكر كيف تفاعلت الأونروا في ظل قيادته مع المزاعم الإسرائيلية ضد موظفيها في غزة خلال الحرب. بدل أن يدافع عن مؤسسة تحت القصف، اختار أن يفتح باب التحقيقات الداخلية وأن يتعهد للممولين بمراجعات إضافية، ما أعطى الانطباع بأنه يضع الوكالة في موقع المدان لا في موقع الضحية. هذا السلوك زاد من عزلة الأونروا، وأعطى لازاريني الضوء الأخضر لبعض الدول لوقف مساهماتها المالية.
لقد تحوّلت فترة لازاريني إلى لحظة اختبار حقيقية لمدى قدرة الأونروا على الحفاظ على استقلاليتها، فجاءت النتيجة سلبية في معظم جوانبها. فالوكالة التي كان يفترض أن تصمد أمام الضغوط، وجدت نفسها في عهد لازاريني أكثر خضوعاً لشروط الممولين، وأكثر ابتعاداً عن اللاجئين. ومع كل خطوة تقليص، ومع كل تراجع أمام الهجمات الإسرائيلية، كان يتضح أن الرجل يختار «السلامة السياسية» مع الغرب على حساب الالتزام باللاجئين. إن منطق «البقاء بأي ثمن» الذي تبناه لازاريني أدى عملياً إلى تقليص الوكالة من الداخل، حتى وإن بقيت قائمة من الخارج.
لكن اللافت أيضاً أن لازاريني لم يُحدث القطيعة الكاملة مع اللاجئين، بل حاول في خطاباته التمسك بالجانب الإنساني، عبر التركيز على «معاناة الأطفال» و«صعوبات الأسر» و«الحاجة إلى التعليم والصحة». هذه اللغة الإنسانية التي بدت للوهلة الأولى تعبيراً عن التعاطف، تحولت عملياً إلى أداة لتجريد القضية من بعدها السياسي. فحين يُختزل اللاجئون في صورة محتاجين للمساعدات، يُسقط حقهم في العودة والتحرر، ويُختزل وجودهم في كونه «عبئاً إنسانياً» يحتاج إلى إدارة. وهكذا نجح لازاريني – عن وعي أو عن غير وعي – في تمرير الرؤية الغربية التي تريد التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم «ملفاً إنسانياً» لا أكثر.
إن القراءة السياسية المتأنية لمرحلة لازاريني تكشف عن خط متصل بين الضغوط الخارجية وقراراته الداخلية. فهو لم يكن مجرد موظف أممي يطبق سياسات حيادية، بل كان طرفاً في معادلة دولية تهدف إلى إعادة صياغة دور الأونروا. من جهة، أراد الممولون الغربيون التأكد من أن أموالهم لا تُستخدم في أي سياق يُفسَّر سياسياً أو يُعزز من مكانة اللاجئين كجماعة سياسية. ومن جهة أخرى، أرادت إسرائيل التخلص من الوكالة أو على الأقل تحجيمها. وبين هذين الطرفين، لعب لازاريني دور «المُنفّذ المطيع» الذي يوازن بين الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات وبين تنفيذ أجندة التصفية التدريجية.
ولعل السؤال الأهم الآن: ماذا بعد لازاريني؟ إن مغادرته في آذار/مارس 2026 قد لا تعني انتهاء السياسات التي جسدها، بل ربما تكون بداية لترسيخها. فاختيار خليفة جديد له في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 سيتم وفقاً لمعادلات القوى نفسها، ما يعني أن القادم قد لا يكون أفضل، بل ربما أكثر جرأة في دفع الوكالة إلى منطق «التنمية البديلة» أو «الدمج التدريجي» في مؤسسات أخرى. وبذلك، تكون مرحلة لازاريني قد مهدت الأرضية لمرحلة جديدة من الهجوم على الأونروا، مرحلة لم يعد فيها الحديث عن حقوق اللاجئين أساساً من أساسيات العمل الأممي.
في المقابل، فإن انتهاء ولايته يفتح أيضاً نافذة للمراجعة الفلسطينية والعربية. فالتجربة المريرة مع سياسة لازاريني يجب أن تكون درساً في أن ترك الوكالة لرحمة الأمين العام للأمم المتحدة والممولين الغربيين يعني فتح الباب واسعاً أمام التصفية. المطلوب اليوم هو إعادة وضع الأونروا على جدول العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، لا بوصفها مؤسسة خدماتية فحسب، بل باعتبارها شاهداً قانونياً حياً على قضية اللاجئين. ولا بد من استعادة الضغط الشعبي والنقابي من داخل المخيمات نفسها، بحيث يُفرض على أي مفوض عام جديد أن يستمع إلى صوت اللاجئين قبل أن يستمع إلى الممولين.
لقد مثّل فيليب لازاريني، خلال ست سنوات، نموذجاً لمفوض عام أدار الوكالة بعقلية «إدارة الأزمة المالية» وتجاهل عمداً البعد السياسي الأعمق. قراراته بتقليص الخدمات، إضعاف النقابات، نقل المكتب الرئيسي إلى جنيف، الاستجابة الضعيفة للابتزاز الإسرائيلي، كلها خطوات تركت ندوباً عميقة في علاقة اللاجئين مع الأونروا. صحيح أن الوكالة لم تنهَر، لكنها خرجت من عهد لازاريني أكثر هشاشة وأقل صلة بدورها الأصلي. وإذا كانت إسرائيل قد فشلت حتى الآن في إلغاء الأونروا، فإنها بلا شك كسبت كثيراً من خلال هذه المرحلة التي نزعت عن الوكالة جزءاً كبيراً من رمزيتها السياسية.
إن خلاصة المرحلة تقول إن المعركة على الأونروا لم تعد معركة حول التمويل أو الخدمات، بل حول الهوية والوظيفة. وسياسات لازاريني، بكل ما حملته من تنازلات وانزياحات، كانت جزءاً من هذه المعركة، وإن وقعت في خانة الطرف الخاسر بالنسبة للاجئين. واليوم، مع اقتراب لحظة رحيله، تبقى القضية مفتوحة على صراع أشد قسوة، صراع بين من يريد للأونروا أن تبقى صمام أمان سياسي وحقوقي يذكّر العالم بمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ومن يريد لها أن تتحول إلى مجرد ذكرى إدارية تتآكل ببطء حتى تختفي من المشهد■