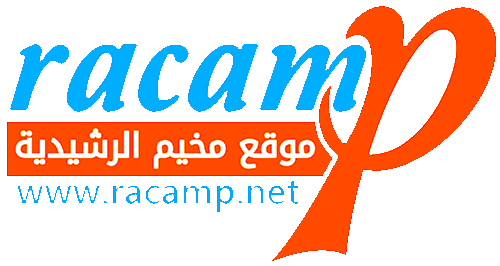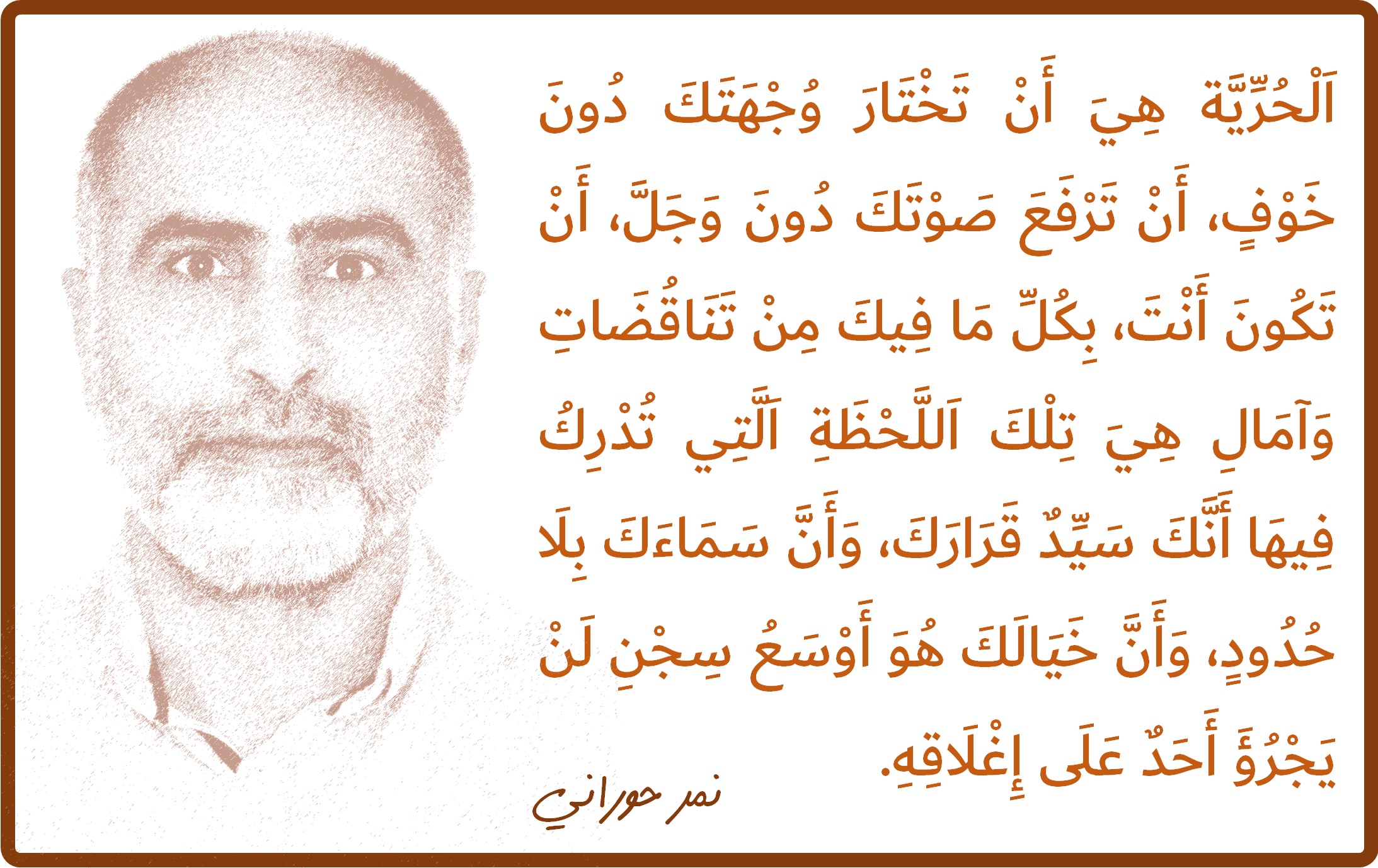كريم حداد
تُظهر الخبرة التاريخية للحركات الإسلامية السياسية أن سؤال البقاء سبق سؤال الحكم، وأن الاستمرارية في ظل الاستهداف المنهجي شكّلت منذ البدايات معيار النضج التنظيمي لا مجرد اختبار ظرفي. فالعمل السياسي في سياقات القمع والاغتيال لا يسمح بالرهان على انتظام الزمن ولا على سلامة القيادة، بل يفرض بناءً مؤسسيًا يفترض الغياب بوصفه احتمالًا دائمًا. من هنا، تتحدد قيمة التنظيم بقدرته على تحويل الضربة إلى حافز لإعادة التشكل، وعلى نزع الفاعلية السياسية عن الاغتيال عبر الجاهزية البنيوية لإنتاج البديل.
هذا المنطق البنيوي، الذي تشترك فيه حركات وكيانات متباينة السياقات، يتبدّى بوضوح في تجارب قوى مثل «الإخوان المسلمين» و«حزب الدعوة الإسلامية»، حيث لم تكن المداورة إجراءً إداريًا، بل ثقافة عمل ناتجة من ضغط الاضطهاد. في هذه البيئات، لا تُختزل القيادة في موضع واحد، ولا تُحتكر المعرفة والقرار في مستوى واحد، بل تُوزّع الوظائف وتُجزّأ الخبرة ويُحاط القرار بطبقات أمان تنظيمية تقلّل أثر أي ضربة. بهذا المعنى، يصبح الاغتيال حدثًا مُدرجًا في الحساب الداخلي، لا قطيعةً مع المسار.
وتتعمق الدلالة حين ننتقل من التنظيمات إلى الأحزاب التي خاضت لحظة التأسيس تحت نار الاستهداف. فـ«حزب الجمهورية الإسلامية» واجه في بداياته ضربة واحدة أودت بعشرات من قياداته، ومع ذلك استمرّ. ليست العبرة هنا في سرعة التعويض العددي، بل في وجود بنية تفترض أن القيادة وظيفة قابلة للإحلال، وأن المشروع يُدار بمنطق المؤسسة لا بمنطق الرأس الواحد.
وكذلك الأمر في تجربة حركة «حماس» التي واجهت على مدى عقود سياسة اغتيالات مركّزة، ومع ذلك حافظت على الاستمرارية عبر إعادة إنتاج الأطر والكوادر وتداول الأدوار. القاسم المشترك في هذه التجارب ليس التماثل الأيديولوجي، بل افتراض المواجهة الطويلة وبناء التنظيم وفق هذا الافتراض.
غير أن البقاء وحده لا يكفي لتأسيس فاعلية سياسية مستدامة.
فالاستمرارية البنيوية، كي تتحول إلى قدرة على التأثير في المجال العام، تحتاج إلى أفق معياري جامع يتجاوز منطق الهوية الصلبة. هنا يبرز التحول المفاهيمي من مركزية شعار «تحكيم الإسلام» إلى مركزية «إقامة العدل» بوصفها الغاية القرآنية الجامعة عند القوى المؤمنة بـ«بعثة الأنبياء». وهذا التحول لا ينطوي على تراجع عن المرجعية الإسلامية، بل يعيد ترتيبها على نحو يجعل القيم المقاصدية، وفي مقدمتها العدل، محرّك الفعل السياسي ومعيار تقويمه.
لقد أدّى التركيز المباشر على «تحكيم الإسلام» في مراحل سابقة وظيفة تعبئةٍ في مواجهة الإقصاء والاستبداد، ولكنه حمل في الوقت نفسه كلفة سياسية ومعرفية. إذ تحوّل الشعار إلى عنوان هويّاتي مغلق، يضيق عن استيعاب التعقيد الاجتماعي، ويعقد إمكانية التحالف على دائرة المتشابهين عقديًا أو فكريًا، حتى عندما تتقاطع المصالح الموضوعية في مقاومة الظلم أو بناء سياسات إنصاف. ومع الزمن، بدا أن تحويل الغاية الأخلاقية إلى شعار سلطوي يُربك السياسة ويختزل الدين في إدارة الحكم.
في المقابل، يفتح جعل «العدل» محور المشروع السياسي أفقًا مختلفًا. فالعدل قيمة كونية قابلة للتعاقد في فضاء تعددي، ومعيار عملي يمكن ترجمته إلى سياسات ومؤسسات وآليات مساءلة. حين تُعيد الأحزاب الإسلامية ترتيب أولوياتها حول إقامة العدل الاجتماعي والقضائي والاقتصادي والسياسي، تغدو مرجعيتها مُلهِمة لا إقصائية، وتصبح قادرة على مخاطبة المجتمع بلغة الحقوق والمصالح العامة، لا بلغة الاصطفاف العقدي. بذلك، يتسع نطاق التحالف ليشمل المختلفين في العقيدة والفكر السياسي ممن يشتركون في هدف تقليل الظلم وتوسيع الإنصاف.
هذا التحول المعياري يتكامل عضويًا مع المنطق البنيوي للاستمرارية تحت الاستهداف. فالتنظيم الذي يُدرج الاغتيال في حسابه، ويُهيّئ نفسه لإنتاج البديل، يمتلك في الأصل قابليةً أعلى للفصل بين المشروع والأشخاص، وبين المرجعية والقالب. وعندما يقترن ذلك بأفق العدل، يتحول العمل السياسي من صراع على «من يحكم باسم من» إلى مسار طويل النفس لتشييد مؤسسات عادلة، وتوزيع منصف للموارد، وحماية قانونية للفئات الأضعف. هنا، تُقاس الفاعلية لا بامتلاك السلطة، بل بالقدرة على تعديل القواعد التي تُنتج الظلم.
إن مفهوم «الفاعلية السياسية» بهذا المعنى يحرّر المشروع الإسلامي من ثنائية المعارضة/السلطة، ويضعه في فضاء أوسع: التأثير المستدام. فالفاعلية تُبنى عبر حضور اجتماعي منظم، وخطاب معياري قابل للتعاقد، وبنية مؤسسية قادرة على الصمود. وهي تتطلب، معرفيًا، أولوية المقاصد على الأشكال، والشورى على الاحتكار، والمسؤولية الجماعية على التراتب الجامد. كما تتطلب عمليًا سياسات قابلة للقياس والمساءلة، تترجم العدل إلى مؤشرات أداء وممارسات مؤسسية.
في السياقات المركبة، ومنها السياق اللبناني والإقليمي، تتضاعف أهمية هذا المسار. فالتعددية الدينية والسياسية، وهشاشة الدولة، وتاريخ الاغتيال السياسي، تجعل أي مشروع قائم على الهوية الصلبة عرضةً للعزلة أو للاستنزاف. أما المشروع الذي يجمع بين جاهزية بنيوية للصمود وأفق معياري للعدل، فيمتلك قدرة أعلى على بناء تحالفات عابرة للهويات، وعلى تحويل الصراع من نزاع صفري إلى تنافس برامجي حول السياسات العامة. بهذا المعنى، لا يعود الاغتيال أداة كسر، بل اختبارًا لصلابة المؤسسة؛ ولا يعود الاختلاف العقدي مانعًا للتحالف، بل عنصر تنوع داخل تعاقدٍ على العدالة.
إن إعادة مركزية العدل لا تعني إلغاء الخصوصية الإسلامية، بل تعني ترجمتها إلى لغة عامة تُغني المجال العام بدل أن تُغلقه. فالدين، حين يعمل بوصفه أفقًا قيميًا، يُسهم في تهذيب السياسة لا في تأليهها، ويمنحها معيارًا للمساءلة لا غطاءً للهيمنة. وعندما تتجسّد هذه الرؤية في تنظيمات قادرة على امتصاص الضربات وإنتاج البديل، تصبح السياسة ممارسة جماعية قابلة للاستمرار، لا رهينة اللحظة ولا أسيرة الأشخاص.
خلاصة القول إن التلاقي بين منطق الاستمرارية تحت الاغتيال ومنطق إقامة العدل يوفّر إطارًا متماسكًا لتجديد العمل السياسي الإسلامي. فالأول يؤمّن الصلابة البنيوية ونزع الفاعلية عن الاستهداف، والثاني يوفّر الأفق المعياري وتوسيع دوائر التحالف. وبينهما تتشكل فاعلية سياسية قادرة على الصمود والتأثير، تُعيد تعريف النجاح لا بوصفه غلبةً آنية، بل بوصفه قدرةً مستدامة على تقليل الظلم وبناء مؤسسات عادلة في مجتمعات متعدّدة ومعقّدة. بهذا الأفق، يغدو المشروع الإسلامي مساهمةً عامة في السياسة، لا مشروع هوية مغلقة؛ ومسارًا تاريخيًا مفتوحًا، لا استجابةً ظرفية لميزان قوة متقلّب.
يقتضي هذا التحول المزدوج، من الاستمرارية تحت الاغتيال إلى مركزية العدل، إعادة نظر أعمق في مفهوم الزمن السياسي الذي تتحرك ضمنه الأحزاب الإسلامية. فالعمل السياسي، في كثير من تجاربه الحديثة، أُسِرَ بزمن قصير، زمن اللحظة والصدمة والردّ الفوري، وهو زمن تفرضه بيئات الصراع والاستهداف. غير أن الحركات التي نجحت في البقاء لم تفعل ذلك لأنها أتقنت إدارة اللحظة فحسب، بل لأنها بنت تصورًا مختلفًا للزمن: زمنًا تراكميًا، طويل النفس، يسمح بتوزيع الخسائر، وامتصاص الضربات، وتحويل الفشل الجزئي إلى معرفة تنظيمية. هذا الوعي الزمني هو ما يجعل الاغتيال حدثًا محدود الأثر، لأن معناه يُعاد امتصاصه داخل مسار أطول لا يتوقف عند الأفراد ولا عند الوقائع المفصلية.
العمل وفق مفهوم العدل يسمح بتحالفات كبيرة مع بقية أطراف المجتمع ويتيح تفاعلاً لا يهدد الهوية الفكرية أو الجسم التنظيمي للقوى الإسلامية
ضمن هذا الأفق، يتبدّى أن التحول نحو العدل ليس مجرد إعادة صياغة خطابية، بل هو إعادة تموضع في الزمن السياسي نفسه. فالعدل قيمة لا تُستنفد في دورة انتخابية، ولا تُنجز بقرار واحد، بل تُبنى تدريجيًا عبر مؤسسات، وتشريعات، وسياسات عامة، وممارسات اجتماعية. وعندما تتبنى الأحزاب الإسلامية هذا الأفق، فإنها تنتقل من منطق «الإنجاز الحاسم» إلى منطق «التراكم الإصلاحي»، ومن البحث عن لحظة فاصلة إلى الاستثمار في مسار قابل للاستمرار. بهذا المعنى، يصبح الزمن حليفًا لا عدوًا، ويغدو الصبر السياسي، بوصفه استراتيجية وليس خيارًا أخلاقيًا فقط، عنصرًا تأسيسيًا في الفاعلية.
هذا التحول يفرض إعادة تعريف العلاقة بين التنظيم والمجتمع. فالحركات التي نشأت في سياق الصراع، عملت كثيرًا على تطوير آليات حماية داخلية، لكنها جعلتها شديدة الانغلاق، وهو انغلاق مفهوم وظيفيًا لكنه مكلف سياسيًا. أما الانتقال إلى مشروع العدل، فيفترض انفتاحًا مُدارًا على المجتمع، لا يفرّط بالأمن التنظيمي، ولا يعيد إنتاج منطق الطليعة المنعزلة. فالعدل، كي يتحول إلى قوة سياسية، يحتاج إلى حوامل اجتماعية واسعة: نقابات، روابط مهنية، مبادرات مدنية، شبكات تضامن، ومساحات نقاش عمومي. وهذا يقتضي من الأحزاب الإسلامية تطوير أدوات اشتغال تتجاوز التنظيم الصارم إلى أشكال عمل مرنة، قادرة على بناء الثقة، وتبادل المعرفة، وإنتاج تحالفات موضوعية حول قضايا ملموسة.
ويكشف هذا المسار عن بعد معرفي بالغ الأهمية: الانتقال من فقه السلطة إلى فقه المجال العام. فبدل الانشغال بسؤال «كيف يُحكم؟» بوصفه سؤالًا تقنيًا أو سلطويًا، يُعاد طرح السؤال على نحو مختلف: كيف يُنتَج العدل في فضاء تعددي؟ وهو تحول يفتح المجال أمام استثمار تراث واسع في الفكر الإسلامي حول المقاصد، والمصلحة العامة، ويضعه في حوار مباشر مع نظريات العدالة المعاصرة، من دون ذوبان ولا تعارض. وهنا، لا يعود الاختلاف مع القوى الأخرى تهديدًا للهوية، بل موردًا معرفيًا يثري النقاش حول السياسات والخيارات، ويُخرج العمل السياسي من أسر اليقينيات المغلقة.
إن هذا التوسيع المعرفي ينعكس مباشرة على بنية القرار داخل الأحزاب. فحين يكون الهدف هو العدل، لا مجرد الحفاظ على التنظيم أو توسيع النفوذ، تصبح الحاجة ملحّة إلى آليات تشاورية أوسع، وإلى إدماج خبرات متخصصة، وإلى قبول النقد الداخلي بوصفه شرطًا للتصحيح لا عاملًا للانقسام. كذلك، يفرض هذا المنطق تطوير أدوات قياس للأداء السياسي، تسمح بتقييم السياسات وفق أثرها العادل، لا وفق مردودها التعبوي فقط. بذلك، تتحول المؤسسة الحزبية إلى فضاء تعلّم مستمر، لا إلى جهاز تعبئة مغلق.
في المحصلة، تُظهر هذه الإضافة أن الجمع بين الجاهزية البنيوية في مواجهة الاغتيال، وبين التحول المعياري نحو العدل، لا يُنتج فقط قدرة على البقاء، بل يفتح أفقًا جديدًا للعمل السياسي الإسلامي بوصفه مشروعًا طويل المدى، متعدد المستويات، ومندمجًا في المجتمع. هذا الأفق لا ينفي الصراع ولا يتجاهل موازين القوى، لكنه يرفض اختزال السياسة في لحظاتها العنيفة أو شعاراتها القصوى. وبهذا، تتجدد الأطروحة الإسلامية لا عبر تبديل مرجعيتها، بل عبر تعميقها، وجعلها أكثر قدرة على الاشتغال في عالم معقّد، حيث الاستمرارية والعدالة ليستا خيارين متوازيين، بل شرطان متلازمان لأي فاعلية سياسية قابلة للحياة.
إن حركات المقاومة الإسلامية تواصل مسارها التاريخي ليس فقط لأنها نجحت في بناء تنظيمات قادرة على الصمود، بل لأنها تنطلق من تصور يرى أن الاجتماع السياسي نفسه يظل مبتورًا ما لم يُحسم سؤال التحرر. فالبناء الذاتي للمجتمع والدولة لا يمكن أن يبدأ من داخل واقع مُصادَر الإرادة، ولا أن يستقيم في ظل احتلال مباشر أو خضوع غير مباشر يُفرغ السيادة من مضمونها. في هذا السياق، لا تُفهم المقاومة بوصفها حالة استثنائية أو مرحلة طارئة تُستنفد بانتهاء الصراع العسكري، بل بوصفها شرطًا تأسيسيًا لإمكان السياسة العادلة، لأن العدالة تفترض أصلًا وجود مجتمع يمتلك قراره، ودولة قادرة على تمثيل مصالحه من دون وصاية أو إكراه. فالاحتلال لا يختزل الأرض فحسب، بل يعيد تشكيل البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على نحو يُنتج قابلية للاستسلام، ويُضعف الثقة بالذات الجماعية، ويحوّل الدولة—إن وُجدت—إلى جهاز إدارة للأمر الواقع لا أداة للتحرر والإنصاف.
من هنا، ترى حركات المقاومة الإسلامية أن فعل التحرير هو المدخل الضروري لإعادة بناء المجتمع على أسس العدالة، لا نقيضًا لها ولا بديلًا منها. فالمقاومة، في هذا المعنى، ليست إنكارًا للسياسة، بل إعادة تأسيس لها في شروطها الأولية، حيث تُستعاد الإرادة العامة، ويُعاد وصل السياسة بالأخلاق، ويُكسر منطق التكيّف القسري مع ميزان قوة مفروض. وعندما تُدرج هذه الحركات التحرر في صلب مشروعها، فإنها لا تفصل بين معركة السيادة ومعركة العدالة الاجتماعية، بل تعتبر أن الثانية تظل شكلية ومحدودة ما دامت الأولى مؤجلة أو منقوصة. فالاستسلام، مهما اتخذ من صيغ واقعية أو براغماتية، يُفضي في النهاية إلى إعادة إنتاج الظلم داخل المجتمع نفسه، لأن من يقبل الهيمنة الخارجية يعجز عن مقاومة الهيمنة الداخلية.