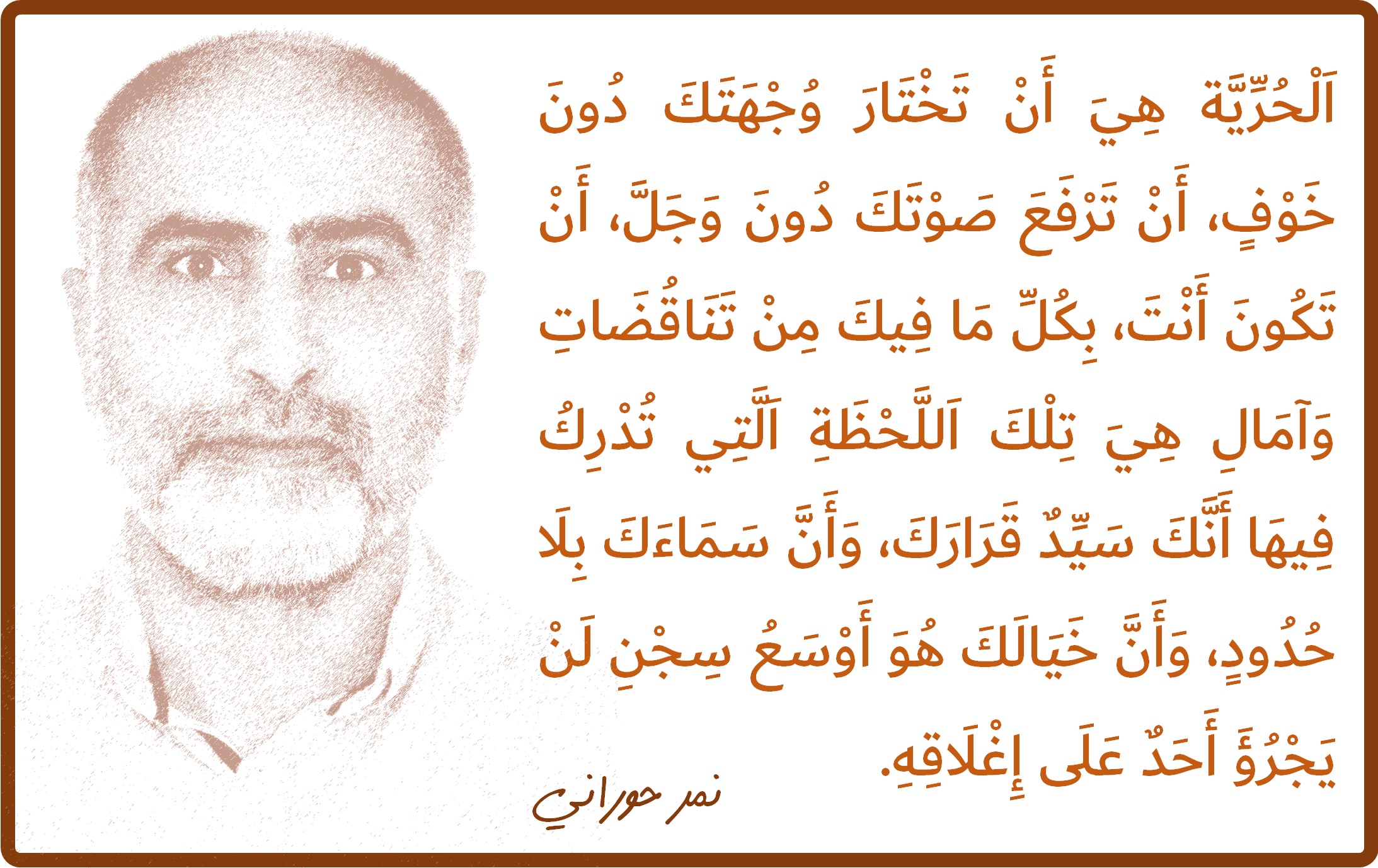محمد محمود مرتضى
يبدو أنّ سؤال النصر والهزيمة يفرض نفسه بعد كلِّ معركة بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، وهو سؤال قد يظهر للوهلة الأولى سؤالاً بسيطاً محوره: من ألحق بالآخر خسائر أكبر؟ ومن فرض معادلات جديدة؟ لكنَّ هذا السؤال، في حقيقته، تعبير عن اختلاف أعمق في مرجعيَّة تعريف النصر والهزيمة. فقبل أن نسأل: من انتصر؟ ينبغي أن نسأل: بأيِّ معيار يُقاس النصر أصلاً؟ ومَن يمتلك سلطة تعريفه؟ فالنصر مفهومٌ يُبنى داخل منظومة فكريَّة وخُلُقيَّة وسياسيَّة مُحدَّدة. وحين تختلف المنظومات، تختلف بالضرورة معايير الحكم.
من هنا، لا يصحّ التعامل مع توصيف النصر والهزيمة بوصفه خلافاً في الروايات أو في الدعاية، وإنَّما بوصفه تعبيراً عن اختلاف جذري في تعريف الحرب ذاتها، ووظيفتها، وغايتها. ولذلك، فإنَّ أيَّ نقاش لا يبدأ من تفكيك مرجعيَّة كلِّ طرف في تحديد معنى النصر، سينتهي حتماً إلى سجال انطباعي لا يفسّر الواقع بقدر ما يعكس ارتباكه.
أوَّلاً- النصر في مرجعيَّة «الدولة الحديثة»: منطق الحسم والإنهاء
في مرجعيَّة الدولة الحديثة، وبصورة أكثر حدّة في حالة إسرائيل، يُعرَّف النصر بوصفه حسماً نهائياً. فالكيان لا يخوض الحرب كي يدير الصراع، بل كي يُنهيه أو يضبطه ضمن شروط تضمن أمنه واستقراره. لذلك، يُقاس النصر بمجموعة عناصر مترابطة: تحقيق الأهداف المُعلنة، وتدمير قدرات الخصم، وكسر إرادته، واستعادة الردع بما يمنع تكرار التهديد.
وهذا التصوُّر يفترض جملة مُسلَّمات:
1. أنَّ الحرب أداة لضبط البيئة الاستراتيجيَّة لا لإدارتها طويلاً.
2. أنَّ التفوُّق العسكري يجب أن يُترجم نتائج نهائيَّة.
3. أنَّ استمرار التهديد بعد الحرب يُعدّ فشلاً، مهما بلغ حجم الدمار.
وفق هذا المعيار، يكون النصر قدرة على الإنهاء. ولذلك، فإنَّ أيَّ مواجهة لا تُفضي إلى كسر الخصم، أو تجريده من أدوات الفعل، تُقرأ داخل هذا المنطق بوصفها إخفاقاً بنيويّاً، حتى لو رافقها تفوّق ناري هائل.
فالدولة، بخلاف حركة المقاومة، لا تستطيع أن تعتبر الزمن رصيداً لها، إنَّ الزمن بالنسبة إليها خطر؛ لأنَّ كلَّ يوم إضافي يعني تهديداً قائماً لمفهوم الأمن الذي قامت عليه.
لهذا السبب تحديداً، تُصاب المؤسَّسة الإسرائيليَّة بالقلق العميق حين تعجز عن الحسم. فعدم القدرة على إنهاء التهديد، أو فرض شروط الاستسلام، لا يُقرأ داخلياً بوصفه «نتيجة مقبولة»، وإنما بوصفه فشلاً في وظيفة «الدولة» ذاتها.
ثانياً: النصر في مرجعيَّة المقاومة ومنطق المنع والتراكم
في المقابل، تنتمي حركات المقاومة إلى مرجعيَّة مختلفة جذرياً، بحكم موقعها في ميزان القوَّة وطبيعة الصراع الذي تخوضه. فهي لا تمتلك أدوات السيطرة الشاملة، ولا تسعى – أصلاً – إلى حسم نهائي سريع. لذلك، يُعاد تعريف النصر لا بوصفه إنهاءً للصراع، بل بوصفه منعاً للهزيمة.
في هذا المنطق، يعني النصر:
1. إفشال الأهداف الأساس للعدوّ
2. منع فرض شروطه السياسيَّة أو الأمنيَّة
3. الحفاظ على قدرة الاستمرار والمبادرة
هنا، يتحوَّل الصمود من حالة دفاعيَّة إلى فعل استراتيجي هجومي، ويغدو الزمن عنصر قوَّة، لا عنصر استنزاف. فالمقاومة لا تراهن على لحظة خاطفة، بل على تراكم الأثر، وعلى استنزاف التفوُّق، وعلى تحويل القوَّة الماديَّة للعدوّ إلى عبء سياسي ونفسي.
لكنَّ هذا التعريف، على متانته النظريَّة، عرضة للالتباس حين لا يُؤسَّس بوضوح في الوعي العام، ولا يكون فاعلاً تلقائيّاً في هذا الوعي، وما لم يُحط بخطاب منضبط، وسقف توقُّعات واضح، ومعيار مرجعي ثابت، أو حين يُزاحم بخطابات أخرى، وهنا تبدأ الإشكاليَّة الحقيقيَّة.
ثالثاً: انتقال الأزمة من الخارج إلى الداخل
فالإشكاليَّة الأخطر اليوم لم تعد محصورة في اختلاف معيار النصر بين المقاومة والعدوّ، وإنما في انتقال الارتباك إلى داخل بيئة المقاومة نفسها. فمع تصاعد الخطاب الإعلامي، وتكثيف الوعود الميدانيَّة، بدأ معيار النصر ينزاح – في المخيال الشعبي – من كونه مساراً استراتيجياً طويل النفس، إلى كونه اختباراً مباشراً لتحقّق وعود محدَّدة. بمعنى آخر، نقل مركز الثقل من المعنى إلى الوعد، ومن الغاية إلى الصورة. فقد ترسَّخت في وعي الجمهور مجموعة من الصور الناتجة من خطابات أطلقها الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله (رضوان الله عليه) من قَبيل: إن هدم المباني في لبنان من قِبل العدوّ سيقابل بهدم مبانٍ في تل أبيب، وتعطيل المطارات، وشلّ الطيران العسكري، وفرض معادلات مرئيَّة وفوريَّة.
هذه الوعود التي جاءت في سياق حرب نفسيَّة واستعدادات ميدانيَّة وفرض معادلات ردعيَّة، تحوّلت في المخيال الشعبي من أدوات ضغط معنوي وسياسي إلى مقاييس حاكمة للحكم على النصر والهزيمة.
ومع هذا التحوٌّل، انتقل مركز التقويم من المعنى إلى المشهد، ومن المسار إلى اللحظة. فكانت النتيجة أنّ السؤال لم يعد: هل فشل العدوّ في فرض إرادته؟ بل أصبح: هل تحقَّقت الوعود كما أُعلِنت؟
وهنا وقع الخلل البنيوي. فحين تُربط فكرة النصر بتحقُّق وعود جزئيَّة، يُصبح عدم تحقُّق – أو تحقُّق جزئي – مصدرَ ارتباكٍ وإحباطٍ، حتى لو كانت نتيجة الحرب، في ميزانها الأعمق، تميل إلى صالح المقاومة. وبهذا المعنى، لا يكون الخلل في الوعد ذاته، بل في تحويل الوعد إلى معيار.
فهنا حدث الانزلاق الأخطر عندما بدأ جمهور المقاومة يقيس النصر بمنطق إنجازي قريب من منطق الدولة الحديثة، لا بمنطق المقاومة ولا بمنطقها المرجعي الأعمق.
وهكذا لم تعد المشكلة أنَّ إسرائيل تدّعي النصر، فذلك جزء من بنيتها الدعائيَّة، وإنَّما تكمن المشكلة في أنَّ جزءاً من جمهور المقاومة بات يقيس النصر بأدوات العدوّ نفسها: صورة، ودمار مرئي، وإعلان فوري، ونتيجة قابلة للعدّ. وهو ما يُفرغ مفهوم النصر من بعده القِيَمي والتاريخي، ويحوُّله إلى اختبار إنجازات قصيرة الأمد.
والأخطر من ذلك أنَّ هذا التحوّل يُنتِج أثراً عكسياً على الوعي المقاوم: فبدل أن يكون الزمن عنصر قوَّة – كما في منطق المقاومة – يتحوَّل إلى عنصر ضغط، وبدل أن يكون الصمود معياراً، يصبح مجرّد تعويض عن «غياب الإنجاز الموعود». وهنا تنتقل المقاومة من موقع تعريف النصر إلى موقع الدفاع عنه.
فالوعود الميدانيَّة، حين تُفصل عن معيارها الاستراتيجي، لا تعود عناصر تعبئة مرحليَّة، وإنما تصبح سقفاً نفسياً يُقاس عليه كلّ شيء.
وهذه في الحقيقة أعمق من كونها أزمة خطاب؛ لأنَّها في الواقع أزمة وعي. فأخطر ما يمكن أن تواجهه المقاومة ليس خسارة ميدانيَّة قابلة للتدارك، وإنَّما فقدان ميزان التقويم الذي به تُفهم التضحيات، ويُحمَل الألم.
رابعاً: المعيار الإيماني
عند هذه النقطة تحديداً، ولأنَّ حزب الله يعرِّف نفسه بوصفه «حركة جهاديَّة»، يصبح استدعاء المرجعيَّة القرآنية للنصر والهزيمة ضرورة تحليليَّة، لا قفزة وعظيَّة. فالقرآن يؤسِّس للنصر بوصفه تحقُّقاً للغلبة المعنويَّة والتاريخيَّة، لا مجرَّد انتصار عسكري لحظي.
ففي الميزان القرآني:
1. النصر ليس مرهوناً بتحقُّق كلّ الوعود الظاهريَّة فوراً.
2. ولا يُقاس بحجم الدمار، وإنَّما بكسر منطق الطغيان.
3. والهزيمة ليست سقوط موقع، بل الهزيمة الحقيقيَّة هي الانكسار الداخلي وسقوط بوصلة، أو قَبول بشروط الظالم.
ففي التجربة القرآنيَّة، لم يكن النصر مرتبطاً دائماً بتحقُّق كل ما وعد به القائد أو النبيّ على المستوى الظاهري والفوري بل بتحقُّق السُّنَن الكبرى:
1. بقاء الجماعة المؤمنة
2. سقوط هيبة الطغيان
3. انكشاف زيف القوَّة المتغطرسة
4. تراكم شروط الغلبة ولو بعد حين.
وبكلمة أخرى، النصر في التصوُّر القرآني، ليس نتيجةً حسابيَّة لعدد الأهداف المدمَّرة، ولا مشهداً استعراضياً لانهيار العدوّ، وإنَّما هو تحقُّق الغاية من المواجهة. فالنصر في القرآن قد يتحقَّق مع الخسائر، بل أحياناً من خلالها، ما دام ميزان الصراع لم يُكسر لصالح الظالم.
من هنا، قد تُصاب الجماعة المؤمنة بالجراح دون أن تكون مهزومة، وقد يمتلك العدوّ تفوُّقاً نارياً دون أن يكون منتصِراً. فالعبرة بما يستقرّ أخيراً في ميزان التاريخ.
إنَّ سؤال النصر والهزيمة بين حزب الله وإسرائيل ليس سؤالَ نتائج عسكريَّة، وإنَّما هو سؤال مرجعيَّات ومعايير ووعي. وحين يختلُّ هذا الوعي، تُختزل المعركة في صور ووعود، بدل أن تُفهم في سياقها التاريخي والخُلُقيّ.
إنّ التحدِّي الحقيقي اليوم يكمن في إعادة تثبيت معيار النصر في الوعي المقاوم، أكثر منه في إثبات أنَّ المقاومة «انتصرَت» بالمعنى الإعلامي للانتصار.
*أكاديمي وباحث