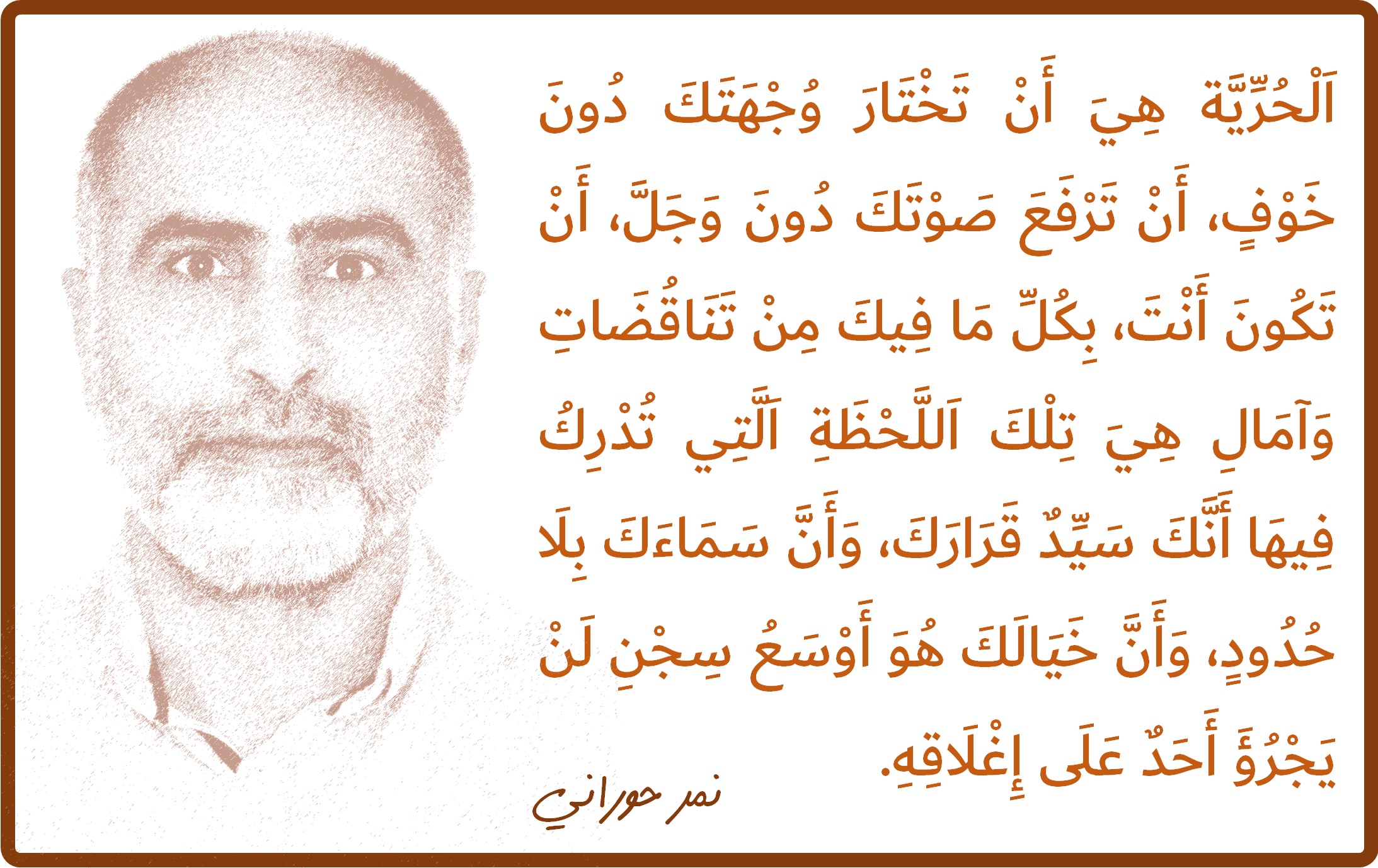معين الرفاعي
تتعامل «استراتيجية الأمن القومي الأميركية 2025» مع الشرق الأوسط بوصفه عبئاً يجب تخفيف كلفته لا مركزاً لصوغ القرار العالمي، ولكنها في الوقت نفسه، تُعيد تثبيت المنطقة كحزام أمني – اقتصادي لا غنى عنه لضمان تدفّق الطاقة وحماية إسرائيل وتطويق خصوم واشنطن. وبين وثيقة 2017 (خلال فترة ترامب الأولى) ووثيقة 2025، تتشكّل ملامح تحوّل لافت: من خطاب هجومي مفتوح على «محور الشر/ المقاومة»، إلى مقاربة أكثر براغماتية، تقبل بالتوازنات القائمة ما دامت لا تعطّل ممرات النفط ولا تهدّد دولة الاحتلال، ولا تفتح باباً لحرب جديدة تنزف فيها القوة الأميركية.
من مركز الصراعات إلى «هوامش» الاستراتيجية
لا تنكر وثيقة 2025 أهمية الشرق الأوسط، لكنها تنزعه من موقع «مركز الاهتمام» الذي شغله لعقود متتالية لمصلحة جبهات أخرى، وفي مقدمتها التنافس مع الصين وروسيا وأمن سلاسل التوريد. توحي اللغة المستخدمة في الاستراتيجية بأن المنطقة فقدت كثيراً من ديناميكيتها السابقة: فلم تعد المصدر الأوحد للطاقة في العالم، ولا الساحة الوحيدة للحروب الكبرى، بل واحدة من مسارح عدّة متداخلة يجب إدارتها بأقل قدر من الانخراط المباشر.
هذا لا يعني انسحاباً أميركياً، بل إعادة ترتيب الأولويات: المطلوب أن يبقى الخليج مفتوحاً للطاقة، وأن يبقى البحر الأحمر ومضيق هرمز سالكَين للملاحة، وأن تبقى إسرائيل متفوقة عسكرياً، وأن تُضبط حركات المقاومة تحت سقف لا يسمح لها بتغيير قواعد اللعبة في فلسطين أو الإقليم. ضمن هذه الرؤية، تستمر شعوب المنطقة في دفع ثمن الاستقرار الذي تريده واشنطن، لكنها تُمنع في الوقت نفسه من امتلاك أدوات تغيير جذري في المعادلة السياسية أو في بنية التحالفات.
قائمة المصالح: نفط وممرّات وحماية الإرهاب الإسرائيلي
تقدّم الوثيقة تعريفاً شديد التركيز لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يكاد يختزل المنطقة في خمس أولويات واضحة:
(1) منع وقوع إمدادات الطاقة في الخليج في أيدي «عدو صريح» أو قوّة معادية للمصالح الأميركية.
(2) ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط والتجارة الدولية كخط أحمر استراتيجي.
(3) تأمين البحر الأحمر ومسار قناة السويس في سياق حماية سلاسل التوريد العالمية.
(4) الحؤول دون تحوّل المنطقة إلى حاضنة للإرهاب أو نقطة انطلاق لعمليات تستهدف الداخل الأميركي أو مصالحه المنتشرة في العالم.
(5) إضافة، بالطبع، إلى الإبقاء على إسرائيل آمنة، متفوّقة عسكرياً وتكنولوجياً، وقادرة على لعب دور رئيسي في مواجهة إيران ومحور المقاومة.
بهذا التعريف، لا تظهر الديموقراطية ولا حقوق الإنسان ولا حق الشعوب في تقرير المصير إلا كهوامش خطابية في أحسن الأحوال، فيما تُصاغ المصالح بلغة الممرات والموارد والأمن الإسرائيلي.
بالنسبة إلى شعوب المنطقة، يكرّس هذا النهج معادلة قديمة: تُختزل المنطقة إلى «أرض/ ثروات» تُدار خطوطها البحرية وباطنها النفطي من الخارج، بينما يُترك للبشر فيها هامش ضيّق بين الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية.
أدوات التنفيذ: قبول الأنظمة وتوسيع التطبيع
في وثيقة 2017، طغى خطاب يقوم على مواجهة «الأنظمة المارقة» و«الإرهاب الإسلامي المتطرف» مع مساحة أوسع للحديث عن تشجيع «التطلعات الديموقراطية» ولو بشكل انتقائي، في ظل نزعة هجومية تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بالقوّة الناعمة والخشنة. أمّا في وثيقة 2025، فيبرز تحوّل إلى ما يمكن تسميته «الواقعية المحافظة»؛ إذ تقرأ الإدارة الأميركية التجارب المرّة في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، وتخرج بخلاصة مفادها أن كلفة محاولة تغيير الأنظمة أعلى بكثير من كلفة التعايش معها ما دامت لا تصطدم مباشرة بالمصالح الأميركية.
يُترجم هذا التحوّل في ثلاثة مسارات عمليّة:
أوّلها، تشجيع الشركاء على «مكافحة التطرف» كوظيفة أمنية، لا كبوابة لإصلاح سياسي أو مشاركة شعبية حقيقية، الأمر الذي يمنح شرعية إضافية للأنظمة السلطوية التي تتبنّى خطاب «محاربة الإرهاب» في مواجهة خصومها الداخليين.
ثانياً، التخلّي الضمني عن خطاب «نشر الديموقراطية» الذي استُهلك في حقبة بوش وأعيد تدويره بشكل أقل حدّة في وثيقة 2017، لمصلحة خطاب «احترام السيادة» الذي يخدم عملياً استقرار الأنظمة الحليفة.
ثالثاً، اعتماد مبدأ «الضربات المحسوبة» لمواجهة أي تهديد، عبر أدوات استخبارية وعسكرية محدودة، وعقوبات اقتصادية وسيبرانية وحروب بالوكالة، ومساع لتغيير الثقافة السائدة في المنطقة، بدلاً من الغزو المباشر والحروب البرية المفتوحة. تقول الوثيقة بوضوح إن الجبهة الفكرية والثقافية هي جبهة مواجهة، جنباً إلى جنب، مع التدخل العسكري.
بالنسبة إلى شعوب المنطقة، هذا يعني أن واشنطن لم تعد مضطرة حتى إلى تغليف تحالفها مع الأنظمة بوعود إصلاحية، بل باتت أكثر صراحة في تفضيل «الاستقرار السلطوي» على المغامرة بأي تغيير قد يفتح الباب أمام قوى مقاومة أو حركات تحرر أو حتى نخب وطنية مستقلة.
دول الخليج: من موقع الاتهام إلى موقع الحماية
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، كانت دول الخليج، وخاصة السعودية، في مرمى الاتهام داخل الخطاب الأميركي الرسمي والإعلامي، بوصفها بيئة حاضنة للفكر المتطرّف والمموّل الأوّل للمدارس الدينية التي خرجت منها موجات «التطرف الإسلامي». اليوم، تعيد استراتيجية 2025 رسم الصورة: الخليج شريك في محاربة التطرّف، وركن في منظومة الطاقة العالمية، وممرّ لإعادة إعمار غزة وسوريا واليمن، وأداة رئيسية في مواجهة إيران.
تتجنّب الوثيقة أي حديث عن تغيير الأنظمة، ولا سيما في الخليج، وتتعامل معها باعتبارها جزءاً ثابتاً من المشهد، بل وتراهن على خططها الاقتصادية («رؤية 2030» وغيرها) لتوفير فرص استثمارية للشركات الأميركية والغربية في الطاقة المتجدّدة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. في المقابل، يتّسع هامش المناورة أمام هذه الأنظمة لتعميق التحالف مع واشنطن وتل أبيب، وتقليص أي مساحة داخلية لصوت معارض تحت عنوان «مكافحة التطرّف» أو «حماية الاستقرار»، ما يعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويفاقم احتقاناً قد ينفجر في لحظة ضعف إقليمي أو دولي.
توسيع اتفاقات أبراهام: التطبيع كاستراتيجية أمن
أحد أعمدة «رؤية 2025» للمنطقة هو توسيع دائرة اتفاقات أبراهام؛ إذ يفترض صانعو الاستراتيجية أن إدماج مزيد من الدول العربية في شبكة التطبيع مع إسرائيل سيحوّل الصراع العربي – الإسرائيلي إلى خلاف محلي محدود مع الفلسطينيين يمكن «إدارته»، لا قضية مركزية قادرة على تفجير الإقليم.
توظَّف هنا لغة «السلام» و«الاستثمارات المشتركة» و«الممرّات الاقتصادية» لتمويه حقيقة أنّ التطبيع يُستخدم كبديل من العدالة، وكطريق للالتفاف على الحقوق الفلسطينية لا لإنصافها، مع تحويل الأنظمة العربية المطبّعة إلى شركاء في حماية أمن إسرائيل وحدودها ومشاريعها الاقتصادية الجديدة في البحر المتوسط والخليج.
من حيث الجوهر، لا تزال إسرائيل في وثيقة 2025 «الحليف غير القابل للاستبدال»، و«الديموقراطية الوحيدة في المنطقة» بحسب التعبيرات المتكررة في الخطاب الأميركي، لكن الوثيقة تعكس أن «شكل» هذا الحلف قد تغيّر: لم تعد إسرائيل مجرد كيان يحتاج إلى حماية، بل تحوّلت إلى شريك أمني – تكنولوجي واقتصادي يُتوقّع منه أن يتحمّل قسطاً أكبر من عبء مواجهة إيران وحركات المقاومة.
في وثيقة 2017، كان التركيز منصباً على ضمان التفوّق العسكري الإسرائيلي ومواجهة «إيران وملحقاتها»، مع حديث عن «عملية سلام» وإشارة، ولو شكلية، إلى حل الدولتين كإطار مرجعي. أمّا في وثيقة 2025، فتُدفع إسرائيل إلى مركز هندسة الإقليم عبر محورين: – محور أمني، عبر تعميق التعاون الدفاعي والاستخباري، وتوسيع شبكات الدفاع الجوي المشتركة مع دول عربية، بما يجعل إسرائيل جزءاً من بنية الأمن الإقليمي الرسمية، لا مجرد طرف في نزاع.
– ومحور اقتصادي لوجستي، عبر إدماج إسرائيل في مشاريع الممرّات البرّية والبحرية، وخطوط الطاقة والغاز، والموانئ، لتتحوّل إلى عقدة في شبكة سلاسل التوريد التي تريد واشنطن بناءها في مواجهة الصين وروسيا.
يرفع هذا التحوّل كلفة أي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل بالنسبة إلى دول الجوار، لكنه، في المقابل، يضع الكيان نفسه في موقع مكشوف: فكل إخفاق أمني أو عسكري أو سياسي سيتردّد صداه في صورة الولايات المتحدة نفسها، وكل تصعيد ضد غزة أو لبنان أو الضفة سيُظهر حدود «قدرة الشريك» التي تراهن عليها الاستراتيجية. بالنسبة إلى شعوب المنطقة، يفاقم هذا التماهي بين واشنطن وتل أبيب القناعة القديمة بأن الولايات المتحدة ليست وسيطاً، بل طرف في الصراع، ما يعمّق شرعية المقاومة بوصفها خياراً دفاعياً في مواجهة نظام إقليمي يجري رسمه فوق رؤوسها.
اقتصاد سياسي جديد: المنطقة كسوق وممرّ
تتعامل الاستراتيجية الجديدة مع الشرق الأوسط بوصفه سوقاً استهلاكية ضخمة للسلع والخدمات والتكنولوجيا والسلاح، وممرّاً أساسياً لسلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، ومنصة استثمارية في مجالات الطاقة (بما فيها النووية المدنية) والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
تضع الوثيقة قضية «أمن سلاسل التوريد» في قلب الرؤية الاقتصادية والأمنية، وتربط بينها وبين المواقع الجغرافية الحساسة في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط. وفي هذا السياق، يصبح هدف واشنطن إبقاء المنطقة مستقرّة بالحدّ الأدنى الذي يسمح بمرور النفط والغاز والحاويات والسفن الحربية، حتى لو كان الثمن استمرار الاحتلال في فلسطين، وتكريس أنظمة قمعية، واندلاع حروب منخفضة الحدّة على أطراف الخريطة.
تتّسق هذه الرؤية مع سياسات تسليح موسّعة؛ فالمطلوب أن تشتري دول المنطقة المزيد من منظومات الدفاع والهجوم الأميركية، وأن تُفتح أمام الشركات الكبرى أسواق خصخصة الكهرباء والمياه والموانئ والاتصالات، وأن تتموضع الصناديق السيادية الخليجية في قلب الاقتصاد الأميركي، بينما يُطلب من شعوب المنطقة قبول هذا «السلام البارد» الذي يضمن الاستقرار المالي ولا يقترب من جوهر القضايا الوطنية.
لكن، ثمّة سؤال يفرض نفسه: لماذا خفتت نبرة إدارة ترامب تجاه المنطقة عمّا كانت عليه في السابق؟
على خلاف المتوقّع، لا تبدي وثيقة 2025 ميلاً إلى مراجعة نقديّة حادّة لسياسات إدارة ترامب الأولى عام 2017، بل تعيد تقديمها جزئياً كمرحلة تأسيسية لسياسة «أميركا أولاً» في الطاقة والتجارة والتحالف مع إسرائيل. ففي حين تبنّت الوثيقة السابقة استراتيجية المواجهة ضد إيران، وجعلت من هذه المواجهة ركيزة السياسة الخارجية في المنطقة، اكتفت الوثيقة الحالية بالقول إنّ إيران قد رُدعت وتم إضعافها، بعد حرب الـ12 يوماً في حزيران الفائت.
ثمّة سببان رئيسيان لهذا «الخفوت»:
أولاً، البُعد الداخلي. ذلك أن حركة MAGA الملتفة حول ترامب تريد التركيز على القضايا التي تهمّ المواطن الأميركي بدرجة أولى، ولا سيما معالجة أزماته المالية والبنى التحتية والضمان الصحي وغيرها. تفتخر وثيقة 2025 بأنها أعادت الروح إلى «عقيدة مونرو»، والاهتمام بالمجال الأميركي الحيوي. وبذلك، فإنّ آخر ما يريد المواطن الأميركي سماعه هو التوجّه نحو خوض حروب جديدة لا يرى فيها مصلحة وطنية مباشرة.
وثانياً، البُعد الخارجي. فالوثيقة تحرص على طمأنة الأنظمة في المنطقة، جنباً إلى جنب مع تحميلها عبء الدفاع عن نفسها، ولا سيما في ظل تراجع حدّة التنافس الدولي في المنطقة، كما زعمت الوثيقة. ما ورد في الوثيقة يطمئن الأنظمة على استقرارها من التدخّلات الأميركية لمحاولة «إصلاحها»، من جهة، ويسمح باستنزاف أموالها عبر المشتريات الدفاعية والاستثمار في البرامج النووية السلمية والذكاء الاصطناعي، من جهة أخرى.
بالنسبة إلى شعوب المنطقة، هذا يعني أن واشنطن لا تزال ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن الفوضى والدمار اللذين تركتهما حروبها وصفقاتها، وتصرّ على فتح فصل جديد من دون محاسبة أو مراجعة حقيقية، ما يعمّق فجوة الثقة ويترك الباب مفتوحاً أمام استمرار دورة العنف.
على أنّ أخطر ما في الوثيقة ليس ما جاء فيها، بل ما غاب عنها. فالقضية الفلسطينية، وغزة خصوصاً، لا تحضران في وثيقة 2025 بما يتناسب مع موقعها في قلب الصراع الإقليمي، كما إن «حل الدولتين»، أو أي تصور لحل سياسي آخر، يغيب تماماً عن الوثيقة، في انعكاس واضح لما جرى على الأرض من ضمّ واستيطان وحروب متكررة.
يمكن قراءة هذا التجاهل في ضوء أربعة عوامل مترابطة:
أولاً، رغبة الإدارة في فصل ملف غزة عن العقيدة الاستراتيجية العامة، والتعامل معه كملف تقني يُدار عبر خطة منفصلة (خطة النقاط العشرين، وقوة الاستقرار الدولية، وترتيبات اليوم التالي) بدلاً من إدراجه كعنصر تأسيسي في رؤية الأمن القومي.
ثانياً، تجنّب الاصطدام مع حكومة نتنياهو والقوى اليمينية في واشنطن التي تعتبر ذكر حلّ الدولتين تنازلاً غير مقبول، في وقت تريد فيه الإدارة أن تستثمر رأس المال السياسي في معارك أخرى كالصين وروسيا والداخل الأميركي.
ثالثاً، تكريس منطق أن اتفاقات أبراهام ودوائر التطبيع هي «البديل العملي» من أي مسار تفاوضي جدي مع الفلسطينيين؛ فطالما أن دولاً عربية أساسية مستعدّة لتجاوز القضية أو تأجيلها، يمكن للوثيقة أن تعامل فلسطين كملف ثانوي لا يستحق فقرة مستقلة.
رابعاً، محاولة إعادة تعريف القضية الفلسطينية من مسألة تحرّر وطني إلى قضية إنسانية – إدارية تُعالج بالأموال والممرّات الاقتصادية والإغاثة وإحكام السيطرة الأمنية، لا بالاعتراف بالحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
بالنسبة إلى غزة، التي دفعت خلال السنوات الأخيرة ثمناً مروعاً من الدم والحصار والحرب، يصبح هذا الغياب دليلاً إضافياً على أن واشنطن لا ترى في القطاع سوى مساحة يجب ترويضها أمنياً وإدارتها عبر ترتيبات دولية وعربية، حتى لو تطلّب الأمر نزع سلاح المقاومة وتحويل مليوني إنسان إلى رهائن لاستقرار إقليمي مفروض من الخارج.
بين النص والواقع: ما الذي يعنيه ذلك لشعوب المنطقة؟
في المحصّلة، تُسجّل استراتيجية 2025 قطيعة جزئية مع أوهام «إعادة تشكيل الشرق الأوسط» من بوابة الغزو العسكري أو تغيير الأنظمة، لكنها لا تقترب من جوهر ما تطالب به شعوب المنطقة: الحرّية والسيادة والعدالة وإنهاء الاحتلال.
فالشرق الأوسط في الاستراتيجية الأميركية الجديدة ليس مركزاً لإنتاج القرار، بل هامش ضروري لضمان تدفّق النفط وحماية الممرّات. وهو ليس فضاءً لتجربة الديموقراطية، بل حديقة خلفية لأنظمة موالية تُمنح صكّ البراءة ما دامت منضبطة أمنيّاً. كما إنه ليس مسرحاً لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بل منصّة لتثبيت إسرائيل كقوةً إقليمية مهيمنة، وتطويق كل مَن يقاوم هذا الواقع.
أمام هذه المعادلة، يبقى سؤال الشعوب مفتوحاً: كيف يمكن تحويل هذا «الهامش» المفروض من الخارج إلى نقطة ارتكاز لمشروع تحرّر حقيقي؟ لن يأتي الجواب من وثيقة أميركية أو قرار دولي، بل من توازنات القوّة على الأرض، وقدرة حركات المقاومة والقوى الشعبية والنخب المستقلة على كسر احتكار السردية، وفرض حضورها في أي ترتيب يتعلّق بأمن المنطقة ومستقبلها، مهما حاولت الوثائق تجاهل وجودها.
* باحث وسياسي فلسطيني