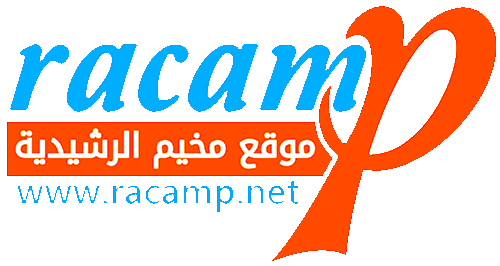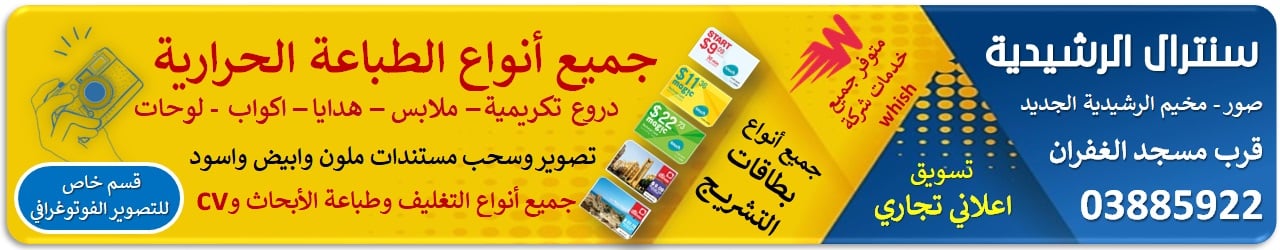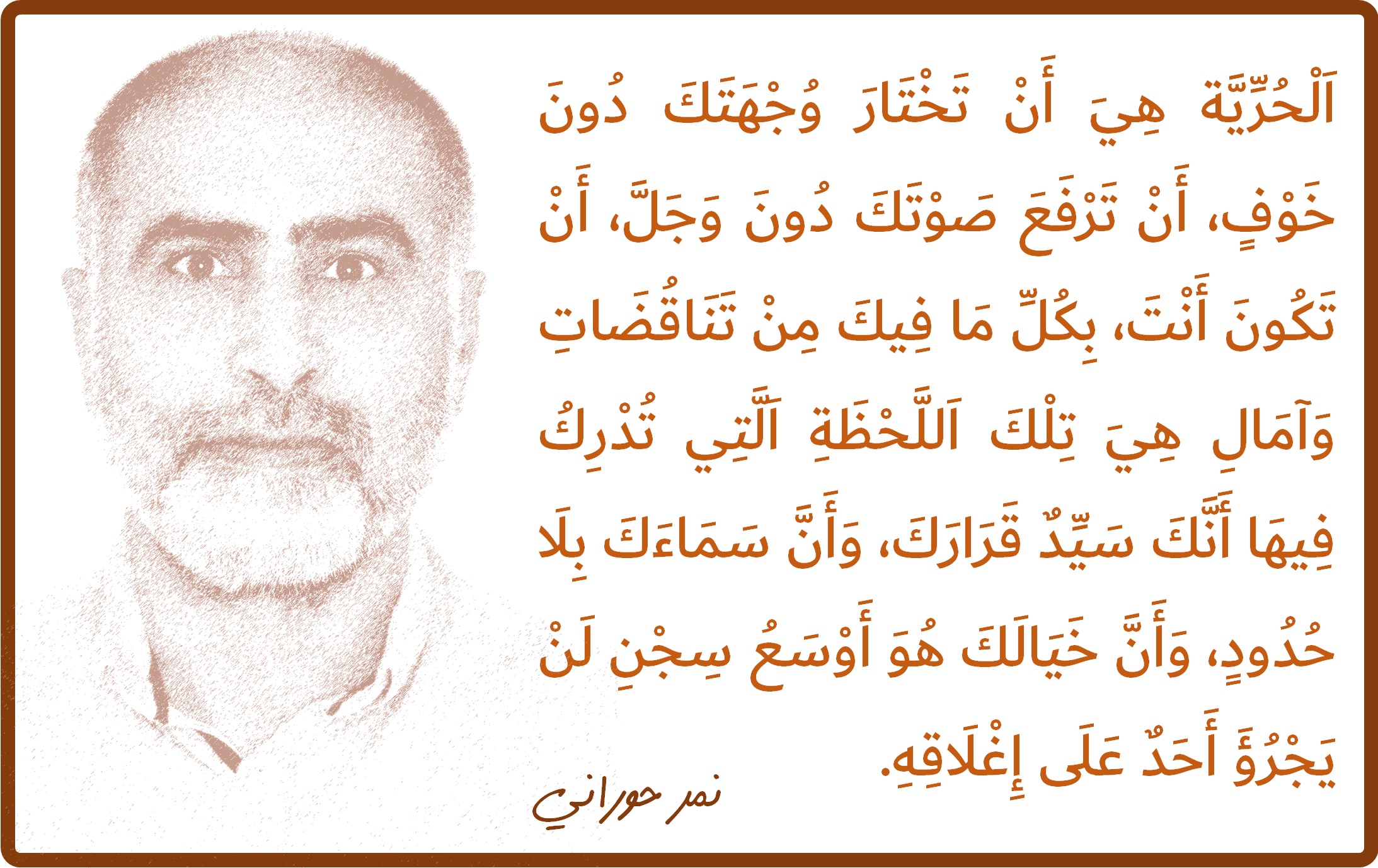محمد قعدان
«سياسة التجويع والتدمير الشامل للبنى الاقتصادية اللازمة للحياة كانت من أهم أسلحة الإبادة» ــــــ منير العكش، كتاب «أمريكا والإبادات الجماعية»
«وَلكِنْ، أتَعْلَمُ أنّ الغزالة لا تأْكُلُ الْعُشبَ إنْ مَسّهُ دَمُنا؟» ــــــ محمود درويش، «خطبة الهندي الأحمر -ما قبل الأخيرة- أمام الرجل الأبيض»
أفتتحُ المقالَ باقتباسين من منير العكش ومحمود درويش، إذ البحث والدراسة ومقاربة الإبادة ضد الشعوب الأصلانية في أميركا شكّلت ما جمع بينهما داخل المشهد الثقافيّ العربيّ في بيروت منذ اللقاء الأول في بيت أدونيس. فقد نشر العكش مقالةً في فصليّة «الكرمل»، كانت بمنزلة نواة عمله وبحثه الذي صدر عام 2002 «أمريكا والإبادات الجماعية». وأشار إلى أن محمود درويش صاحبه طوال مسار هذا المشروع، بل وكان هو من دفعه إلى تحويل المقال إلى كتاب.
وإلى جانب كتابه «دولة فلسطينية للهنود الحمر» الذي صدر عام 2015، فإنّ نقطة الانطلاق جاءت أيضاً من سؤال وجّهه درويش إلى العكش حول حاشية وردت في مقالته «زحف القديسين من المجاز إلى الحقيقة – نذهب إلى الحرب، ولكن على مضض»، التي نُشرت في خريف 2005 في «الكرمل»، خُصصت للوقوف عند فكرة «أميركا» كتصوّر ومشروع «ثروة الأمم».
ففي الحاشية الرقم 46، أشار العكش إلى أن حاكم كنساس لم يمانع في إطلاق اسم «دولة» على بعض المحميات الأميركية، وهي الملاحظة التي أصبحت، في ما بعد، مركز التفكير لدى كل من درويش والعكش، وتحوّلت إلى مشروع كتاب. الإبادة الأميركية لم تكن فقط عبر القتل والحرب، بل تجلت أدواتها أيضاً في التجويع، ونشر الأوبئة، والتهجير القسري، وإنشاء المحميات، وهنا يمكن تتبّع بدايات تشكّل مدرسة عربية تضع الإبادة الأميركية في قلب البحث والكتابة.
تتبّع مسار الإبادة الصهيونية الراهنة يكشف كيف تشكّلت عبر صعود شخصيات يمينية فاشيّة، استطاعت – على عكس كاهانا – أن تُصبح مُهيمنة ومقبولة في بنية المجتمع المستوطن الإسرائيلي. أسماء مثل نفتالي بينيت، أييلت شاكيد، وبتسلئيل سموتريتش، لم تقتصر أدوارهم على الدخول إلى المشهد السياسي، بل أسّسوا لخطاب عنصري بيولوجي يَستهدف الفلسطينيين وجودياً. ففي إحدى موجات التصعيد على غزة بين عامي 2014 و2015، وصفت شاكيد الأطفال الفلسطينيين بـ«الثعابين الصغيرة»، في تصريح لا يُخفي رغبة في القتل المسبق. أمّا سموتريتش وزوجته، فقد عمّقا هذا الخطاب عندما صرّحا بأن الطفل العربي هو مشروع قاتل مستقبلي، إلى الحدّ الذي رفضت فيه زوجته مشاركة غرفة ولادة مع امرأة فلسطينية، بذريعة أن المولود الفلسطيني قد يهدّد حياة ابنها يوماً ما.
هذه المواقف لا تعبّر فقط عن انحرافات فردية، بل تعكس نزعة عنصرية متجذّرة تتجاوز الخطاب السياسي، لتبني تصوراً وجودياً يُنكر على الفلسطينيين حتى حقّ الحياة. بل إنّ هذه الأحزاب، ومعابدهم الدينية ومنظماتهم في الضفة الغربية، تحوّلت إلى مراكز تخطيط وصياغة لمفهوم الإبادة، وإلى مختبرات تُنتج خطاباً وأدوات تشرعن قتل الفلسطينيّ وتحوّله إلى «ضرورة أمنية» أو «قيمة دينية».
هذا إلى جانب عشرات الحالات التي تنضح بعنصرية ذات طابع بيولوجي، ما بات يشكّل محوراً رئيسياً في أعمال باحثين مثل نادرة شلهوب-كيفوركيان، نديم روحانا، وهنيدة غانم، الذين تتبّعوا تشابك العلاقة بين الديني والصهيوني، وتطوّر الاصطلاح الإبادي داخل هذا السياق.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى كتابات أحمد الدبش، أحد أبرز الباحثين العرب اليوم في مقاربة الإبادة الأميركية، الذي وثّق بتفصيل دور الدين والمسيانية في رسم وتخطيط وتطبيق سياسات الإبادة هناك، وهو ما يفتح لنا مجالاً لفهم البُعد الديني في المخيال الصهيوني المعاصر. هذا المخيال ليس مجرّد خلفية أيديولوجية، بل بات المحرّك الفعلي لنشوء حركة صهيونية دينية واسعة، ممأسسة داخل المجتمع الاستيطاني، ومتمتعة بدعم حكومي وشبكة تمويل ضخمة تمتدّ إلى الولايات المتحدة.
لقد أصبحت هذه الحركة نواة الخطاب الصهيوني الحالي، تصوغ مفاهيمه، وتُنتج مؤسساته، وتُخطّط لسياساته. ويمكن القول إن جذور الإبادة التي نشهدها اليوم، وإن كانت كامنة في نواة المشروع الصهيوني منذ بدايته، إلا أنها لم تتطوّر وتُشرعن وتُمارس بهذا الشكل الفجّ إلا عندما تلبّست الصيغة الدينية الفاشيّة.
التجويع اليوم كما نراهُ في غزة، هو شبكة علاقات منظمات أميركية كبرى، منها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) ومؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي تعمل ضمن خطط الجيش الإسرائيلي، الذي يهدف أساساً إلى تهجير الفلسطينيين ضمن خطط حكومية، ومعها الولايات المتحدة، أعلن عنها في بداية عام 2025. بعدما شجّع ترامب على طرد الفلسطينيين، بدأت إسرائيل إنشاء مديرية خاصة للترانسفير الطوعي لسكان غزة، تقوم على تحضير مسارات وطرق لأهالي غزة من أجل الخروج. لم تكن هذه الخطة مجرد تصريحات، بل هي الموجّه الرئيسي لسياسة التجويع التي نراها اليوم.
التجويع أداة للتهجير والتطهير العرقي، بما يخدم الإطار العام لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الأقل حتى الآن. وإذ تقع المخيّمات في قلب هذا الصراع، باعتبار خصوصيّتها النضاليّة الفلسطينيّة، وما نزال نشهد ممارسات يوميّة لإزالة المخيمات في الضفة الغربية أيضاً، نشير إلى أن قضيّة محو مخيمات اللاجئين وإنهاء قضيتهم لها جذور في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث إن ثلث من تبقّوا هناك هم لاجئون من قرى ومدن فلسطينية.
في تلك المرحلة، كانت منظمات الإغاثة، مثل الصليب الأحمر والكويكرز، تقدّم لهم المساعدة حتى نهاية عام 1949، ضمن إطار الأمم المتحدة، وقدّمت الطعام والملابس والدعم، إلى جانب مشاريع تتعلق بعودتهم. إلا أن المؤسسة الإسرائيلية رفضت ذلك رفضاً تاماً، نتيجة العنصرية الاستعمارية الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأرض. مع بدء عمل «الأونروا» عام 1950، شملت خدماتها اللاجئين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والذين سُمّوا لاحقاً «المهجرين داخلياً»، لكن هذه القضية انتهت فعلياً بعد عامين فقط، وتلتها مشاريع إسكانهم وتأمين حياتهم، ولكن ضمن إطار منع عودتهم. يمكننا الاستنتاج بأن إنهاء قضية اللاجئين يُعدّ أحد الأهداف المركزية للمشروع الصهيوني، بأي وسيلة كانت.
لقد استمرت آنذاك خطط التجويع ضد الفلسطينيين تحت الحكم العسكريّ، باعتبارها أحد وسائل دفعهم إلى خارج أراضيهم. خطة تقويض وصولهم إلى أراضيهم ومحاصرة زراعتهم هدفت إلى تجويعهم في ظل عدم قدرتهم على التنقل والحركة بين القرى والمدن للعمل. باتت منظومات الحكم العسكري ـــــ على الأقل حتى نهاية الخمسينيات ـــــ مصمّمة من أجل منع الطعام ومصادر الرزق عن الفلسطينيين. وفي المقابل، إرادة البقاء والصمود أفشلت مجمل خططهم، وعلى هذا الأساس تبنّت الدولة تسهيلات عدة في إطار استمرار الحكم العسكري، منها السماح بتصريح للعمّال العرب في السوق اليهودية. استهداف غزة اليوم، يأتي أيضاً على أساس إنهاء كامل لقضية اللاجئين والمخيمات عبر الإبادة.
التجويع، إذاً، ليس حدثاً عرضياً بل ممارسة بنيويّة في مشاريع الاستعمار الاستيطاني؛ أداة ممنهجة تُستخدم لتفكيك المجتمعات الأصلانية وتجريدها من أدوات البقاء، وتحويل الحاجة البيولوجية إلى سلاح سياسي.
في كتابه «مواطنون على أرض مسروقة»، يتتبّع ستيفن كانتروفيتس تاريخ شعب «هو تشانك» في القرن التاسع عشر، ويوضح كيف تحوّلت المواطنة إلى أداة للنضال من أجل البقاء، لا كامتياز قانوني، بل كوسيلة لتحدّي الإبادة. يروي كانتروفيتس كيف فُرض على هذا الشعب الترحيل من ويسكونسن إلى محمية غير مجهّزة في نبراسكا، من دون أي بنية تحتية، أو مأوى، أو طعام.
بدأت العملية بدفعة أولى من نحو مئة شخص أُجبروا على الرحيل وتركوا في العراء، لتبدأ المجاعة كواقع يومي، وليس كنتيجة عرضية بل كأداة إدارية للسيطرة. لم تصل الحصص الغذائية التي وعدت بها الحكومة، أو كانت فاسدة، وتحولت إلى وسيلة ابتزاز: الخضوع مقابل البقاء. هذا الوضع أطلق قطيعة داخلية مع النظام الحاكم، وبدأت تظهر نقاشات داخل المجتمع حول معنى البقاء وسبل المقاومة. وهكذا، ولدت ظاهرة «العودة السرّية»، إذ أخذ كثيرون يهربون من المحمية ويعودون إلى أراضيهم الأصلية في ويسكونسن، رغم الطرد المتكرر والملاحقة.
التجويع هنا لا يُفهم فقط كحالة جسدية، بل كبنية استعمارية تُنتج الفناء ببطء، وتبني فوق الجوع اليومي شبكة من الانكسار، والعزل، وإعادة تشكيل الإنسان ككائن قابل للإبادة أو للاستسلام. لكن هذا لم يحدث. فالعودة كانت فعلاً سياسياً، يعيد تعريف العلاقة مع الأرض، ويُعيد إنتاج الذات من تحت الأنقاض.
لنعد إلى كتاب منير العكش «أميركا والإبادات الجماعيّة»، حيث يتوقّف عند لحظة مفصلية تسبق السياسات الوحشية التي تعرّض لها شعب «هو تشانك»، وهي انتفاضة شعب السانتي داكوتا (شعب السو) عام 1862، التي انفجرت نتيجة سياسة تجويع قاتلة. كانت الدولة الأميركية قد حاصرت القبائل في منطقة سانتي، حتى قال المفوّض الفيدرالي للزعيم الغراب الصغير: «اذهب أنت وشعبك وكلوا من حشيش الأرض، وإذا شئتم فكلوا خراءكم». الإهانة لم تكن مجرد كلمات، بل تجلٍّ فاضح لسياسة ترى في الجوع أداة إخضاع وتهذيب.
كان رد الزعيم سريعاً وحاسماً، إذ قتل المفوّض، وبدأت المعارك التي استمرت شهراً واحداً، وانتهت بأحكام الإعدام الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة، حين عُلّق 38 من زعماء السانتي على المشانق. بهذه اللحظة الدموية تنكشف بنية الاستعمار الاستيطاني في أوضح صورها: تجويع ممنهج، إهانة للوجود، وردّ فعل تُصنّفه الدولة كـ«تمرّد» ولكن في جوهره كان هذا الرد تعبيراً عن كرامة جائعة ورفضاً لإبادة بطيئة.
كما في حالة «هو تشانك»، وكما في فلسطين، يصبح الخبز فعل مقاومة، والعودة، سرّاً أو جهراً، هي اللغة الوحيدة التي يفهمها التاريخ حين يُكتب من تحت الحصار. بهذا، لا تعود الإبادة حدثاً مغلقاً في القرن التاسع عشر، بل مشروعاً مُمتدّاً، تتكرّر أدواته وتتجدّد لغته، من سانتي داكوتا إلى جنين، ومن خراب الأرض إلى بُقع الحياة الصغيرة التي يتمسّك بها المنفيّون ليكتبوا قصصهم، ليس كضحايا، بل كناجين يفضحون البنية.
* كاتب فلسطيني