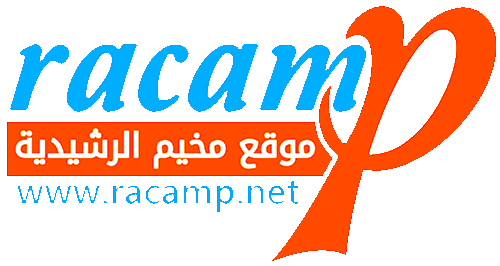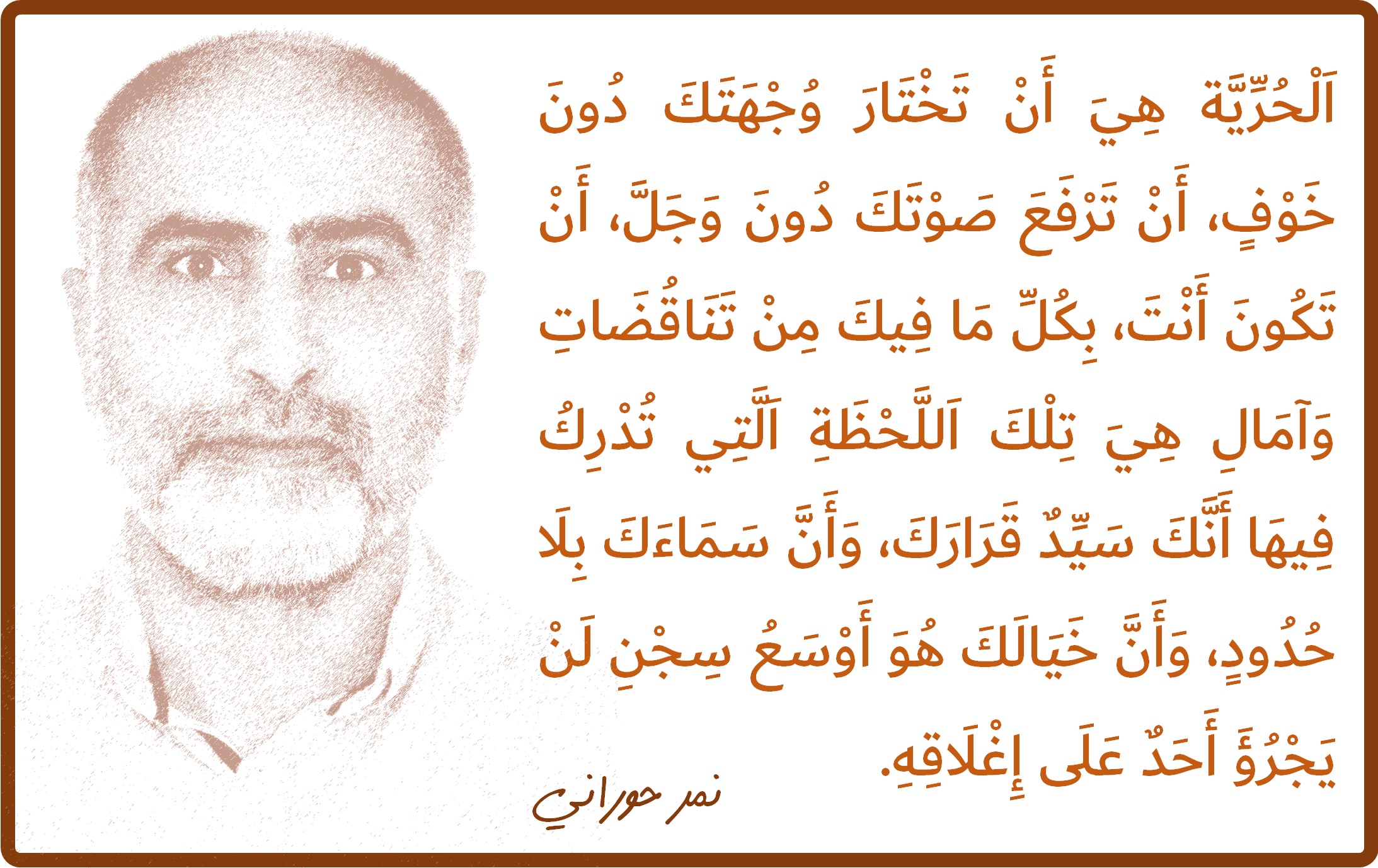سامر توفيق عجمي
يعيش مجتمع المقاومة اليوم «صمتاً تفسيرياً» [أي غياب السرديّة الداخلية أو الرسمية للأحداث بعد الحرب]. هذا الصمت لا يترك فراغاً معرفياً فحسب، بل يحوّل غياب التفسير إلى عبء يضاعف فقدان السيطرة على المعنى. وغالباً ما يكون الصمود والتحمّل والاستعداد للتضحية مشروطة بامتلاك إطار يفسّر ما يجري ويمنحه دلالة مفهومة. وتتضاعف هذه الحاجة في لحظات المعاناة، إذ لا تكمن الخطورة في القلق والألم بحدّ ذاتهما، بل في غياب تفسيرهما.
يميل العقل البشري إلى عدم احتمال الغموض طويلاً. والصمت التفسيري لا يُوقف التفكير أو يتركه في حياد، إنما يدفعه إلى البحث عن إغلاق معرفي، أي عن سردية تملأ الفجوة. حين تُعلَّق الإجابات ويُغلَق النقاش المفتوح، لا تختفي الأسئلة من الفضاء العام -لأنه من الصعب تعطيل الحاجة إلى الفهم- بل قد يُفتح الباب أمام تهديد أشدّ خطورة، يتمثّل في انتشار تفسيرات بديلة غالباً أقل عقلانية وأكثر اندفاعاً.
الفرد الواقع تحت ضغط القلق والألم وفقدان المعنى قد لا يسأل عن مصدر التفسير بقدر ما يسأل عن قدرته على تهدئة اضطرابه الداخلي. هنا يسعى الأفراد إلى ملء الفراغ بأي تفسير متاح، فتنتشر التفسيرات العفوية غير المدروسة، وتعاد صياغة الوقائع وفق انفعالات الخوف والغضب، بما يهدّد التماسك الداخلي للجماعة، ويفكّك روابطها الرمزية، ويضعف الثقة بالقيادة والخطاب الرسمي.
من هنا، فإن «الفراغ التفسيري» حالةٌ معرفية–اجتماعية، تنشأ حين تغيب السردية الداخلية القادرة على تفسير الحدث وإدارة المعنى في وعي الجماعة. هذا الفراغ لا يعني غياب المعلومات فحسب، بل فقدان الإطار الذي يربط الوقائع بمعنى مشترك ويحوّل الصدمة من حدث مبهم إلى تجربة قابلة للفهم الجماعي المُطمئِن نفسياً واجتماعياً.
قد يترقّب العدو الصمت أكثر مما يرصد الخطاب المُعلَن، وعندما تُحرم الجماعة من تفسير داخلي منضبط ومدروس، يتحوّل الفراغ إلى فرصة استراتيجية يمكن استثمارها لفرض تفسيرات خارجية بديلة، سواء عبر قوى معادية أو منافسة أو حتى فاعلين داخليين مخترَقين.
هنا تظهر النقلة المفاهيمية الأساسية: الفارق ليس في ما يعرفه العدو، إنما في مَن يمتلك القدرة على تنظيم هذا المعروف وتوجيه دلالاته. حين تمتنع الجماعة عن تفسير واقعها، لا تمنع العدو من الفهم بل قد تحرم نفسها من امتلاك سردية داخلية وأدوات ثقافية ونفسية وتربوية قادرة على تنظيم المعنى، واحتواء الألم، وضبط القلق، ومنع الانهيار الرمزي.
في ضوء ذلك، تصبح المسؤولية المجتمعية والقيادية واضحة؛ المقاومة لا تُختزل في إدارة المعركة العسكرية والأمنية أو التحليل السياسي فقط، بل تشمل إدارة المجتمع الذي يعيش داخلها وتمتد إلى إعادة تنظيم الحياة بعد الكارثة. الإمكانات لتحقيق ذلك متوافرة أصلاً، عبر مؤسسات تربوية وثقافية وصحية واجتماعية، وكوادر ثقافية ونفسية وتنموية، وقدرة تنظيمية عالية. المشكلة تكمن في حصر مفهوم التفسير وإدارة المعنى ضمن المجال السياسي–الأمني، وكأن الرعاية النفسية والثقافية والتربوية شأن يمكن تأجيله زمنياً إلى ما يسمّى اللحظة المناسبة.
الصمت التفسيري لا يُفهَم بوصفه مجرد إحجام عن تقديم سردية سياسية–أمنية أو تأخير خطاب إعلامي؛ هذا الفهم يختزل التفسير في بعده الخطابي ويحوّل المجتمع من كيان حيّ متأثر بالحدث إلى جمهور متلقٍ ينتظر معلومة. الإشكال أعمق من ذلك، إذ يتعلّق بغياب منظومة شاملة لإدارة المعنى والألم داخل مجتمع، يعيش المعاناة، لا يراقبها من الخارج. في هذا المستوى، لا يقتصر الصمت على الكلام فحسب: هو يمتد إلى الرعاية والإرشاد ومرافقة التحولات الوجودية التي تفرضها الصدمات والجراح على الأفراد والعائلات.
قد يثار اعتراض مألوف: أن تفسير الواقع لمجتمع المقاومة في الفضاء المفتوح، يشكّل معلومات مجانية للعدو، وأن الصمت ضرورة أمنية-مجتمعية. غير أنّ هذا الافتراض يغفل أن العدو لا يرى المجتمع بمنظار الرصد العسكري أو التفسيرات المنشورة فحسب. فهو منذ عقود راكم منظومات متقدّمة ويستخلص معرفته عبر الرصد التراكمي.
إنّ إدارة الفراغ التفسيري من قِبل العدو تعمل عبر آليات دقيقة:
أولاها، استهداف الثقة الداخلية عبر التشكيك غير المباشر بالخطاب المحلي.
ثانيها، تقديم تفسيرات بديلة تبدو عقلانية ومتعاطفة، قابلة للتسلّل إلى وعي متعب يبحث عن معنى.
وثالثها، تفكيك الرابط الرمزي بين الجماعة ورموزها، إذ تبدو منفصلة عن التجربة اليومية، فاقدة القدرة على التعبئة والإقناع.
لا يستهدف النقد منطق التحفّظ الأمني أو السرّية، ولا ينفي الحاجة إلى الصمت في لحظات معيّنة، بل يميّز بين الصمت التكتيكي والصمت البنيوي في إدارة المعنى والألم
في زمن يميل فيه الوعي البشري إلى السهولة والسرعة، فإنّ السردية التي تملأ الفراغ أولاً -حتى لو كانت منحازة أو خبيثة- تمتلك أفضلية تنافسية، لأنها توفّر أماناً نفسياً مؤقتاً، بخلاف الصمت الذي يُبقي الجرح مفتوحاً. وهنا تكمن المفارقة: يُتّهم التفسير -لأنه مرئي وصريح- بأنه يهدّد التماسك الداخلي ويخدم أجندة العدو، في حين أنّ الصمت نفسه قد يكون هو الذي يسمح لتلك الأجندة بالعمل بحرّية وفاعليّة.
من هذا المنطلق، لا يستهدف النقد منطق التحفّظ الأمني أو السرّية، ولا ينفي الحاجة إلى الصمت في لحظات معيّنة، بل يميّز بين الصمت التكتيكي والصمت البنيوي في إدارة المعنى والألم. حين تتوسّع الكلفة الاجتماعية يتحوّل حصر التفسير ضمن الدائرة السياسية–العسكرية إلى عبء داخلي، ويُترك المجتمع ليعيد تفسير حياته وصدمة أحداثه بموارد فردية محدودة جدّاً.
بناء عليه، يتضح أن الصمت التفسيري، رغم ما ينطوي عليه من نية حماية الجماعة وتشديد الحذر من العدو، ليس بالضرورة أداة استراتيجية فعّالة، وقد ينقلب إلى عبء عقائدي ونفسي واجتماعي إذا لم يُستبدل بسردية داخلية منضبطة، توازنُ بدقّةٍ بين الكشف الضروري والسرّية الواجبة، أي بسياق استراتيجي ذكي لإدارة المعنى والألم، يحدّد ما يمكن الكشف عنه وما يجب الاحتفاظ به، ضمن ضوابط مدروسة تُحقّق أثراً عقائدياً ونفسياً واجتماعياً إيجابياً من دون المساس بالقدرة الدفاعية للمقاومة.
في سياقات الصراع نادراً ما تكون الخيارات بلا كلفة. المجتمعات لا تواجه مفاضلة مريحة بين خير خالص وشرّ خالص، فتقف أمام بدائل مثقلة بالمخاطر. هنا تكتسب مقولة علي بن أبي طالب دلالتها العميقة: «ليس العاقل مَن يعرف الخير من الشرّ، ولكن العاقل مَن يعرف خير الشرّين». فالعقل الاستراتيجي يبحث عن أقلّ الخيارات تآكلاً على المدى البعيد. ضمن هذا الإطار، يغدو التفسير المدروس المنضبط -رغم ما يرافقه من توتّر مؤقّت أو خلافات داخلية أو انكشاف نسبي أمام العدو- أقلّ كلفة من الصمت الممتدّ.
في هذا السياق تحديداً، يبرز مأزق خطير في المجتمعات التي لم تتشكّل فيها ثقافة راسخة لحقّها في التفسير والنقد، إذ يتحوّل الصمت إلى منطق دفاعي جماعي، وترى الجماعة الجريحة في كسر الصمت سوء تقدير للتوقيت وتهديداً للتماسك وعدم مراعاة لحجم المعاناة. هذه الهواجس، رغم مشروعيّتها النفسية، تقوم على مسلّمة غير مفحوصة، مفادها أن التفسير في زمن المعاناة والقلق فعلٌ سلبي بطبيعته. والحال أنّ الزمن ليس عنصراً محايداً، بل شريك فاعل في صناعة المعنى وتوجيه الحدث نفسه، إمّا نحو الاحتواء الواعي أو التآكل الصامت.
في الحروب المفتوحة على الزمن، كما في تجربة مجتمع المقاومة وبيئتها في لبنان منذ عام 1982، لا توجد لحظة مؤجَّلة مثالية للتفسير أو النقد. فإدارة المعنى والألم لا تمارس بعد اكتمال الحدث بل في لحظة تشكّل الفجوة التفسيرية ذاتها، حين تكون المعاني لا تزال قيد التشكّل والخيارات مفتوحة. مع مرور الوقت تتراكم الفراغات، تتكثّف الضغوط، ويضعف الاستقرار الرمزي للجماعة، فتزداد قابلية الاختراق ثقافياً ونفسياً واجتماعياً.
في هذا المستوى، يعادل الفراغ التفسيري عملياً تعطيل القدرة على المعالجة المبكرة للأزمات قبل أن تتجذّر. وكلّ تدخّل متأخّر يصبح توصيفاً للماضي أكثر منه أداة فاعلة لتوجيه المستقبل، فيما يستمرّ الصمت بإنتاج مساراته الخاصة.
أمّا الحكم الانطباعي بأن الصمت يحمي الجماعة مستقبلاً، فيفتقر إلى أدوات قياس حقيقية للأثر، إذ لا دليل قوياً يثبت أن الواقع سيكون أسوأ في حال التفسير والنقد، بل قد يكون العكس هو الأرجح. فلعل صناعة مستقبل أفضل للجماعة –في قدرتها على الفهم، التماسك، التكيّف، القوة الرمزية، والحياة الطيبة- لا تُستنهَض باستدامة الصمت التفسيري، بل بكسره في اللحظة التي يكون فيها المعنى قابلاً للإدارة والألم للاحتواء.
* كاتب وأكاديمي