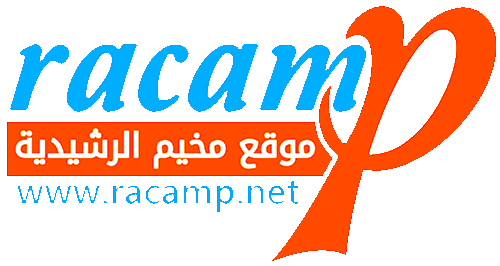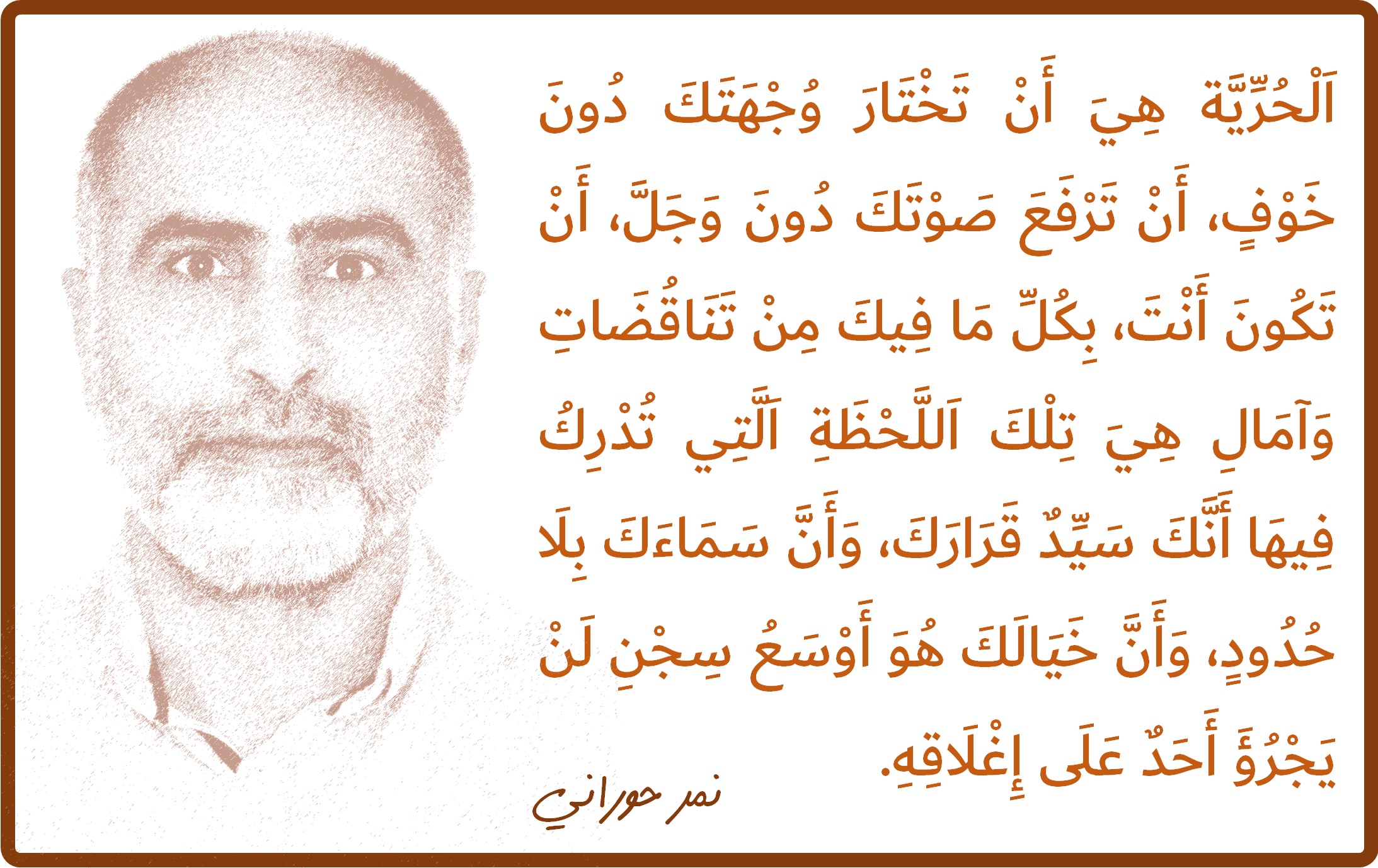بثينة عليق
تظهر مؤشرات عديدة على أن واشنطن و “تل أبيب” تدفعان باتجاه توقيع اتفاقية بين لبنان و”إسرائيل” قد تكون أكثر انتهاكًا للسيادة والكرامة الوطنيتين مما كانت عليه اتفاقية 17 أيار، التي أعقبت اجتياح العدو للأراضي اللبنانية عام 1982 والتي شكّلت نموذجًا لمحاولات فرض وقائع سياسية على لبنان تحت ضغط عسكري مباشر واختلال فادح في موازين القوى. واليوم، تتكشّف مؤشرات متعددة توحي بأن هذا النموذج يُعاد إحياؤه بصيغة مختلفة، وبأدوات أكثر تعقيدًا.
من أبرز هذه المؤشرات طريقة التعاطي مع «الميكانيزم»، أي اللجنة التي تشكّلت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان للإشراف على تطبيق القرار 1701 وضمان تنفيذه. فمنذ إنشائها، تتوالى محاولات شلّ عمل هذه اللجنة، وصولًا إلى تداول إمكانية تجميدها، في سلوك يطرح تساؤلات جدّية حول الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا المسار.
ويزداد هذا المشهد دلالة إذا ما وُضع في سياق التنازلات التي قدّمتها السلطة اللبنانية، وآخرها ضمّ شخصية مدنية إلى اللجنة، بعد إطلاق خطة لما يُسمّى «حصرية السلاح». فهذه الخطوات لا توحي بأن المطلوب يقتصر على تنفيذ القرار 1701، بقدر ما تشير إلى مسعى أوسع يتجاوز هذا القرار، الذي تتعامل معه واشنطن وتل أبيب على أنه أصبح من الماضي وانتهت مفاعيله السياسية والأمنية.
إن متابعة مسار الأحداث منذ انتهاء حرب الستة والستين يومًا العام الماضي تكشف بوضوح أن المشروع الأميركي–الإسرائيلي يتحرّك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة إنتاج اتفاقية 17 أيار، ولكن بنسخة منقّحة تميل أكثر إلى المصالح الإسرائيلية. ويجري تنفيذ هذا المشروع تدريجيًا، عبر مسارات متوازية ومتداخلة، وعلى مستويات متعددة.
فعلى المستوى العسكري، يُستخدم الضغط الميداني أداة لتطويق بيئة المقاومة والمجتمع اللبناني عمومًا، ولترسيخ فكرة أن الاستقرار غير ممكن إلا من خلال الرضوخ للمطالب الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع محاولات ممنهجة لإضعاف منسوب الثقة بإمكانات المواجهة وترسيخ فكرة انعدام أي أفق جدي للصمود والمقاومة.
أما على المستوى السياسي، فيجري العمل على توسيع النفوذ الأميركي داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، والإمساك بمفاصل القرار عبر شخصيات وجهات طيّعة وخاضعة للإرادة الأميركية.
وفي هذا السياق، يبرز دور وزير الخارجية اللبناني، الذي يقدّم، مبرّرات للاعتداءات الإسرائيلية ويعيد إنتاج رواية العدو، من خلال تبرير الأعمال العدائية الإسرائيلية بذريعة عدم تسليم المقاومة لسلاحها.
هذان المساران المتوازيان، اللذان تحدّث عنهما بصراحة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، يسيران ضمن تناغم واضح بين الضغوط الخارجية والتجاوب الداخلي. فالضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية ما كانت لتتقدم لولا وجود بيئة داخلية مساعدة، تمثّلها طبقة سياسية لطالما قدّمت نفسها بوصفها غربية الهوى وأميركية الوجهة.
هذه الطبقة السياسية لم تكن يومًا في موقع الداعم لمقاومة الاحتلال، وإن التزمت الصمت في مراحل سابقة بفعل حجم الإنجازات التي فُرضت في الميدان. أما اليوم، فهي تكشف بصورة متزايدة عن طبيعة مشروعها السياسي، الذي يكاد يتطابق مع الرؤية الأميركية والإسرائيلية للمنطقة. وهو ما يسلّط الضوء على هشاشة الجبهة الداخلية اللبنانية، إلى درجة أن شخصية وهمية مثل «أبو عمر» يمكنها، بحسب ما أظهرت التجربة، التأثير في مواقف وأداء وزراء ونواب ومسؤولين، وصولًا إلى التدخّل في خيارات بحجم رئاسة الحكومة، فكيف الحال مع السفراء والمبعوثين الأجانب أو الجهات الاستخبارية الفاعلة؟
في هذه المرحلة السياسية شديدة الحساسية، يعود التحذير من تفكك الموقف الوطني ليطفو على السطح بوصفه الخطر الأكبر الذي يهدد لبنان. هذا الخطر حذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارًا، معتبرًا أن التفريط بالوحدة الوطنية يشكّل نقطة ضعف قاتلة في مواجهة الضغوط الخارجية المتصاعدة. وقد سعى، خلال الأشهر الماضية، إلى بلورة موقف رسمي موحّد على مستوى الرؤساء الثلاثة، يوفّر حدًّا أدنى من الحصانة السياسية في وجه العواصف الإقليمية والدولية، غير أن المسار الذي سلكه بعض المسؤولين جاء مغايرًا لهذا التوجّه.
فالتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئاستين الأولى والثالثة عكست انقلابًا واضحًا على سردية وطنية شكّلت، لعقود، الوعي السياسي اللبناني، عبر التنكّر لتاريخ طويل من مقاومة الاحتلال وتضحيات اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وقد جرى، بصورة متعمّدة أو غير بريئة، اختزال صراع امتدّ لأكثر من أربعين عامًا، هدفه تحرير الأرض ومنع إدخال لبنان في مشروع «إسرائيل الكبرى»، إلى مجرّد صراع يخوضه الآخرون على أرضه، مع تحميل سلاح المقاومة مسؤولية عدم الاستقرار، بدل توصيف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بوصفها السبب الجوهري لهذا الاضطراب.
هذا الأداء السياسي لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي يسعى إلى دفع لبنان نحو خيار التسليم، سواء عبر الضغط أم عبر إعادة صياغة المفاهيم الوطنية. فعندما يتخلّى بعض المسؤولين عن شعبهم ويتنكّرون لتضحياته، فإن ذلك يعكس استعدادًا خطيرًا للمساومة على السيادة الوطنية.
في المقابل، يملك لبنان، بما يتميّز به من تنوّع وتعدّدية، سجلًا تاريخيًا يؤكد قدرته على التكيّف مع التحوّلات ومواجهة محاولات الاحتواء والتطويع. فمنذ قيام كيان العدو على حدوده الجنوبية، واجه هذا البلد الصغير مشاريع متتالية لإخضاعه، وتمكّن في محطات مفصلية من إفشالها. ومن هذا المنطلق، يبدو الحديث عن تمرير نسخة جديدة من «اتفاق 17 أيار» أنه ليس سوى إعادة إنتاج لفكرة سقطت سابقًا تحت وطأة الرفض الشعبي والوقائع الميدانية.
فالشعب الذي قدّم، خلال الحرب الأخيرة وحدها وعلى مدى ستة وستين يومًا، آلاف الشهداء، وصبر على اعتداءات يومية طالت البشر والحجر والمؤسسات، لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى منطق الاستسلام أو التنازل عن مكتسبات دفع ثمنها دمًا ودمارًا. كما أن الإصرار على المضي في هذا الخيار يضع البلاد أمام مخاطر داخلية جسيمة، إذ يرتكب خصوم المقاومة خطأً فادحًا لا بل خطيئة، إذا اعتقدوا أن منطق الاستقواء قادر على إخضاع مجتمع لم تتزعزع قناعاته رغم كل أشكال الضغط.
إن أي رهان على إمكان عقد تسويات مع عدو ما زال يقتل ويدمّر، يتجاهل حقيقة أن هناك من وقّع بدمه على حرية هذا الوطن وسيادته، ولا يزال مستعدًا للدفاع عن هذه المنجزات. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة شاملة لأداء السلطة اللبنانية، بكل مكوّناتها، قبل الانزلاق إلى مستنقع سياسي قد يهدّد الكيان اللبناني نفسه، بوصفه وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه.
أما الذين يراهنون على ما يسمّى تبدّل موازين القوى، فعليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ القريب قبل البعيد. فهذا المجتمع، الذي وقف وحيدًا في أحلك الظروف، لم يُهزم عندما اشتدّت العواصف، ويبدو غير مستعد اليوم للتخلّي عن قناعاته. ولا يزال قول الإمام موسى الصدر «سنقاتل إسرائيل بأسناننا» حاضرًا كعنوان لإرادة لم تنكسر، كما أن الالتزام بخيار المقاومة، كما عبّر عنه الإمام الصدر والسيد حسن نصر الله، يبقى بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين خيارًا وجوديًا، لا يسمح بإعادة عقارب الساعة إلى 17 أيار 1982.