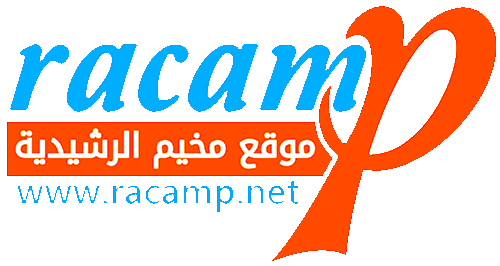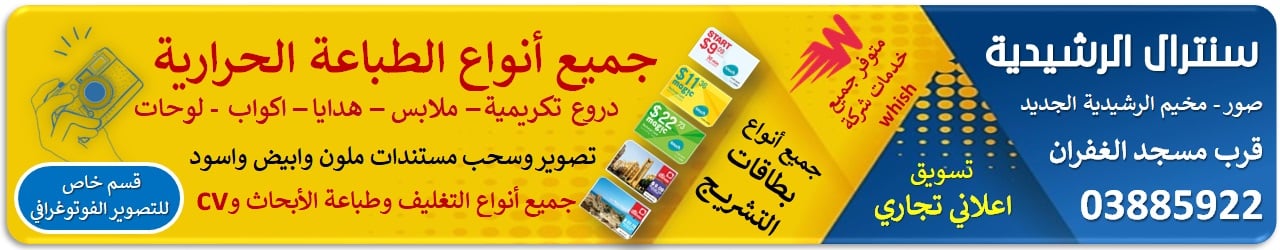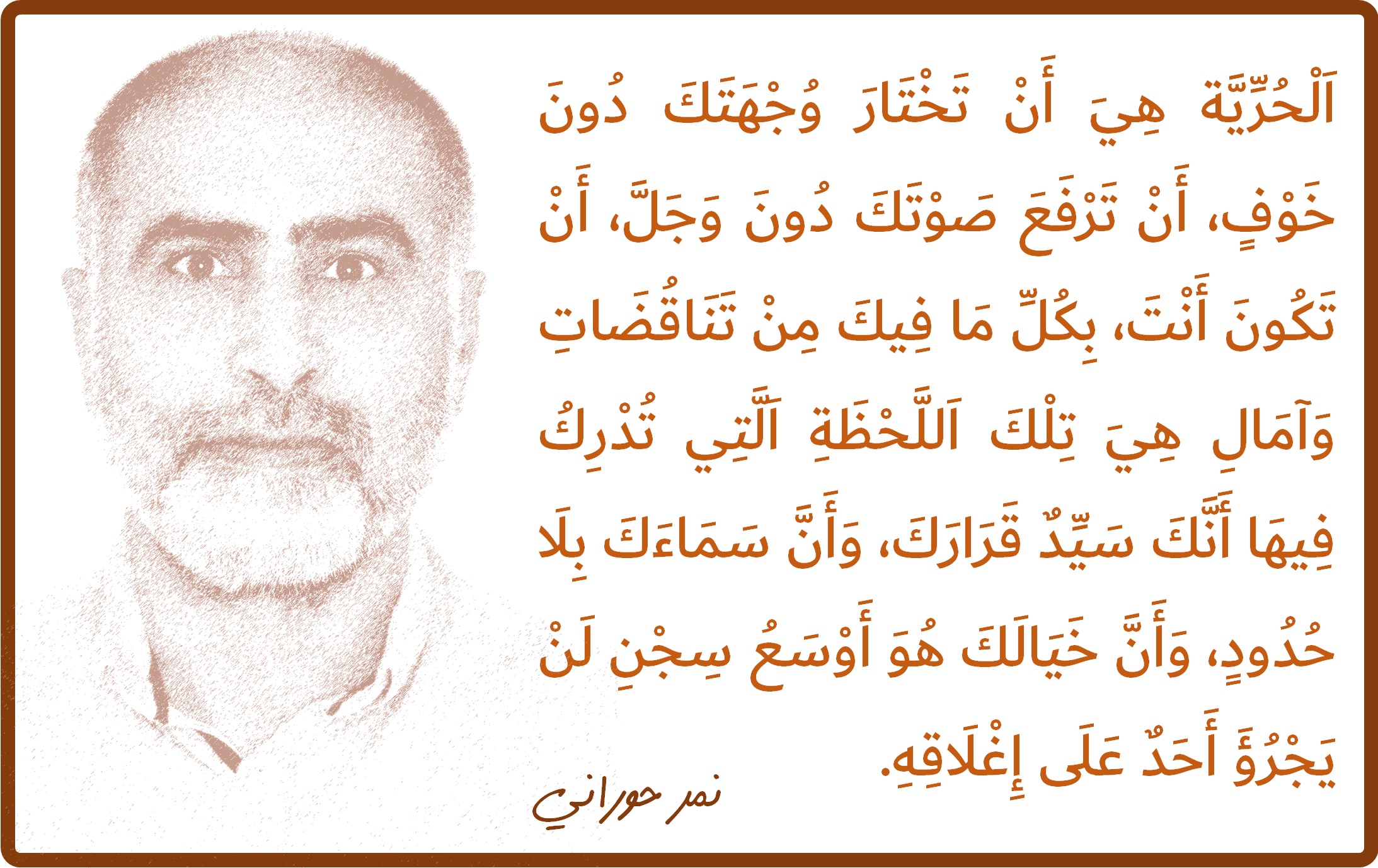محمد قعدان
يمكن القول إنّ العامين الماضيين بين 2023 و2025 يمثّلان أكثر المراحل تأثيرًا على القضية الفلسطينية منذ السنوات التأسيسية للنكبة (1947–1949)، إذ يقعان في قلب الحدث وكثافته، وفي عمق التحولات الكبرى التي أعادت صياغة المشهدين الإقليمي والعالمي. من هنا، يصبح «سؤال الطوفان» امتدادًا لـ«سؤال النكبة» ذاته، وإن اختلف السياق. ففي حين شهدنا إبادةً وتدميرًا منهجيًا، رأينا في المقابل إصرار الشعب الفلسطيني في غزة على الصمود والبقاء والنجاة.
إحدى أكثر قصص النكبة قسوةً يرويها الشاعر الفلسطيني الشيوعيّ حنّا أبو حنّا، عن مدينة طبريا التي أحبّها منذ صغره. يقول عنها في مذكراته: «أحبّ يحيى طبريا بحجارتها البركانية السوداء، أحبّ سور ظاهر العمر ومسجده والحمّامات المعدنية، بل وما ينطلق منها من أبخرةٍ حادّة. أحبّ السفوح المتقوّسة المحيطة بالبحيرة كأنها سطحٌ داخليّ». هذا النص ورد في فصلٍ بعنوان «نيسان أقسى الشهور» في مذكراته «مهر البومة»، وقد نُشر الفصل أيضًا في مجلة «مشارف» عام 2002، وهي المجلة التي أسّسها وحرّرها إميل حبيبي قبل وفاته عام 1996. شهدت طبريا نصيبًا كبيرًا من مآسي النكبة ومحو المدن والقرى والذكريات. وصف أبو حنّا ذلك قائلًا: «عرب طبريا كلّهم يُقتلعون اقتلاعًا في يومٍ واحد، وتذروهم العاصفة في مهبّ الرياح».
تجسّد هذه العبارة جوهر النكبة، إذ أسّست لمفهوم الاقتلاع الذي واجهه الفلسطينيّ، حين لم يكن قادرًا على البقاء في معظم القرى والبلدات والمدن. في هذا السياق، تُقدّم طبريا نموذجًا مكثّفًا لما جرى عام 1948. كانت المدينة تضمّ نحو خمسة آلاف فلسطيني مقابل ستة آلاف يهودي، لكنها تحوّلت بين ليلةٍ وضحاها إلى مسرحٍ للاقتلاع والتهجير والحصار المنظّم. يروي أبو حنّا عن جبرا قردحجي الطبراني، وهو حدّاد من عائلة حدادين بنوا بيوتهم على التلّة المشرفة على البحيرة، كيف كان اليهود منظمين في فرقٍ وعصاباتٍ مسلّحة، بينما كان العرب بالمقابل بلا تنظيم، بلا مؤسسات، وبلا سلاح.
في مقال إلياس شوفاني «سقوط قرية» (مجلة «مواقف» العدد 23)، يروي قصة احتلال قرية معليا في الجليل الأعلى. يؤكد شوفاني أن شعور مواجهة المصير بشكلٍ منفرد ومنعزل عن باقي الشعب الفلسطيني كان شائعًا، إذ لم يكن الفلاحون مهتمين بالقضية الوطنية عمومًا أو بما يجري في الدول العربية. ويذهب — وربما إلى حدّ المبالغة — إلى القول إنّ الجليل بأسره لم يكن معنيًا إلا بمسألة الصمود وحماية القرية. غير أنّ شوفاني لا يقدّم نقدًا واضحًا لهذا الوعي، ما يستدعي منّا قراءة أعمق لأثر غياب القيادة الوطنية الموحّدة والمؤسسات التنظيمية على تشكّل هذا الوعي الانعزالي.
قراءة روايات التهجير تبيّن لنا أن كلّ قريةٍ وبلدةٍ ومدينةٍ واجهت مصيرها منفردة، معزولة ومحاصرة وحدها. إنّ استحضار تجربة طبريا وغيرها يدفعنا للتفكير في الحاضر أيضًا، فكما واجهت المدن الفلسطينية عام 1948 الاقتلاع والمحو، تواجه غزّة اليوم ممارساتٍ مكثّفة من الإبادة، والإزالة، والطرد. فالسياق واحد، وإن اختلف الزمن، والجوهر هو ذاته: استمرار مشروع المحو ومقاومته بالصمود والبقاء. لم تكن غزّة وحدها هذه المرّة، وهذا عاملٌ بالغ الأهمية؛ فربما لم تؤدِّ الدول العربية دورًا حقيقيًا كما في الخطابات، لكن شعوب العالم كانت هذه المرة أكثر وعيًا بخطط التهجير، وأكثر إدراكًا لمشاريع الاستعمار والإمبريالية، ومدركةً أنَّ التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر، بل هو امتدادٌ لمسارٍ طويلٍ من النكبات والمقاومات.
في بدايات الحرب، أكّد السيّد حسن نصرالله في خطابه الأوّل أنَّ «ما يجري في غزّة ليس حربًا كبقيّة الحروب السابقة، وليس حادثًا كبقيّة الحوادث، ليست معركة كبقيّة المعارك، هي معركة فاصلة، حاسمة، تاريخيّة، ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق، وهذا يفرض على الجميع أن يتحمّل المسؤولية». واسترسل موضحًا أنّ نكبة عام 1948 كانت لها تداعيات امتدّت إلى جميع الدول العربية المجاورة، وبالتالي فإنّ أهداف هذه المعركة تتمحور أساسًا حول منع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، والتي لو حدثت، فستكون ذات آثار هائلة على المنطقة بأسرها.
وبدوره، استشهد أحد قيادات المقاومة في هذه المعركة تحديدًا من أجل هذا الهدف؛ منع الاستسلام أمام المطالب الإسرائيلية التي تجسّدت في تهجير الفلسطينيين، والاحتلال الكامل لقطاع غزّة، والتدمير المطلق لحركة حماس. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ارتكب الاحتلال عمليات قتلٍ منهجية بأعداد غير مسبوقة، وفرض سياسة تجويعٍ ممنهجة على الأهالي في قطاع غزّة، ولم تتحقق.
كتب مصعب أبو طه في كتاب «صمود» (Sumud) الصادر بالإنكليزية عام 2025، ملاحظات متشابكة حول فكرة الصمود. يذكر فيها جدَّه حسن الذي توفّي في غزّة عام 1986، محتفظًا بمفتاح بيته في يافا. البيت بالتأكيد لم يعد موجودًا، والباب صار مجرّد ذكرى، أمّا المفتاح الذي صدئ، فهو ما يزال باقيًا. وهنا يطرح السؤال: ما معنى البقاء في ظل هذا الدمار الهائل؟ غزّة اليوم تعيد طرح هذا السؤال، ولكن بشكلٍ مغاير لسؤال البقاء الذي طوّره الفلسطينيون الباقون عام 1948 تحت منظومة المواطنة الاستعمارية الاستيطانية.
في تلك الأيام، لم يكن البقاء متاحًا سوى لقلّة قليلة، مقارنةً بالغالبية العظمى التي دفعتها العصابات الصهيونية إلى اللجوء. ذكر حنّا أبو حنّا في مذكّراته أنّ مجزرة دير ياسين شكّلت فاصلًا حاسمًا بالنسبة إلى مدينة طبريا وأهلها في التاسع من نيسان، لأنّها كانت الإبادة الأولى لقريةٍ كاملة، أصابت المجتمع كاملًا. وصلت أخبار المجزرة إلى كلّ فلسطين، وشعر الناس في طبريا أنّ الجميع بات تحت التهديد. حينها، أدركوا أنّ ما يواجهونه ليس معركة أو حربًا، بل مجزرة وإبادة قادمة. بدأت المعارك في طبريا – كما يروي – في شهر آذار، ووصلت البنادق وبدأت التدريبات على القتال.
يضيف مصعب أبو طه: «كيف غادرت غزّة؟ هل تنوي العودة؟ عليك البقاء في الولايات المتحدة، لا تفكّر بالعودة إلى غزّة. هذا ما يقوله الناس لي». هذه الكلمات تفتح السؤال مجددًا: ما هو البقاء؟ ليس بمعناه الشخصيّ فقط، بل بما يفوق الفرد. فالكثير من المتضامنين يظنون أن الفلسطيني يسعى إلى النجاة الفردية، بعيدًا عن أهله وأصدقائه ووطنه. لكن، هل يمكننا حقًا النجاة كأفرادٍ مشتّتين، مهجّرين في أصقاع الأرض؟
الفكرة التي أطلقها محمود درويش في قصيدته «مديح الظلّ العالي»، التي ألقاها عام 1983 في الجزائر أمام حشد من قيادات المقاومة الفلسطينية، تعبّر عن دروس التاريخ غير الخطيّة وعن ديالكتيك التاريخ في حركته المتناقضة. فهي تُبرز قدرة الحركات الفلسطينية، والفدائيين، والمقاتلين، على تجاوز بنى القمع والماكينات العسكرية الاستعمارية وتحقيق إنجازات عظيمة رغم تفوّق الإمبراطورية المحتلة وجيوشها.
في المقطع الشهير من القصيدة يقول درويش: «حاصِرْ حصَارَكَ… لا مفرُّ، سقطتْ ذراعك فالتقطها واضرب عَدُوَّك… لا مفرُّ، وسقطتُ قربك، فالتقطني، واضرب عدوّكَ بي… فأنت الآن حُرٌّ حُرٌّ وحُرُّ…»؛ في هذه الأسطر، يدعونا درويش إلى إعادة التفكير في معاني النصر والهزيمة. فالحرية ليست بالضرورة نتاج الغلبة العسكرية، بل فعل مستمر يتجسد في الصمود، في تحويل الحصار إلى فعل مقاومة.
ومن المهم فهم تجربة درويش في ظلّ الحكم العسكري الإسرائيلي، وضمن إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وفي سياق شعراء المقاومة الفلسطينيين، حيث صيغ شعار «البقاء» في الداخل الفلسطيني مقابل شعار «العودة» في المخيمات.
بذلك، استطاع درويش أن يجمع بين التجربتين الثوريتين – تجربة البقاء وتجربة المنفى – ليقدّم خلاصة فلسفية ثقافية من عمق التجربة الفلسطينية، مفادها أن الفاعل الأقوى ليس هو المنتصر دائمًا.
كتب درويش القصيدة خلال الحصار الدموي لبيروت عام 1982، ورغم أن إسرائيل حققت ما اعتبرته «إنجازًا» بطرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، فإنها لم تدرك أن هذا الفعل سيشعل لاحقًا انتفاضة كبرى في الأراضي المحتلة – في الضفة الغربية وغزة – بعد أقل من عقد.
* كاتب فلسطيني